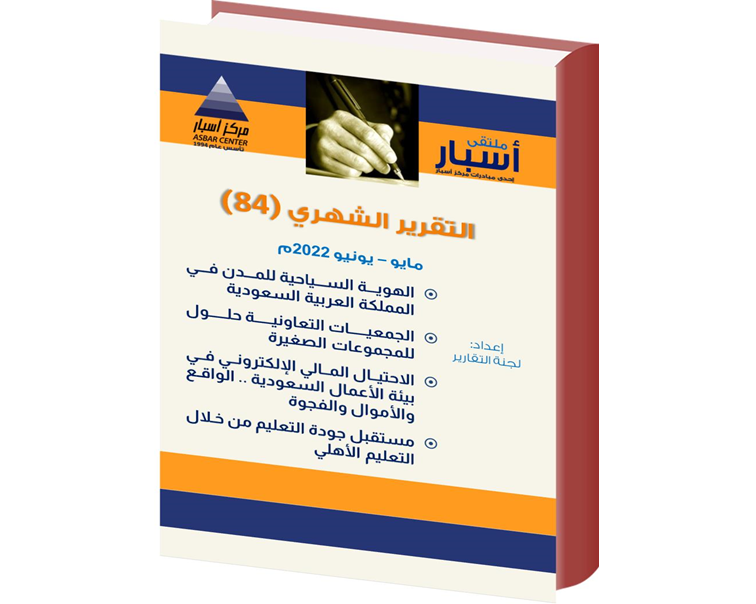للاطلاع على التقرير وتحميله إضغط هنا
مايو – يونيو – 2022
- تمهيد:
- يعرض هذا التقرير عددًا من الموضوعات المهمة التي تمَّ طرحها للحوار في ملتقى أسبار خلال شهري مايو ويونيو 2022 م، وناقشها نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، والذين أثروا الحوار بآرائهم البنَّاءة ومقترحاتهم الهادفة؛ حيث تناولت القضية الأولى: الهوية السياحية للمدن في المملكة العربية السعودية، وأعد ورقتها الرئيسة أ. علاء الدين براده، وعقب عليها كلٌّ من أ. خالد آل دغيم، أ. ماهر الشويعر، وأدار الحوار حولها أ. سعيد الزهراني. بينما تناولت القضية الثانية: الجمعيات التعاونية وحلول للمجموعات الصغيرة، وأعد ورقتها الرئيسة أ. ماهر الشويعر، وعقب عليها كلٌّ من د. احسان بوحليقة، أ. الحجاج بن مصلح، وأدار الحوار حولها د. مها العيدان. وعالجت القضية الثالثة: الاحتيال المالي الإلكتروني في بيئة الأعمال السعودية، وأعد ورقتها الرئيسة د. محمد الزهراني، وعقب عليها كلٌّ من المستشار عاصم بن عبد الوهاب العيسى، د. محمد بن حميد الثقفي، وأدار الحوار حولها اللواء فاضل القرني. وجاءت القضية الرابعة بعنوان: مستقبل جودة التعليم من خلال التعليم الأهلي، وأعد ورقتها الرئيسة د. محمد الملحم، وعقب عليها كلٌّ من د. زياد الحقيل، د. ناصر الملحم، وأدار الحوار حولها د. صالحة آل شويل.
القضية الأولى
الهوية السياحية للمدن في
المملكة العربية السعودية
(11/5/2022م)
- الملخص التنفيذي:
تناولت هذه القضية الهوية السياحية للمدن في المملكة العربية السعودية، وأشار أ. علاء الدين براده في الورقة الرئيسة إلى أن هدفها يتمثل في فهم عناصر القوة في هوية المدن السياحية، وإشكالية طغيان أحد السمات، بحيث تصل صورة هذه المدن بشكل مشوش، مع اقتراح بعض الحلول لمعالجة هذه الإشكالية. ومن أبرز ما تطرقت إليه الورقة التأكيد على أهمية استراتيجية السياحة الرقمية والتي ستساعد في إثراء جهود إعادة بناء قطاع السياحة في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تعمل على وضع المملكة ضمن أهم الوجهات السياحية في العالم.
بينما لفت أ. خالد آل دغيم النظر في التعقيب الأول إلى أهمية الطراز العمراني للمدينة أو بالأخص “المدينة العتيقة” والتي يجب أن تنطلق منها أي تصاميم حديثة تقضي على التشوه البصري، فضلًا عن ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بالبيئة بما من شأنه أن يزيد من جودة الحياة في المدن.
بينما أكد أ. ماهر الشويعر في التعقيب الثاني على أهمية موضوع الهوية السياحية للمدن؛ لأنه ينقل المدن من مدن مغمورة أو حتى من سياحة تقليدية محدودة إلى صناعة سياحية؛ مما يعني أن هنالك أنشطة أكثر ومتنوعة في المدينة ودخلًا أعلى للمدينة وخلق وظائف جديدة بشكل مباشر وغير مباشر. ومن ناحية أخرى وجود مساحات كبيرة لريادة الأعمال من خلال الأفكار المبتكرة والمرتبطة بهوية المدينة السياحية وخلق صورة ذهنية أكثر عمقًا عن المدينة واستغلالها بشكل إيجابي.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- الهوية السياحية وعلاقتها بسمات المدن الأساسية.
- آليات بناء استراتيجية سياحية وطنية متكاملة.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:
- تفعيل دور هيئات المدن في التنسيق بين الجهود لإبراز الهوية السياحية للمدن.
- وضع سياسة دعم للجهات فيما يتعلق بالهوسة السياحية للمدن تهدف إلى الوصول للاعتمادية وعدم الاتكال على الدعم المقدم، وذلك من خلال التحفيز على الاعتماد الذاتي في توفير مصادر التمويل.
- تصميم استراتيجية وطنية شاملة تنظم فكرة الهوية السياحية للمدن في المملكة عبر تنسيق الجهات ذات العلاقة.
- العناية بالهوية السياحية الرقمية للمدن كونها متطلبًا رئيسًا في سياق الحضارة الرقمية.
- تركيز الجهود العلمية لتعميق مبحث الهوية السياحية للمدن على المستويين النظري والتطبيقي عبر استحضار أبرز التجارب الرائدة عالميًا وتطويرها وفقًا للأطر الثقافية المحلية.
- الورقة الرئيسة: أ. علاء الدين براده
نسعى من خلال هذه الورقة إلى فهم عناصر القوة في هوية المدن السياحية، وإشكالية طغيان أحد السمات بحيث تصل صورة هذه المدن بشكل مشوش. وفي ذات الوقت نعمل على مشاركة بعض الحلول لمعالجة هذه الإشكالية.
- السمات التاريخية في هوية المدن
على مر التاريخ عُرِفت المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بصناعة اللؤلؤ، حتى وقت قريب كنا نتابع أخبار صناعة متكاملة -إنْ صح التعبير- في منطقة الخليج العربي تتمحور حول الغوص وصناعة اللؤلؤ، وربما أيضًا صناعة المجوهرات. وبطبيعة الحال كان لكثير من المدن السياحية السعودية على ساحل الخليج دور في الحركة الاقتصادية.
هذه الحِرَف التي اعتمدت على الطبيعة الجيوغرافية للمنطقة، والتي تناقلتها الأجيال جيلًا بعد جيل حتى وصلت إلينا أسهمت بشكل كبير في تشكيل هوية تاريخية ترسخت في الأذهان عن المنطقة. هذا المثال أحببت أن أبدأ به حديثي في هذه الورقة حتى يتصور القارئ ما يمكن أن يتحقق من نتائج إيجابية من خلال بناء صورة ذهنية واضحة للمدن السياحية.
الهوية كما نعلم هي مجموعة من العناصر المجتمعة التي تدفع العميل لاختيارك دون غيرك. وهنا نقول إنها الدافع الذي يُحرِّك الزائر والسائح لاختيار مدينتك دونًا عن غيرها من المدن حين يتخذ القرار بالزيارة. وهذه العملية بالتأكيد تحتاج إلى بناء ممنهج، فهي تعتمد على الكيفية التي تظهر فيها صورة المدينة من خلال الأنشطة التسويقية والحملات وكافة العناصر. ومن هنا نستطيع أن نعكس هذا التعريف على المثال الذي استعرضناه سويًا في المدن الساحلية من المنطقة الشرقية.
وحتى تعكس المنطقة التصور الذي نراه على أرض الواقع، يمكن أن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا للمجوهرات وكل ما يتعلق بها من متاحف وندوات ومؤتمرات ومعارض جاذبة تعمل على تحقيق استقطاب السياح. هذه المهمة ليست سهلة بالتأكيد وتتطلب تضافر كثير من الجهود المجتمعة؛ لكنها في نهاية المطاف تسهم في توليد وظائف جديدة بشكل مستمر ومستدام، وتخدم هذه الوظائف المنطقة بطبيعة الحال أهداف الابتكار والتحسين المستمر من خلال استدامة التجارة الداخلية والخارجية. مع مرور الزمن نتأمل أن تتشكل في المنطقة منظومة متكاملة من النقل والسكن والمعارف الريادية كنتيجة طبيعية لوضوح الهوية.
ننتقل إلى الطرف الآخر من مملكتنا الحبيبة لنأخذ مثالًا مختلفًا بعض الشيء. من غرب المملكة ينقل لنا تاريخنا المعرفي الإسلامي رحلة الشتاء والصيف، مما يدعونا للتأمل في التجارة التي بنت ثقافة المنطقة بما تشمله من انعكاس على شخصية السكان أنفسهم، واعتيادهم حياة الترحال، ويعزز من ذلك الجانب ويدعمه شعيرة الحج التي تدفع بساكن المنطقة على أن يألف المجتمعات البشرية بجميع أطيافها وأجناسها من زوار الحرمين، فنمط حياة يختلف نسبيًا عن باقي المناطق من واقع التسارع في الحركة والتغيير النابع من الترحال المستمر وانفتاح على أنواع متعددة من المعارف والعلوم. هذه الهوية السياحية للمنطقة تأتي ومعها ترحيب بأشكال متنوعة من التجارة هي أيضًا إضافة اقتصادية نلاحظها من منطلق صناعة الهوية المدروسة بشكل جيد وعناية شديدة.
في منطقة عسير تبدأ مقدمة استراتيجية تطوير المنطقة بالتركيز على كونها “متفردة بطبيعتها وأصالتها” تحت شعار قمم وشيم. وهي بالمناسبة أول منطقة تَخرُج لنا باستراتيجية مناطقية متكاملة. وكان من الجميل بالفعل الاطلاع على الدروس المستفادة نتيجة المقارنات المعيارية، والاهتمام تحديدًا ببناء هوية إقليمية قوية لكل وجهة بهدف تقديم العروض السياحية المتنوعة.
يتضح ذلك بشكل جلي من خلال التطرق لمنهجية تطوير الوجهات السياحية ومراحل نطاق العمل فيها، حيث شملت تحديد المزايا الفريدة لكل منطقة من خلال الإمكانات المتوافرة بما يشمل التركيز على الهوية السياحية.
مدينة كمدينة الجبيل أو ينبع يندر أن تجد شخصًا من الجيل الحالي إلا وترتبط في ذهنه بكونها مدنًا صناعية ذات طابع عالمي. وهذا بالطبع لم يكن هو الحال قبل عقود قليلة فقط؛ لكنها هوية نشأت مع المتغيرات الصناعية التي صاحبت فترة الطفرة.
عناصر الهوية
كل ما تحدثنا عنه في السابق جميل، ولكنه يحتاج لإطار مُنظَّم وواضح مع مؤشرات قياس، وهذا كما يتضح من الرسم المرفق أدناه مكون من ثلاثة محاور أساسية تشمل القياس والتأثير بما يشمل الجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى الإرث الذي يتكون عبر السنوات للمدينة.
الهندسة الألمانية هو مصطلح تم بناؤه على مدى سنوات طويلة حتى أصبح رمزًا يعرفه القاصي والداني لفخر الصناعة في تلك الدولة، وبعيدًا عن الصناعة دعنا نأخذ مثالًا آخر على سماتٍ ارتبطت بمنطقة جغرافية محددة كالشاي الإنجليزي الذي تعدَّى مسألة الرمزية، فارتبط بشخصية الفرد في ذاك المجتمع واهتمامه الدقيق بالتفاصيل في طريقة التعاطي مع المنتج، وهنا أحب أن أشير إلى أن المسألة تأخذ مزيدًا من التعقيد حين نعلم -كأشخاص نسعى لبناء هوية وطنية- أن علينا أن نشير حتى إلى سماتٍ غير ملموسة، فالتفاعل مع المشاعر الوطنية ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، لأنك تبحث عن عوامل مشتركة بين أطياف متعددة من المجتمع تشكَّلت على مدى سنوات طويلة.

أرقام وطموحات
ما أن تبدأ بتصفح موقع الهيئة السعودية للسياحة، حتى تلحظ أرقامًا طموحة، يستهدف القطاع الوصول لها خلال السنوات القليلة القادمة، حيث إن مؤشر الأداء لعدد الزيارات من الخارج خلال العام الجاري 2022 هو 29.5 مليون، وهو الرقم الذي من المفترض أن يتضاعف ليصل إلى 55 مليون زيارة بحلول العام 2030. أما على مستوى الناتج المحلي الإجمالي فإن القطاع يسهم حاليًا بنسبة 5.3 بالمائة، وهي النسبة التي من المفترض أن تتضاعف لتصل إلى 10 بالمائة خلال العام 2030.
هذه الأرقام طموحة لا بد وأن خلفها كثيرًا من الجهود، ولأننا نعلم أن هذه الطموحات لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال وضوح كامل في هوية المدن السياحية السعودية، لتُشكِّل عنصر جذب للسائح الأجنبي الذي نطمح لاستقطابه.

إشكالية مصادر القوة في هوية المدينة
في حال كنتَ مهتمًا بمتابعة ما يُطرَح من مشاريع طموحة على مستوى مدينتك، فأنت بالتأكيد ستبدأ بعد ذلك رحلة من البحث عن مزيد من التفاصيل بشكل أكثر عمقًا للوصول إلى أكبر كمٍّ من المعلومات عن تلك المشاريع، ثم يتبع ذلك صورة ذهنية تحتفظ بها في عقلك الباطن حول كل مشروع.
تحاول بعد ذلك أن تتصوّر الشكل الشمولي للمدينة من حولك بعد أن ترى كل تلك المشاريع النور، وتظهر ملامحها بشكل جلي على أرض الواقع، لكن الإشكالية التي تتكشف لك مع مرور الوقت، هي أن هناك هوية طاغية، أو لنقل بمصطلح أقل حدة سمات تبرز ملامحها بشكل أكبر عن غيرها في هوية المدينة. وهذه المسألة بدورها تتسبب في تشتت الصورة التي تحاول أن تبرزها أنت أمام الجمهور، لذلك يجب أن تكون على درجة عالية من الإلمام بمحتوى الرسائل والأفكار المتداولة حتى لا يتعارض أحدها مع الآخر.
مدينة مثل مدينة الرياض تحمل عبق التاريخ؛ لكن لا يمكن أن نغفل أن هناك جهودًا لإضفاء الصبغة الصناعية على المدينة من خلال رموز كمركز الملك عبد الله المالي، وبالإضافة لذلك تظهر بشكل لافت سمات الترفيه مع الجهود التي نراها مؤخرًا للترويج لقطاع الترفيه.
من المهم جدًا أن تلعب الهيئات في المدن مثل الهيئة الملكية لتطوير الرياض دورًا محوريًا لتحديد معايير القوة التي تخدم الجانب السياحي دون إخلال بباقي الجوانب، وكل ذلك سعيًا لخلق صورة ذهنية واضحة.
وهنا أجد أنه من المناسب أن نشير إلى جانب آخر في تسويق الوجهات ينتقل بنا من خلال ثلاث مراحل أولها يبدأ بالترويج، يتبعها بعد ذلك التسويق حتى نصل لمرحلة صناعة علامة تمثِّل هوية خاصة بهذه المدينة، وفي مرحلة الترويج غالبًا ما تكون الرسائل صادرة من طرف واحد، فتأتي خالية من التفاعل، يلي ذلك في الدرجة الثانية مرحلة يتم فيها مخاطبة فئات محددة من المجتمع ونلاحظ هنا ارتفاع درجة التفاعل، أما المرحلة الأعلى التي يطمح أن يصل لها دومًا مسؤولو التسويق في أي مدينة، فهي مرحلة تحديد هوية واضحة للمدينة يستطيع الجمهور أن يميِّزها بوضوح جهود على كافة الأصعدة.
قبل أيام قليلة كان وزير السياحة قد أعلن عن تنظيم مجالس التنمية السياحية بالمناطق التي وافق عليها مجلس الوزراء، والذي يهدف بالأساس لتحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية.
وينص التنظيم على إنشاء مجالس للتنمية السياحية في المناطق ويكون مقرها إمارات المناطق، وبحسب التنظيم يرأس المجلس أمير المنطقة، ويضم في عضويته عددًا من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويهدف المجلس إلى العمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
ومن هذا المنطلق نلحظ أن الاهتمام بخلق هوية سياحية واضحة المعالم لكل مدينة؛ لكن الإشكاليات تتضح مع التعمق بشكل أكبر والدخول في التفاصيل. وتلعب عناصر القوة دورًا محوريًا في هذا الجانب، ففي كل مدينة هناك عناصر جذب تُبرِز جزءًا من الصورة الكاملة لهوية هذه المدينة.
استراتيجية السياحة الرقمية
ستساعد هذه الاستراتيجية في إثراء جهود إعادة بناء قطاع السياحة في المملكة، بما يحقق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” التي تعمل على وضع المملكة ضمن أهم الوجهات السياحية في العالم، كما أن تجربة المملكة في تنفيذ هذه الاستراتيجية ستكون مُلهِمة لقطاع السياحة العالمي.
وهي دعوة كما أشار معالي الوزير للمبدعين في هذا المجال للمشاركة في تحسين الإجراءات التي تنظم فضاء السياحة الرقمية.
في الدنمارك لفتت أحد التجارب انتباهي حين ركَّزتْ على تفعيل دور المرشدين السياحيين الافتراضي، ربما نكون سمعنا عن كثير من تجارب السياحة الافتراضية، لكن الجديد هو أن أي مواطن أو ساكن في المدينة يمكن أن يصبح مرشدًا وقتما يريد بمجرد الدخول على التطبيق، ليأخذ السائح الافتراضي في رحلة لمدة دقيقتين فقط. أما إذا رغبت في طلب دقائق إضافية مع المرشد الذي يطوف بك أحياء مدينته فيمكنك طلب ذلك أيضًا، ولكن مع إعطاء الأولوية لصفوف الانتظار، ولعل ذلك نوع من التشويق اللطيف في هذه التجربة، لاحظ كيف أصبح السكان من خلال هذه الفكرة جزءًا مهمًا في تجربة الزائر، حتى ولو كانت افتراضية، وبالتأكيد فلا يمكن أن نتخيل أن مثل هذه التجربة أغفلت المردود المادي.
أما في طوكيو فقد قرر أحد الباحثين أن يركز أبحاثه على سياحة المرضى المسنين تحديدًا، والانتقال بهم إلى عوالم يطوف بها خيالهم، أو ربما كانوا قد زاروها من قبل يومًا ما، حيث يؤمن هذا العالم بشكل كامل بأن هذه الرحلات ستساهم في العلاج النفسي وتخفف من حدة الشعور بالمرض.
وفي فرنسا قدمت إحدى الشركات الناشئة نموذجًا لحل ذي ارتباط بالاستدامة، عبر تطبيق يتيح لمستخدميه العثور على المطاعم والفنادق ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والفكرة ذهبت أبعد من ذلك بالسماح لأي شخص بأن يتعاون كسفير للاستدامة، فيعمل على التعريف بالمؤسسات السياحية الصديقة للبيئة، وتقييمها بحيث تسهل تجربة السياح والزوار.

التحديات:
- تضارب المصالح بين الجهات العاملة على صنع هويات المدن السياحية يخلق منافسةً لنيل الدعم الأكبر، وهو ما يحقق نجاحًا على المدى القصير، ويؤثر سلبًا على صورة المدينة.
- يتضح الاهتمام بصناعة الهوية في الجهود القائمة، لكن يكمن التحدي في رسم الصورة الشاملة.
التوصيات:
- تفعيل دور هيئات المدن في التنسيق بين الجهود لإبراز الصورة الذهنية بالشكل المطلوب.
- وضع سياسة دعم للجهات تهدف إلى الوصول للاعتمادية وعدم الاتكال على الدعم المقدم، وذلك من خلال التحفيز على الاعتماد الذاتي في توفير مصادر التمويل.
المصادر
- https://data.gov.sa/Data/en/dataset/the-main-indicators-of-tourism-demand-statistics-2021/resource/2b05e222-8e81-44b8-8b1a-61c77b1aa5b0?inner_span=True
- https://sta.gov.sa/
- https://mt.gov.sa/MediaCenter/News/MainNews/Pages/news-2-3-01-02-2022.aspx
- https://www.researchgate.net/figure/the-three-dimensional-model-of-city-brand-equity-Lucarelli-2012-240_fig1_318285802
التعقيبات:
- التعقيب الأول: أ. خالد آل دغيم
اطلعت على ما كتبه أ. علاء براده حول بناء الهوية للمدن السعودية. وقد أحسن في محورة الموضوع حول الترويج السياحي للمدن السعودية، منطلقًا من بناء الهوية والتي تركزت حول العناصر الثلاثة وهي كالآتي:
1- عناصر هوية المدينة.
2- قياس هوية المدينة.
3- أثر هوية المدينة.
وللتحسين ينبغي أن نركز على تفاصيل تلك العناصر، وما تكمن فيها من عمليات وإجراءات وأنشطة تفسيرية ومحققة لكل عنصر منها، حتى نتلافى تضارب المصالح للمعنيين، وهم الدولة، المسؤولون بالمؤسسات المحلية، المواطنون والمقيمون، السياح المحليون والعالميون.
وهذه أحد المقترحات للتحسين على سبيل المثال وليس الحصر، مثل تعزيز نماذج عمل تجارية مبنية على الاقتصاد الاجتماعي التشاركي، والذي يفعل فيه كل شرائح المجتمع المدني وبالطبع الإداري، مثل إنشاء منصة افتراضية تكون بمثابة مساحة عمل مشتركة للجميع يجد فيه الفرد والفريق والإدارة والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي والعالمي لها فيها تأثير إيجابي واقتصادي يدر دخلًا على الجميع بما يتوافق مع معايير الاستدامة ويحقق مستهدفات رؤية 2030، مثل تطبيق Airbnb، بات موقع Airbnb -اير بي أن بي الخيار المُفضل للأشخاص الذين يبحثون عن مساكن معروضة للإيجار بغرض السياحة أو الإقامة، وعلى اختلاف أنواعها (غرفة، استديو، شقة، كوخ، فيلا، شاليه، مزرعة، تخييم خارج المدينة.)، ويعد بمثابة البوابة التي تربط المنتجين والمستهلكين بمجال السكن، تمامًا مثل ما يفعل فيسبوك بمجال التواصل، أو أمازون بقطاع التجارة، أو أوبر في ميدان النقل.
وفي جانب آخر وأتوقع أنه جدير بالاهتمام هو الطراز العمراني للمدينة أو بالأخص “المدينة العتيقة” والتي يجب أن تنطلق منها أي تصاميم حديثة تقضي على التشوه البصري. بجانب نقطة مهمة إضافية وهي الاهتمام بالبيئة وهذا يزيد من جودة الحياة في المدن.
أخيرًا فيما يخص المنطقة الشرقية، لا يمكن تحديد تجارة اللؤلؤ في مدينة الدمام ونهمش شركة أرامكو وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، ومن وجهة نظري أنها وضعت بصمة في مدينة الخبر والظهران انعكس على سلوك المجتمع وكل مدن الشرقية.
- التعقيب الثاني: أ. ماهر الشويعر
يعد هذا الموضوع مهمًا جدًا لأنه ينقل المدن من مدن مغمورة أو حتى من سياحة تقليدية محدودة إلى صناعة سياحية؛ مما يعني أن هناك أنشطة أكثر ومتنوعة في المدينة ودخلًا أعلى للمدينة وخلق وظائف جديدة بشكل مباشر وغير مباشر، ومن ناحية أخرى وجود مساحات كبيرة لريادة الأعمال من خلال الأفكار المبتكرة والمرتبطة بهوية المدينة السياحية وخلق صورة ذهنية أكثر عمقًا عن المدينة واستغلالها بشكل إيجابي.
أشار كاتب الورقة الرئيسة بشكل سريع إلى الميزة النسبية للمدينة، وأرى أن الميزة النسبية هي حجر الأساس الذي تنطلق منه الهوية السياحية للمدينة، ففي مثال المنطقة الشرقية وارتباطها باستخراج اللؤلؤ الطبيعي. فاللؤلؤ هو الميزة النسبية للمنطقة والتركيز سينصب في وجود الرحلة لاستخراج اللؤلؤ في كل الأنشطة السياحية كرمزية للهوية السياحية.
ففي المدينة سنجد متحفًا متخصصًا باستخراج اللؤلؤ والذي يحكي القصة من البداية ويصور البحر والبحارة والقوارب والأهازيج التي يصدح بها النهام وأدوات الغوص ومهارات البحارة في الغوص إلى الأعماق، من أجل الوصول إلى اللؤلؤ مرورًا بالأسماك حول الغواص، ووصولًا إلى فرز اللؤلؤ وصناعة الحلي، ولا ننسى الآلام التي ترافق هذه المهنة من غرق وفقد للأحبة ومهاجمة أسماك القرش الشرسة والتي قد تفقد البحار حياته أو أحد أطرافه، وهذا الجانب الإنساني مهم، لكونه يلامس العواطف ويبقى في الذاكرة بشكل أكبر من قصة نجاح تتردد في أماكن كثيرة.
صحيح أن الهوية السياحية للمدينة هي استخراج اللؤلؤ؛ ولكن هناك عناصر أخرى داعمة لهذه الهوية مثل:
- الثقافة وما تشمله من لباس تقليدي للمدينة، والأطباق الشعبية، واللهجة المحلية، والعادات والتقاليد لهذه المدينة.
- التاريخ للمدينة، وأهم الأحداث التي مرَّت بها حتى اليوم، وهنا سيبرز اكتشاف النفط في المنطقة الشرقية.
- السياحة والترفيه والتي قد تحتوي متحفًا لاستخراج اللؤلؤ، وآخر عن القوارب وأنواعها (في الملحق تفصيل لأنواع القوارب)، ومتحفًا للأعمال الفنية التي تحاكي الهوية السياحية، ومدينة ألعاب مائية مستوحاة من البحر، ومطاعم تقدم الأكلات البحرية، ومنتزهات تحتوي على مجسمات تعرض رحلة الغوص ورحلات بحرية لمحاكاة مهنة استخراج اللؤلؤ وعيش التجربة لنحت الهوية السياحية في ذاكرة الزائر، وتخصيص جزء للأطفال، حيث تعد نوعًا من الاستثمار بعيد المدى. ويضاف لما سبق إبراز الموروث الشعبي للمدينة وتعزيزه بالمهرجانات المختلفة لخلق عالم متنوع يناسب الأذواق المختلفة.
- الأفراد من وحي الهوية ابتداءً من النوخذة ربان السفينة والمسؤول الأول والمباشر عن رحلة الغوص، وقد يكون في الغالب مالكًا لسفينة الغوص. ومن أهم السمات التي يجب أن يتمتع بها النوخذة:
- أن يكون صاحب خبرة كبيرة في مجال عمله، كأن يكون قد عمل لفترة طويلة في مجال الغوص.
- أن يكون على علم ودراية بالأماكن التي يتواجد فيها اللؤلؤ (الهيرات).
- أن تتوافر لديه معرفة كافية بعلم البحار والطقس والفلك؛ فعن طريق النجوم يعرف اتجاه السير؛ فيقود سفينته بنجاح.
- أن يمتلك شخصية قوية؛ ليستطيع إدارة العمل، والسيطرة على جميع العاملين في السفينة.
- أن يكون على علم بكل الأدوات الموجودة على ظهر السفينة، وطرق استخدامها.
- أن يمتلك أمر بيع اللؤلؤ المستخرج للتجار (الطواشين)، ولديه مصادره التي تعينه على البيع.
- المقدمي (المجدمي) :رئيس البحارة، والمسؤول عن العمل في السفينة، والأمين على حاجاتها.
- الغيص (الغواص): يغوص في البحر لجمع المحار.
- السيب: يقوم بسحب الغيص من قاع البحر.
- الجلّاس (اليلاّس) أو الفليج: يقوم بفتح المحار.
- السكوني: مسك بدفّة السفينة ويستجيب لأوامر النوخذة في توجيه السفينة ورفع الشراع.
- النهّام (النهيم): يُغنّي لطاقم السفينة؛ فيخفف عنهم رحلة غربتهم، ويحفزهم على العمل.(1)
أوردت مهام الأفراد في رحلة استخراج اللؤلؤ لعكس مدى ثراء هذه المهنة وتنوع أفرادها وإمكانية خلق مادة دسمة فقط من هذه الجزئية، وهذا ينطبق على جميع الأجزاء وقدرتنا الإبداعية لإبراز سمات الهوية السياحية للمدينة.
- التجارة والصناعة، تنشأ من هذه الهوية أرضية خصبة للإبداع وريادة الأعمال من تجارة وصناعة التحف والتذكارات والثقافة من لباس وحِلٍّي وأوانٍ وصناعة ترفيه، حتى خدمات السكن يمكن خلق تجربة فريدة للزائر من وحي الهوية، مثل السكن في قارب يشبه قوارب استخراج اللؤلؤ أو بيت تقليدي قديم. يجدر بالذكر أن الأفكار الإبداعية لرواد الأعمال قد تصنع الفرق في تعزيز الهوية.
- الخدمات، تقدم خدمات أساسية وأيضًا خدمات أخرى تساعد الزائر على التعرف على الأماكن مثل الخريطة التفاعلية والمرشد السياحي الإلكتروني والذي يعزز تجربة الزائر وينوعها، والأهم إبقاء الزائر أطول مدة ممكنة، وأن يصرف أكبر قدر ممكن من ميزانيته ويرغب في تكرار الزيارة مرة أخرى. والتركيز على الجانب التقني في الخدمات واستغلال الذكاء الصناعي والفينتك لتعزيز الصورة الذهنية للهوية السياحية للمدينة.
- الإعلام وهو ركيزة أساسية في صناعة الهوية السياحية للمدن وتعزيزها بالاعتماد على المؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة الأفلام الثقافية، وعرض الهوية السياحية في الأعمال الدرامية، وتأليف الكتب عن مكونات الهوية بعمق وصناعة الألعاب الإلكترونية المرتبطة بالهوية السياحية. وقد تلاحظون تكراري لمسألة التحف والتذكارات؛ لأنه من أنجع وسائل التسويق للهوية، ووسيلة إعلامية جيدة للتعريف بالهوية السياحية.
- الميثولوجيا إن لم تكن موجودة فيجب إيجادها من العدم أو اقتباسها من المدن القريبة لما لها من أثر إيجابي في دعم الصورة الذهنية للهوية الوطنية؛ ولكن في مثالنا الحالي توجد بعض الأساطير وربما يهمنا حوريات البحر اللاتي يخطفن البحارة.
- الجوانب الأمنية يجب أن تحظى هذه المدن بمستوى عالٍ من الأمن والقوانين التي تحفظ حق الزائر، وتجنب خلق تجربة سلبية لديه. ومن ناحية أخرى يجب حماية الهوية السياحية للمدينة من العبث أو الاستنقاص أو التشويه بأي شكل كان.
تزخر مدن المملكة بميزات نسبية تحتاج لفريق احترافي لتوظيف هذه الميزة النسبية في الهوية السياحية للمدن، ولا تُترك لأفراد غير احترافيين قد يشوهون الهوية السياحية للمدينة، كما أن الهوية السياحية للمدن يجب أن تكون عملًا متكاملًا يشارك فيه الجميع ويُنفَّذ بطريقة صحيحة لا تنعكس سلبًا على الهوية لاحقًا.
الهوية السياحية يجب أن تكون متطورة ومتغيرة مع الزمن، نظرًا لسرعة تغير مخرجات الثورة الصناعية الرابعة ولتلبية متطلبات الزوار.
التحديات:
- مواكبة جميع أذواق الزوار وتوفر تنوع غني من هذه الهوية السياحية ويناسب المستويات المختلفة من الدخل، وليست حصرًا على فئة محددة.
- صناعة محتوى متكامل للهوية السياحية للمدينة وتنفيذه باحترافية والاستمرار في تطويره.
التوصيات:
- وجود فريق حكومي موحد ومحترف يصنع الهوية السياحية لجميع المدن ويقدم دراسة متكاملة للجهات ذات العلاقة لتنفيذه.
- مشاركة التجارب الناجحة بين المدن وتعزيز الهوية السياحية بشكل احترافي وخصوصًا الأفكار الإبداعية.
- الهوية السياحية للمدن هي رمز، ومنه يجب أن تتفرع عدة أجزاء تدعم الهوية السياحية مثل التي تم ذكرها في المثال أعلاه بشكل تكاملي بين جميع الأجزاء.
- مشاركة جميع أطياف مجتمع المدينة ومؤسساته الحكومية والأهلية في تعزيز الهوية السياحية لمدينتهم.
- وجود آليه للتغذية المرتجعة من الزوار والاستفادة منها في تطوير الهوية السياحية للمدن.
الملحق
أنواع القوارب:
- الجالبوت: من السفن الشهيرة في الخليج العربي، كانت تستعمل في الغوص والبحث عن اللؤلؤ، والتجارة، والسفر، وصيد الأسماك. طولها بين 20 و30 قدمًًا، وحمولتها بين 15 و60 طنًا.
- السنبوك: من السفن القوية التي كانت تُستخدم في الصيد، والغوص، ويبلغ طولها 60 قدمًا، وحمولتها تشبه الجالبوت. ويذكر أن ابن بطوطة أرَّخ عنها قائلًا: “ركبت من ساحل البصرة في (صنبوق) وبينها وبين البصرة عشرة أميال.
- البوم: أفضل السفن في نقل البضائع عبر الهند وباكستان وشرق إفريقيا، طولها بين 100 و150 قدمًًا وحمولتها بين 300 و750 طنًا .
- بتيل: سفينة قديمة حمولتها بين 20 و50 طنًا تستعمل في استخراج اللؤلؤ، ويقال إن تسميتها تعود لأسرة (باتيل) الهندية
- شوعي: سفينة تُستعمل للغوص وصيد الأسماك، يتراوح طولها بين 60 و80 قدمًا.
- البقارة: يتراوح طول البيص فيها 30 أو 40 قدمًا، والعرض 15 أو 17 قدمًًا، وحمولتها تزيد على 20 شخصًا.
- الصمعة: يتراوح طول البيص فيها بين 20 و30 قدمًا، والصغير منها لا يتجاوز 20 فوت، أما العرض فيتراوح بين 15 قدمًا و17 فوت تقريبًا.
- الكيت: قارب صغير يلحق بالمركب على شكل قارب نجاة.
بانوش: قارب يشبه السنبوك؛ لكنه صغير الحجم، يُستعمل للصيد والتنقل، ويمتاز بصدره العمودي، ومؤخرته مرتفعة ويستعمله البعض في صيد اللؤلؤ. - دنكية: من السفن القديمة التي كان يستعملها أبناء الخليج قديمًا، وهي من طرز السفن الباكستانية، وتلفظ باللهجة الدارجة دنجية. (2)
المصادر:
- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%A9
- https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
- المداخلات حول القضية
- الهوية السياحية وعلاقتها بسمات المدن الأساسية.
إن الهوية والصورة الذهنية في أبسط المعاني هي الملمح التلقائي الأولي الذي يتبادر إلى الذهن حال الحديث عن شيء ما.. مثلًا مدينة كان الفرنسية إلى جانب معطياتها السياحية الطبيعية؛ إلا أن هويتها والصورة الذهنية الأبرز عنها تتمثل في الثيمة السينمائية الفارقة التي سكّها مهرجان كان السينمائي. أيضًا العلا في المملكة.. رغم الأهمية الزراعية والتاريخية؛ إلا أن هويتها وماهيتها وصورتها الأبرز تتلخص في البعد الآثاري بوصفها متحفًا عملاقًا مفتوحًا لم تُكتشَف أسراره بعد.. والأمثلة كثيرة. من هذا الامتداد.. إلى أي مدى يُعد بروز جانب جذب سياحي لمدينة ما بوصفه هوية دالة لها أمرًا سلبيًا بالنظر إلى تراجع بروز جوانب جذب أخرى؟
وثمة علاقة بين العناصر السياحية وهوية المدينة؛ حيث إنها غالبًا ما تكون مؤثرة في تعزيز تلك الهوية. وتذهب بعض وجهات النظر إلى أن طغيان أحد سمات هوية المدينة بشكل لافت قد يُظهِر صورة المدينة بشكل مشوش، وكمثال فإن الرياض مدينة تحمل هوية تاريخية متمثلة في الدرعية، واليوم نشاهد توجهًا لبناء صورة ترفيهية للمدينة وكمثال على ذلك القدية، هناك توجه صناعي يمكن أن يظهر بشكل جلي من خلال المركز المالي على سبيل المثال، وهنا تبرز الإشكالية إذا لم يتم عرض الهوية بشكل صحيح. أيضًا فإن فعاليات كموسم الرياض ومن ثم موسم جدة وغيرها من المواسم يعطي جميع المدن صبغة واحدة يطغى عليها الجانب الترفيهي. كما أنه “ومع انتشار الطُّرز المعمارية والتطوير العمراني الحديث، أصبحت العديد من المدن السعودية تحت تهديد اندثار هويتها العمرانية الأصيلة”.
وعلى الجانب ترى وجهات نظر أخرى أن طغيان أحد سمات هوية المدينة بشكل لافت قد لا يؤثر على تشويش شكل المدينة، ولنا خير مثال: مدينة باريس، أحد الوجهات السياحية العالمية، حيث تعد من أكبر عواصم العالم من حيث عدد السياح القادمين لها سنويًا على مدار العام، فرغم أن السمة الأولى لها أنها عاصمة للموضة والجمال، لكن هذا لم يؤثر على صيتها كأحد أهم الدول المتقدمة طبيًا لعلاج عديد من الأمراض المستعصية، وأصبحت وجهة طبية رئيسية وأيضًا لقاصدي عمليات التجميل بأنواعها. كذلك ليس هناك أكثر من سياحها الذين يقصدونها للجانب الترفيهي سواء في ديزني لاند، أو للتمتع بالفنون الأخرى في متاحفها أو مسارحها؛ فهي تعد مدينة أساسية لعشاق الفنون، حيث تجمع أهم متاحف العالم، ويوجد فيها وحدها حوالي 60 مسرحًا، ودارًًا للأوبرا. وأقام بها عدد من أشهر الرسّامين مثل: بيكاسو، ورينوار وماتيس، ومن الروائيّين: فيكتور هوجو، وأندريه جيد، وألبير كامو، والمفكر جان بول سارتر؛ لذا يقصدها كثير من السياح لرؤية العديد من المنحوتات الفنية الشهيرة، والذهاب لساحة مونمارتر قبلة الرسامين.
أيضًا لا يمكن إغفال أن هناك عددًا لا يستهان به يذهب كسياحة أو إقامة لغرض تعليمي لينال شرف الدراسة في جامعة السربون، وغيرها من معاهدها التعليمية المتميزة بدورات في مختلف المجالات، من أهمها: (فنون الطبخ، تصميم الأزياء، المكياج، صبغات الشعر، الإتيكيت). ولأن لباريس عدّة ألقاب، منها: مدينة الحب؛ ارتبط العشق والحب بهذه المدينة، فأصبحت من الوجهات التي تختارها النخبة من الأمراء والمشاهير والنجوم لإقامة حفلات زواجهم بها. وهناك أيضًا من يقصدها كسياحة دينية؛ ليتمتع بزيارة أشهر الكاتدرائيات والكنائس في العالم، ومنها: كاتدرائية نوتردام وكنيسة القلب المقدس وكنيسة سانت تشابل وكنيسة سان سولبيس وكنيسة ماري ماجدولين. كما أن باريس تتميز كمدينة بتقديم أفضل المخبوزات – الكرواسون الابتكار الفرنسي الأشهر – والحلويات الفرنسية. وفيها تجمع لأفضل بوتيكات الحلوى والمكارون في العالم مثل LaduréeوPierre Hermé و Fauchon وهناك من يقصدها لهذا الغرض.
وليس هناك ما يمنع الرياض – أو جدة من أن تكون وجهة اقتصادية وطبية وترفيهية وتعليمية وغيرها في ذات الوقت. بالفعل كان المقصد ترفيهيًا كبداية، لكن وجدناه قد فتح الباب لكثير من التجار الخليجيين وغيرهم للتسابق لفتح فروع لمطاعمهم أو محلاتهم لقوة السوق السعودي، وأصبحنا بعدها وجهة استثمارية اقتصادية، ولا نغفل أن الرياض من فترة ليست بالقصيرة أصبحت وجهة طبية لبعض التخصصات، كفصل التوائم وطب العيون. وكمثال آخر هناك مدينة (دمياط) المصرية التي تشتهر فقط بصناعة الأثاث، ومن يقصدها لهذا الغرض فقط سواء من مشترين أو تجار وغيرهم؛ لذا ربما كانت السمة الوحيدة أفضل في المدن الصغيرة وليست في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية، لقد طال انتظار تحقيق أن تكون دولتنا وجهة سياحية، لكن الأهم هو تضافر الجهود وتوحيدها لإبراز أهم سمات المدن بشكل متوازٍ ومتكامل.
ومدننا السعودية يمكن أن تتميز بهويات سياحية، وذلك بسبب تنوع تضاريسها ومناخها وثقافاتها الفرعية ومناشطها الاقتصادية؛ فمدينة جدة على سبيل المثال وهي على مستوى البحر دافئة شتاء؛ وبالتالي قد تصبح “مشتى” ممتازًا لمن يودون زيارتها وقضاء بعض الوقت فيها أثناء فصول الشتاء (ديسمبر ويناير وفبراير). هذا يتطلب أن تكون أنشطتها السياحية مصممة حسب الفصل، مع الأخذ في الاعتبار إمكاناتها أثناء شهور الصيف وذلك كمدينة بحرية (شواطئ وأنشطة ورياضات بحرية). ولا ننسى كذلك أنها بوابة مكة بالنسبة للحجاج والمعتمرين ما يضفي عليها أهمية اقتصادية بالغة كمركز تجاري، إلا أن ذلك يعني ضرورة توفير مواصلات متقدمة وأكثر من مطار لكي تستوعب الزوار، علمًا أنه قد بلغ عدد المعتمرين خلال رمضان 1443 نحوًا من 20 مليون زائر، وهو عدد كبير يتوجب معه وجود مطار كبير يستوعب هذا العدد حتى وإن كان نشاط العمرة موسميًا.
ومن المدن التي تستحق عناية خاصة بسبب إمكاناتها السياحية المتوقعة مدينة الطائف المصيف التقليدي للمملكة؛ فهذه المدينة لم تكتمل بنيتها السياحية بدرجة كافية رغم كل شيء، إذ لا تزال تعاني من نقص حاد في الشقق المفروشة والفنادق، بل إن معظم شققها المفروشة رديئة وغير لائقة بمدينة مهمة كالطائف، وتتضح مشكلة السكن في فصول الصيف، وهي ذات المشكلة التي نجدها في أبها والباحة ومدن الجنوب. ويمكن اقتراح فكرة الأكواخ الخشبية الصغيرة في الجبال فهي قليلة التكلفة في إنشائها واستثمارها في السياحة، وحتمًا سيغطي تكلفتها حتى لو تم إشغالها شهرين أو ثلاثة في السنة.
ويمكن الإشارة كذلك إلى مدن صغيرة على ساحل البحر الأحمر كاملج وضبا وحقل، فهذه المدن بحاجة ماسة إلى تأهيل لكي تصبح سياحية، فاملج مثلًا تتميز بجمال شاطئها (الدقم) والفرص الكامنة للأنشطة البحرية فيما لو استُغلت بصورة تجارية، لكن المدينة ينقصها الفنادق والسكن المناسب، وكذلك المطاعم وملاهي الأطفال؛ فما هو موجود فيها غير كافِ.
إن كل منطقة ومدينة وبلدة مع التطور الثقافي والحس السياحي سوف تجد فيها إنسانها وجغرافيتها وتاريخها ما نستطيع تطويره لجذب شرائح معينة من السائحين.. كلٌّ بأسلوبه وطريقته وخلفياته وابتكاره.. فالعامل المشترك والدافع هو تطور الحس والانتماء والثقافة والحاجة.
وفي سياق متصل، فإنَّ سمات الأفراد وأبرزها تأتي مع بناء الهوية المتكاملة للمدينة، تكون بعد ذلك هنالك رسائل إعلامية متكررة لتشكيل سمات الأفراد وإحياء ما اندثر منها، وخلق ثقافة مجتمعية متميزة، بشرط أن لا تكون عائقًا للهوية.. فمدن مثل الأحساء وحائل والمدينة والعلا يمكن أن يكون لها سمة أفراد؛ لأن نسبة اختلاط الأفراد بأفراد من خارج مجتمعهم محدودة، بينما مدن مثل الرياض والخبر وجدة نظرًا لوجود عدد كبيرة من الثقافات والأعراق يصعب خلق سمة للأفراد؛ ولكن يمكن الاستفادة من هذا الاختلاف وجعله جزءًا من الهوية. في جدة مثلًا تجد فرصة لتذوق أطباق من المطبخ الإندونيسي والإفريقي والطاجيكي؛ فالهوية يجب أن تستفيد من أي مكون متوفر في المدينة.
كذلك فهناك مدن في المملكة اشتُهرت ببعض الحرف اليدوية، وبعضها في طريقها للانقراض لعدم إقبال الشباب عليها وبعضها باقٍ. ومن ذلك صناعة البشوت في الأحساء والفخار والخصف. وفي القصيم هناك الأحذية القصيمية الجلدية (الزبيريات)، وفي الطائف العطورات الوردية، وفي المنطقة الشمالية السجاد اليدوي من الصوف والوبر، ويمكن تطوير هذه الصناعات بحيث يكون هناك مراكز للتدريب عليها يقوم عليها أصحاب الحرف، وذلك لخلق هوية لكل منطقة من خلال منتجاتها.
ويمكن التنسيق بين وزارة السياحة والغرف التجارية في كل منطقة لمعرفة الحرف اليدوية والصناعات المحلية التي تُشتهَر بها كل منطقة وتخصيص سوق في كل مدينة لهذه المنتجات. سوق كهذا سيكون مزارًا للسياح وسيكون نقطة جذب بشرط أن يقوم عليه سعوديون.
لكن ثمة تساؤل مفاده: لماذا نقصر هوية المدينة على الجانب السياحي لها؟ أليس من المفيد أن يكون لكل منطقة ومدنها الرئيسية في المملكة الهوية الخاصة بها؟ هذه الهوية تعكس وتنعكس على الجانب العمراني والثقافي والتاريخي لها وطبيعة النشاطات التي تمارس في المنطقة والمدينة. ومن هذه الهوية الأساسية تنبثق الهوية السياحية التي يتم الترويج لها وتسويقها لجذب السياح والزائرين، وبالتالي سيكون الأسلوب مختلفًا من مدينة ومنطقة لأخرى. كذلك بعض المدن يكون لها هوية ليست بالضرورة سياحية وإنما صناعية أو زراعية أو غير ذلك. ومن يقصدها من الداخل والخارج يكون لغرض العمل وليس السياحة.
- آليات بناء استراتيجية سياحية وطنية متكاملة.
تعد السياحة في السعودية أحد القطاعات الناشئة ذات النمو السريع، ومن المؤكد أنه سوف يكون لرؤية 2030 تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر بعدة طرق على قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالنظر إلى أن مقومات السياحة لمختلف المدن في المملكة غنية جدًا، ولكن تحتاج دارسًا رصينًا، فسير أغوارها ليست بالعملية السهلة، فلا بد من تقليبها على أوجهها المختلفة، اقتصاد، تضاريس، مناخ، شخصية أفرادها، تفردها، وإن أردنا النجاح، فبدايته داخليًا، وأكثر القطاعات المناط بها هذا الدور التعليم والإعلام،. ثم يأتي الدور المساند لبقية الجهات كالسياحة والبلديات.
وربما كان عامل السمات الشخصية للسكان، أحد العوامل التي لا يستهان بها في تطوير الهوية السياحية للمدن، فهناك سمات للشعوب، قد تكون عوامل جذب، أو عوامل غير جاذبة للسياحة في بلدانهم، ولذلك فإن صناعة الهوية السياحية تحتاج لاستراتيجيات تسير في كافة الممكنات والتحديات لها.
وبالتأكيد، يحرص السائح على التوجه إلى المدن والمناطق ذات الشعوب المُرحِّبة التي تتقبل الزوّار بمختلف جنسياتهم وحضاراتهم، لذلك يُعد وعي الشعب وحسن الضيافة والاستقبال وعدم الاستغلال السيء للسياح، من أهم عوامل جذب السياح. ناهيك عن استتباب الأمن؛ فنسبة الأمان في الدولة المراد زيارتها مطلب مهم؛ فكم من دولة تعرض سياحها للسرقات والنشل أو للاستغلال وأثَّر ذلك على سمعتها السياحية بشكل كبير. وربما لا يمكن للسياحة في المملكة، أن تزدهر كما هو مخطط لها دون التركيز بشكل كبير على تثقيف وتدريب وتمكين الشعب السعودي بشكل عام، وبالأخص ساكني المناطق السياحية السعودية المُعوَّل عليها جذب السائحين من مختلف دول العالم على التعامل مع السياحة والسياح بشكل حضاري. فأي تجاوزات وتصرفات غير مقبولة من بعض السكان، تكون كفيلة بإعطاء صورة سيئة جدًا عن السعوديين وبعض التصرفات غير المحسوبة، وتؤثر سلبًا على سمعة الشعب السعودي، والعكس صحيح. ولعلنا شاهدنا الأثر الإيجابي بعد المقاطع التي انتشرت بعد مرور بعض متسابقي الرالي في بعض مناطق المملكة، والاستقبال العفوي لهم من بعض الأطفال والنساء والذي أوضح الكرم السعودي الأصيل.
ومن المهم أيضًا كذلك التشديد على تثقيف جميع العاملين بقطاع السياحة سعوديين وغيرهم بحفظ مفقودات السياح والتواصل معهم لإعادتها قبل أن يلحظوا اختفاءها. مع التأكيد على منح الهدايا للملتزمين وفرض العقوبات للمخالفين، وهنا لن يتردد الزائر من اختيار السياحة لنا مرارًا وتكرارًا.
التعامل مع الآخر المختلف في العقيدة ليس حرامًا، له شروطه، ولكنه ليس محرمًا، كما أن حسن التعامل بنية تأليف القلوب مطلوب، وجميل أن يكون لكل منطقة سمة حتى لو كانت بعض السمات النفسية، بالإضافة للسمات الطبيعية وغيرها، فاختلاف الأماكن في ذلك يشجع على السياحة وزيارة المناطق المختلفة، البعض قد يخاف من العنصرية، لكن لا يوجد للعنصرية مجال هنا! هي فقط سمات يتميز بها أهل مدينة أو منطقة من الجميل أن تظهر، وهو طبيعي. نريد للسائح لا أن يرى ما تتميز به طبيعة كل بلد يزورها فقط؛ ولكن أن يشعر مشاعر مختلفة أيضًا. ويرتبط بذلك التأكيد على أهمية التدريب على حسن التعامل وزيادة كثافة العاملين في الحرمين حتى يستطيعوا أن يقابلوا الضيوف – مهما كان فكرهم- بوجه مبتسم. فأحيانًا لا يستطيعون ذلك لكثرة الضغوط عليهم وعليهن، ولكن زيادة الأعداد وقصر الدوريات، وتثقيفهم عن ثقافة الشعوب الإسلامية وكيفية التعامل معهم مهم جدًا، فأهم سياحة لدينا هي السياحة الدينية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن وزارة السياحة لها جهود مميزة في مجال تطوير العاملين في قطاع السياحة، حيث أطلقت برنامج “تطوير مهارات الكونسيرج” وهو أحد البرامج المبتكرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى الارتقاء بمهارات وقدرات العاملين في الأنشطة السياحية، حيث يركز البرنامج على تنويع الفرص التدريبية للعاملين في منشآت الإيواء السياحي، وصقل مهاراتهم وفق أفضل البرامج الدولية المعتمدة؛ ليسهموا في رفع مستوى جودة الخدمات وإثراء تجربة الزائر المحلي والدولي، بما يحقق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية جاذبة، كما أن لها برنامجًا لتنمية رأس المال البشري السياحي، يدعم العاملين والممارسين في القطاعات السياحية الفرعية في جميع المراحل المهنية لاعتماد معرفتهم وقدراتهم ومهارتهم حسب المعايير والتصنيف العالمي بالتعاون مع المنظمات السياحية الدولية. واهتمت كذلك وزارة السياحة بزوّار المملكة العربية السعودية، من خلال توفير خط ساخن للتواصل معهم (مركز العناية بالزائر) الذي يرحب بهم على مدار الساعة.
ومن منظور أشمل، فإن المدن أصبحت مصدرًا هامًا من مصادر القوة الناعمة لأي بلد، ويتطلب استثمارها وجود برامج ومبادرات وتنسيق وتكامل لتحقيق أقصى قدر ممكن من الجاذبية والتأثير حول العالم، دون إغفال لدور الإنسان في كل مدينة من حيث بشاشته ورقيه وخلقه وحسن تعامله مع الآخرين، فهذه هي المكونات الأهم لـ “روح المدينة”.
وتؤيد بعض الآراء القول بأن مجال السياحة السهل والمتاح حاليًا هو السياحة الدينيّة في مكّة والمدينة والحجاز بصفة عامّة. ولو تم التوسّع في هذا المجال والاستفادة من كل الآثار والمشاهد والمواقع المذكورة لكان كافيًا في الوقت الحاضر، ثمّ التوسّع لاحقًا فيما عدا ذلك. مثلًا تطوير درب الهجرة وبناء محطات متطورة للراحة عليه، ووضع برامج سياحيّة لتتبّع هذا الدرب بالسيارة وعلى الجِمال وبالمشي. وكذلك مواقع المعارك الإسلاميّة القديمة وطقوسها وقصصها ودرب زبيده وغيره، إضافة الى التوسّع في رحلات الحج والعمرة وجعلها أكثر راحة وجدوى وهكذا، فهناك نحو مليار ونصف مسلم جميعهم يتمنون زيارة البلاد المقدّسة.
وتوجد أهمية لموضوع الشواخص السياحية بالنسبة للمدن؛ كون المدن تأخذ هويتها من خلال شواخصها، وقد تكون هذه الشواخص طبيعية أو بنائية، فعلى سبيل المثال يعتبر مرقب الشنانة مُعبِّرًا عن محافظة الرس. والتصور أن هذه الصور الرمزية أو الشواخص هي مرحلة مهمة لبناء الهوية السياحية للمدن في المملكة، ومن الضروري وجود شاخص لكل مدينة ومحافظة وإبرازه إعلاميًا.
وفي السياق ذاته فإن تجربة السائح النهائية هي الصورة التي تتبلوَّر عن هذا المكان وهذه الصورة ينقلها لمن حوله. والمعنيُّ هو السائح وهو يأتي للمكان تحت ضغط هذه الصورة وشغف الاكتشاف وحب الاستطلاع وعيش التجربة. وهنا يبدأ دور المعنيين سواء معماريين ومهندسين ومخططي المكان أو إعلاميين أو مختصي تسويق لتوظيف هذه الصورة في تسويق المدينة ودعمها. والواقع أن السائح يحتاج أن يمارس حياته الطبيعية ويمارس النشاط الذي تم إعداده في هذا المكان (النمط السياحي للمكان).. التسوق. التزلق. الطبيعية.. المغامرات.. التراث.. المعارض والمؤتمرات.. أيًّا كان هذا النمط.. وممكن للسائح أن يمارس أكثر من نمط سياحي في المكان قبل المغادرة بشكل نهائي من المكان. ويمر على هذه الأنماط في وقت وجوده بالمكان؛ لكن يبقى من المهم التأكيد على دور المعنيين في توظيف هذه الصورة (مسؤولي المدن والمخططين والمعماريين ومختصي التسويق والإعلاميين السياحيين ومن له دور في تعزيز هذه الصورة السياحية عن المكان، وإبراز النمط المهم في تسويق الوجهة السياحية للمكان أو المدينة بشكل عام.
ومن المقترحات المطروحة تفعيل تدريس اللغات المختلفة للنشء كنشاط غير صفي في المدارس السعودية في جميع أنحاء المملكة كنوع من التدريب على مهارات التواصل والتفكير خارج الصندوق، ويعود هذا على المجتمع برفع قدرته على إيصال رسالة المملكة بنشر التعاليم الإسلامية بشكل فطري وبسيط يتناسب مع طبيعة الآخر، لأن تعلم اللغات يكسر الكثير من الحواجز الثقافية ويسهل إيصال المعلومة بشكل أفضل.
وثمة أهمية للعمل على تطوير المنتجات السياحية بالمدن وبناء هوية مرتبطة بالمنتج المناسب ووضع الخطط لتسويقها حسب منتجاتها واستهداف أسواق، لذلك فالسياحة عندنا مكلفة نوعًا ما، فأسعار الشقق المفروشة والغرف الفندقية في المدن السياحية مرتفعة نوعًا ما، مما يُشكِّل عائقًا أمام الجذب السياحي.
وهذا دليل على ضرورة الدراسات وعمل المسوحات اللازمة لبناء المنتج السياحي وتعزيز الهوية السياحية حتى نتجاوز المعوقات التي تعيق ذلك. كما أن هناك ضرورة للتكامل بين القطاع العام والخاص في هذا الصدد والبحث بدقة في بناء الهوية السياحية.
وقد يكون من المناسب النظر في إيجاد مؤسسات أهلية للمدن ترجع لمجالسها البلدية، ويكون أهم مسؤولياتها تطوير هوية المدينة وتشجيع السياحة فيها وزيارتها والتعاون مع الغرف التجارية في ذلك.
ومن الضروري كذلك عمل دراسة مسحية موسعة تتناول خصائص السائح السعودي ولماذا يسافر خارج المملكة، وماذا يريد، ومعوقات السياحة الداخلية، على أن تكون العينة مكونة من ثلاث شرائح: الشباب من الجنسين، كبار السن، العائلات، وعقد مقارنات بين هذه الشرائح ومتطلباتها السياحية للخروج بنتائج وتصورات مفيدة.
ومن المهم تحديد عناصر الجذب في كل مدينة ومنطقة سواء التاريخ، أو الثقافة، أو الصحة، أو الفنون، ووضع برامج لمدد مختلفة وميزانيات مختلفة، ومراعاة اهتمامات الفئات العمرية وحجم الأسرة. كما أن من المهم جدًا تأهيل المرشدين السياحيين وتطوير المرافق الخدمية ومنها التي على الطرق. وحبذا لو أمكن الاستفادة من وجود السياح ووضع استبيان لمعرفة آرائهم في تجربتهم في المملكة وما الذي يريدونه أكثر. كما لا بد أن نراعي عامل المناخ في اختيار الأوقات المناسبة للفعاليات والأنشطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة عوامل سياحية جاذبة في المدن السعودية يجب الإفادة منها؛ ففي الجانب المناخي في الوطن نجد التنوع الثري في الجهات الجغرافية الأربع. هذا التنوع المناخي يمنح السياحة لدينا إمكانية السياحة في سائر فصول السنة، كما أن لدينا عمقًا تاريخيًا توثقه المخطوطات والمنحوتات الصخرية منذ آلاف السنين، وتؤكده أشعار العرب التي تحدثت عن الأماكن والأحداث المختلفة. وفي تاريخ الجزيرة العربية عدة لغات محكية مكتوبة على الصخور كالثمودية واللحيانية والمسمارية، وكمية نقوش قد لا تتوفر في بلد آخر، وبالتالي فإن المملكة تستحق أن تكون من أهم مقاصد العالم في جانب السياحة إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل. كما تظهر الحاجة للتركيز على المعالم التي تميزت بها المملكة كالمدن الصناعية والمنشآت النفطية، ومنها أكبر مدينة صناعية في العالم (الجبيل)، وأكبر منشأة نفطية في العالم (خريص)، وأكبر حقل نفط (الغوار)، وعاصمة النفط (الظهران) مع عدم إغفال الجانب الأمني لزيارة السائح لهذه المناطق.
أيضًا يمكن العمل على تسويق المطبخ السعودي المتنوع الذي لا يضاهيه مطبخ في العالم لتعدد الأذواق والأطباق المناطقية، فضلًا عن تسويق الفنون الشعبية المتعددة سواء التراثية أو الطربية.
وتبرز الحاجة لإعداد استراتيجية خاصة بالإعلام السياحي، “بهدف تأصيل العمل المهني لممارسات الإعلام السياحي في المملكة.. وتتبلور أهمية تنظيم استراتيجية خاصة بالإعلام السياحي في ضبط الممارسات المهنية لهذا القطاع في المملكة، انطلاقًا من اعتبارين أولهما تحقيق مقتضيات الوظيفة الإعلامية لتطوير القطاع السياحي السعودي، وثانيهما تحقيق مبدأ التكامل والتنسيق في رعاية العمل الإعلامي مع الجهات المختصة”.
أيضًا ومما لا شك فيه فإن الخصوصية الثقافية والجغرافية والاجتماعية لمناطق المملكة ومحافظاتها جديرة بإبرازها مؤسسيًا، وألا تُترَك عفويًا أو لاجتهادات بعض المتطوعين أو الموظفين، والأهم أن ما تقدمه مراكز التفكير جدير بطرح هذه الموضوعات، ويمكن لأي من الجهات المختصة التقاط هذه المبادرات البسيطة وإسقاطها على أرض الواقع، وفي النهاية تحقيق النتائج التي ترتبط مباشرة برؤية المملكة وأهدافها الاستراتيجية. وفي ضوء ذلك يمكن اقتراح تمويل إعداد دراسة استشارية معمقة لتفعيل الهويات السياحية للمدن السعودية، من قبل وزارة الثقافة.
التوصيات
- تفعيل دور هيئات المدن في التنسيق بين الجهود لإبراز الهوية السياحية للمدن.
- وضع سياسة دعم للجهات فيما يتعلق بالهوسة السياحية للمدن تهدف إلى الوصول للاعتمادية وعدم الاتكال على الدعم المقدم، وذلك من خلال التحفيز على الاعتماد الذاتي في توفير مصادر التمويل.
- تصميم استراتيجية وطنية شاملة تنظم فكرة الهوية السياحية للمدن في المملكة عبر تنسيق الجهات ذات العلاقة.
- العناية بالهوية السياحية الرقمية للمدن كونها متطلبًا رئيسًا في سياق الحضارة الرقمية.
- تركيز الجهود العلمية لتعميق مبحث الهوية السياحية للمدن على المستويين النظري والتطبيقي عبر استحضار أبرز التجارب الرائدة عالميًا وتطويرها وفقًا للأطر الثقافية المحلية.
المصادر والمراجع
- سهى حسن الدهوي ويوسف عيسى علوان: دور الشاخص السياحي الديني في أبعاد تأصيل الهوية العمرانية للمدينة، المجلة العراقية للهندسة المعمارية، المجلد (31)، العدد (3)، 2015م.
- خالد بن عبدالرحمن آل دغيم: الإعلام السياحي وتنمية السياحة الوطنية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2014م.
- يوسف عيسى علوان: دور العناصر السياحية في تأصيل الهوية العمرانية للمدينة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة التكنولوجية، العراق، 2015م.
- يوسف بن طراد السعدون: هوية السياحة في المملكة العربية السعودية، متاح على الرابط الإلكتروني:
https://www.al-jazirah.com/2019/20191023/ar6.htm
- تقرير تعزيز التنمية السياحية عن طريق الملكية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، سويسرا، ومنظمة السياحة العالمية، إسبانيا، 2021م.
- إبراهيم محمد البلوز: دور التصميم العمراني في الحفاظ على الهوية العمرانية المحلية في منطقة الجوف، جامعة الجوف، متاح على الرابط الإلكتروني:
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/sfudjp2019/6.pdf
- التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات السياحة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمم المتحدة، نيويورك، 2011م.
- عبدالمجيد الرجوب ورامي الشوابكة: توظيف التراث العمراني في السياحة، مجلة المنارة، المجلد (26)، العدد (3)، 2020م.
- سيرا SEERA: تحليل مفصل لقطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، متاح على الرابط الإلكتروني:
https://www.seera.sa/wp-content/uploads/2019/12/Seera-Skift-Report-Arabic.pdf
- دانا تيسير: تقرير عن السياحة في السعودية وجهود المملكة في السياحة، 10يناير 2021م، متاح على الموقع الإلكتروني: https://mhtwyat.com
- المشاركون.
- الورقة الرئيسة: أ. علاء الدين براده
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: أ. خالد آل دغيم
- التعقيب الثاني: أ. ماهر الشويعر
- إدارة الحوار: أ. سعيد الزهراني
- المشاركون بالحوار والمناقشة:
- أ. فائزة العجروش
- د. خالد المنصور
- أ. د عائشة الأحمدي
- د. عبدالإله الصالح
- د. خالد الرديعان
- د. حميد الشايجي
- د. سعود كاتب
- د. عبدالله الحمود
- د. وفاء طيبة
- د. حمد البريثن
- د. عبدالرحمن العريني
- د. فهد العرابي الحارثي
- أ. مها عقيل
- أ. فهد الأحمري
- د. رياض نجم
- د. عبير برهمين
- د. مشاري النعيم
- د. محمد الثقفي
- د. فواز كاسب العنزي
- د. الجازي الشبيكي
القضية الثانية
الجمعيات التعاونية حلول
للمجموعات الصغيرة
(1/6/2022م)
- الملخص التنفيذي.
تناولت هذه القضية الجمعيات التعاونية وحلولًا للمجموعات الصغيرة. وأشار أ. ماهر الشويعر في الورقة الرئيسة إلى أن الجمعيات التعاونية هي كيان يهدف لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها في نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق، الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء باتباع المبادئ التعاونية، وهي تقدم الحلول في خفض التكاليف أو زيادة العائد أو الاستفادة من كبر شريحة المستفيدين في الجمعية التعاونية، وهي غالبًا ما تكون تخدم فئة صغيرة في المجتمع تجمعهم منطقة جغرافية وحرفة متشابهة أو حاجة موحدة. وربما يكون أشهرها وأكثرها انتشارًا هي الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تنتشر في أغلب دول العالم. يضاف إلى ذلك، أن الجمعيات التعاونية هي جزء من رؤية المملكة 2030 وتهدف أن تشارك بنسبة 1% من الناتج المحلي السعودي.
ومن التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية بالسعودية الوعي المجتمعي بأهمية ودور الجمعيات التعاونية لحل مشاكل المجموعات الصغيرة نسبيًا وامتلاك قوة أكبر من العمل الفردي، بجانب وجود قيادات تدير عمل الجمعيات التعاونية بشكل احترافي، وتستفيد من الميزات المتاحة لهذه الجمعيات التعاونية، وتفهم الأنظمة الحكومية وتتماشى معها، فضلًا عن عدم وجود دعم من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة أو الهيئات الحكومية.
بينما أكَّد د. احسان بوحليقة في التعقيب الأول على أن التدليل على القيمة المضافة التي بوسع الجمعيات التعاونية أن تقدمها للمجتمع وللاقتصاد تتضح من تجارب حولنا في منطقة الخليج العربي، تبرز منها التجربة الكويتية، وهي سباقة وعامة ولها حضور طاغٍ على الساحة، وكذلك التجربة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في إمارة دبي، وكذلك لها تأثير ولا سيما في الأحياء السكنية.
في حين ذكر أ. الحجاج بن مصلح في التعقيب الثاني أن الفرق بين المنظمة التجارية والجمعية التعاونية هي أن الثانية تهدف لمنفعة الأعضاء، بينما الأولى هدفها ربح المستثمرين. وحتى مع اختلاف الأهداف السامية، فالجمعيات التعاونية يجب أن تخضع لآليات الاقتصاد في نشأتها وفي استمراريتها.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- واقع وأهمية الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية.
- المعوقات التي تحد من فاعلية الجمعيات التعاونية ودورها المأمول.
- آليات دعم الجمعيات التعاونية والإفادة منها.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:
- دعم استقلاليّة القطاع التعاوني ووضعه تحت الإشراف التنظيمي لهيئة مستقلّة.
- نشر الوعي حول أهمية التعاونيات من خلال ما يمكن تحقيقه من مميزات وأهداف لأعضائها، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتوضيح الفرق بينها وبين الجمعيات الخيرية، وإقامة مؤتمر إقليمي أو وطني حول العمل التعاوني.
- إزالة العوائق أمام التعاونيات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل سهولة الحصول على التراخيص.
- إيجاد الحوافز المالية وغير المالية مع توفير برامج تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع التعاونيات.
- تعديل الأنظمة الحالية ذات العلاقة التي تدعم حصول الجمعيات التعاونية على حصة أكبر من السوق منها وتعديل المادة (45) في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليشمل التعاونيات، ويهدف هذا التعديل المقترح إلى إضفاء الشمولية على نظام المنافسات والمشتريات.
- الورقة الرئيسة: أ. ماهر الشويعر
مقدمة:
تعريف الجمعيات التعاونية حسب موقع وزارة الموارد البشرية بأنها: كيان يهدف لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها في نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق، الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء باتباع المبادئ التعاونية.
فهي تقدم الحلول في خفض التكاليف أو زيادة العائد أو الاستفادة من كبر شريحة المستفيدين في الجمعية التعاونية، وهي غالبًا ما تكون تخدم فئة صغيرة في المجتمع تجمعهم منطقة جغرافية وحرفة متشابهة أو حاجة موحدة. وربما يكون أشهرها وأكثرها انتشارًا هي الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تنتشر في أغلب دول العالم. يضاف إلى ذلك، أن الجمعيات التعاونية هي جزء من رؤية المملكة 2030 وتهدف لأن تشارك بنسبة 1% من الناتج المحلي السعودي.
من واقع التجربة:
كوني أحد المهتمين بمرض السلياك (حساسية القمح) والذي يخضع المرضى إلى حمية صارمة خالية من الجلوتين المتواجد في القمح والشعير والشوفان والجاودار كعلاج وحيد لهذا المرض، والذي يُشكل فيه المرضى المكتشف حالاتهم نسبة 0.1% من المجتمع السعودي، بينما لا زال 2.2% لم تُكتشف بعد. ولكون القمح أساسًا في عاداتنا الغذائية فقد افتقد المرضى الخبز الخالي من الجلوتين والمنتجات الخالية من الجلوتين مثل المعكرونة والبسكويت وأصنافًا أخرى أساسية للمرضى وليست شائعة في المجتمع مثل صمغ الزانثان ودقيق التبيوكا ودقيق الأرز. لذا تعاونا مع طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قسم إدارة الأعمال في بحث التخرج لإيجاد حل مناسب لمشكلة المرضى، وكان الحل الأمثل إنشاء جمعية تعاونية في كل مدينة كبيرة توفر محلًا مختصًا ببيع المنتجات الخالية من الجلوتين ومخبزًا يقدم بجانب الخبز بأنواعه المختلفة بعض الحلويات التي يفتقدها مريض السلياك. وأثبتت الدراسة نجاح المشروع على مستوى الجمعيات التعاونية وليس العمل التجاري البحت لفرد أو شركة، وتحل مشكلة مجموعة من الناس يجمع بينهم عوامل مشتركة ما كانت لتُحل بدون الجمعية التعاونية بين مرضى السلياك.
نرى هنا كيف أن الجمعية التعاونية كانت الحل للمرضى، بعد أن لم يساعدهم رجال الأعمال بالاستثمار في هذا القطاع؛ لأن المشروع غير مُجدٍ اقتصاديًا بالمقاييس التجارية وتكلفة الفرصة البديلة أفضل بكثير ووجود تحديات كثير من بينها عمر المنتج وكمية الشراء وأسعار البيع ونسبة التالف ورأس مال المشروع. بالمقابل سيجد مرضى السلياك خبزًا طازجًا يوميًا وحلويات حُرِموا منها سابقًا، بالإضافة لتكامل المنتجات التي قد يحتاجونها في مكان واحد وبسعر مناسب بعد أن كانوا يطلبوها من خلال بعض المواقع على الإنترنت.
على جانب آخر، الجمعيات التعاونية الزراعية تعطي أعضاءها قوة تفاوضية أمام موردي الأسمدة والمبيدات الحشرية والمعدات الزراعية، وكذلك بيع المنتجات بأسعار أفضل بعد تقصير قنوات البيع والتخلص من جزء من تجار الجملة والاستفادة من هامش الربح أكبر، مدعومة بكونها كيانًا قانونيًا مستقرًا ومستمرًا. وقد يتطور الأمر للجمعيات التعاونية الزراعية إلى الجانب الصناعي مثل التصنيع الجزئي أو الكلي والتغليف والتبريد أو التجميد والتخزين والتوصيل الذي يخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية أو التقليل من ضرر تذبذب الأسعار والموسمية في الإنتاج أو الاستهلاك، وهذا الجانب لا يستطيع فرد القيام به منفردًا؛ ولكن وجود مجموعة تحتاج نفس الخدمات يجعل من الجانب الصناعي مجديًا اقتصاديًا. ومن ناحية أخرى، تزيد من فاعلية الإنتاج وتقلل الخسائر.
ومن التجارب الناجحة للجمعيات التعاونية ما هو قائم الآن في دولة الكويت للجمعيات الاستهلاكية (سوبر ماركت) في الأحياء لسنوات طويلة، وتقوم وزارة الموارد البشرية السعودية بدراسة تطبيق هذا النوع من الجمعيات التعاونية في السعودية لكسر احتكار سلاسل السوبر ماركت الكبيرة والتي أصبحت تملك قوة تفاوضية عالية جدًا في وجهة الموردين وخصوصًا المصانع السعودية، وقد تحتاج هذه الجمعيات إلى عملية شراء موحد لخلق قوة تفاوضية مع الموردين.
الميزات النسبية للجمعيات التعاونية
بالإضافة لما ذُكر أعلاه من قوة تفاوضية وحل لمشاكل مجموعة من أفراد المجتمع وإمكانية تطوير الخدمات والتصنيع:
- كيان قانوني يمكنه التخاطب مع الجهات الرسمية بشكل رسمي.
- سهول الإنشاء.
- الدعم المادي الحكومي مما يقلل التكاليف.
- الرعاية الحكومية.
- مسؤولية محدودة.
- الإعفاء الضريبي باستثناء الزكاة الشرعية.
- الاستمرارية.
سلبيات الجمعيات التعاونية
- عدم وجود سرية.
- قلة المهارات التجارية والإدارية في بعض الحالات.
- الفساد في الإدارة.
- ارتفاع أسعار العقار في حالة وجود منافذ بيع.
- ضعف الإقبال على المساهمة في الجمعيات التعاونية، نظرًا لانخفاض العوائد المادية.
الفائدة المجتمعية من الجمعيات التعاونية
- خلق وظائف جديدة.
- كسر الاحتكار وتوفر منتجات أو خدمات بأسعار مناسبة.
- رفع جودة المنتجات ووجود منتجات جديدة ذات قيمة مضافة لسد حاجة المجتمع.
- حل مشكلة قائمة لفئة محددة من المجتمع تجمعهم مصلحة واحدة.
الخاتمة
الجمعيات التعاونية هي حلول لمشاكل المجموعات الصغيرة لتخطي العمل الفردي، من خلال زيادة القوة التفاوضية وتنظيم العمل بشكل أكثر احترافية لتحقيق أهداف المجموعة، وفي بعض الأحيان خلق قيمة مضافة للمنتجات أو الخدمات المقدمة من الجمعيات التعاونية. والمثل الشعبي يقول: ” قوما تعاونوا ما ذلوا”
التحديات:
- الوعي المجتمعي بأهمية ودور الجمعيات التعاونية لحل مشاكل المجموعات الصغيرة نسبيًا وامتلاك قوة أكبر من العمل الفردي.
- وجود قيادات تدير عمل الجمعيات التعاونية بشكل احترافي وتستفيد من الميزات المتاحة لهذه الجمعيات التعاونية وتفهم الأنظمة الحكومية وتتماشى معها.
- عدم وجود دعم من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة أو الهيئات الحكومية.
التوصيات:
- نشر الوعي حول الجمعيات التعاونية ودورها وما يمكن أن تحققه من ميزات وأهداف لأعضائها وعرض قصص النجاح لجمعيات قائمة، لتشجيع الفئات المستفيدة.
- وجود مستشارين في وزارة الموارد البشرية يقدمون الدعم الإداري والفني للجمعيات التعاونية والرقي بالأداء ابتداءً من مرحلة التأسيس وبعد عملها بما في ذلك الجانب المحاسبي.
- إزالة العوائق أمام الجمعيات التعاونية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
ملحق:


- التعقيبات:
- التعقيب الأول: د. احسان بوحليقة
بدايةً أتقدم بالشكر لكاتب الورقة أ. ماهر الشويعر لتناوله موضوعًا مهمًا؛ لكنه لم يحظَ حتى الآن بالانتشار الكافي، رغم أن الحديث عنه دام عقودًا من الزمن، وأتفق مع كاتب الورقة بأن الجمعيات التعاونية هي الحل الأنسب لعدد من التحديات، لكن لماذا هذا العزوف، فعدد الجمعيات التعاونية النشطة أقل مما هو مرخص بكثير؟
لعل الإجابة تحتاج إلى دراسة ميدانية معمقة، لكن يبدو أن أحد أصعب المعوقات الذي يحد من انتشار الجمعيات التعاونية، على الرغم من الحاجة الماسة لها، هو الحصول على الترخيص، إذا ما قارناه بالحصول على الترخيص منصة للتمويل الجماعي مثلًا! ولعل المطلوب، بكل بساطة، هو خفض المُتَطلّب من “ترخيص” إلى “تسجيل”، بمعنى إذا رغب مجموعة من الأشخاص إنشاء جمعية تعاونية لتوفير المنتجات الخالية من الجلوتين فكل ما هو مطلوب أن يدخل أفراد تلك المجموعة على منصة وتسجيل أسمائهم وبعض التفاصيل عن الجمعية التعاونية ورفع بعض الأوراق الثبوتية، لتصدر لهم مباشرة شهادة تسجيل، ومعها قائمة بالخدمات والحوافز التي تقدمها الجهات المعنية في الحكومة. لكن الوضع ليس كذلك، فعلى الرغم من القبول العام لفكرة إنشاء جمعيات التعاونية، إلا أنها ليست حالة عامة بل ما زالت محدودة رغم فوائدها الجمة التي تناولها كاتب الورقة في ورقته.
وبمجرد حصول المجموعة المؤسِسة على التسجيل ينبغي أن تُفتَح لها كل سبل الدعم (إداريًا وماليًا)، بما يمكنها أن تصبح حقيقةً قائمةً تساهم ليس فقط في تحقيق الأهداف المباشرة للمؤسسين، بل كذلك أهداف المجتمع ككل، بما في ذلك المستهدفات الطموحة للرؤية. ومبرر الحماس لتخفيف متطلبات قيام الجمعيات التعاونية هو أن اقتصادنا إجمالًا يعاني من محدودية المنافسة، ومن سيطرة بعض الموردين والمصنعين على منتجات وخدمات، فمثلًا في نشاط تجارة التجزئة نجد أن من يسيطر على السوق هو عدد صغير من المنشآت الكبيرة، من الهيبرماركت والسوبرماركت. واحتكار القلة أمر ينطوي – ضمن أمورٍ أخرى- على محدودية المنافسة، مما يعني ارتفاع هامش الربح إجمالًا، وهذا يأتي بالضرورة على حساب المستهلك النهائي. لنتصور الآن وجود جمعيات تعاونية في الأحياء، يمتلك السكان (أو من يرغب منهم) فيها أسهمًا، ويُعيَّن لها فريق إداري نشط، وأنها عبارة عن “بقالة الحي”، وأن يتفق الملاك على هامش ربح بحيث يغطي المصاريف التشغيلية وفي نهاية العام يرد الربح إلى الملاك أو يعاد ضخه لتحسين وتوسيع الجمعية. عايشت تجربة واقعية في جامعة الملك فهد حيث كان هناك جمعية تعاونية في سكن الأساتذة، وكانت عبارة عن سوبرماركت مع بعض الخدمات، كانت تجربة رائدة، لكن تأثيرها اضمحل مع مرور الوقت. في تقديري لأسباب خارجة عن نطاق الجمعية ذاتها، قد يكون بسبب فتور الحماس ورحيل معظم الجيل المؤسس لها.
ويكتسب موضوع الجمعيات التعاونية أهمية متزايدة مع ارتفاع مؤشر الأسعار، فهي وسيلة للحد من تكسب التجار من ارتفاع الأسعار؛ فقد تزيد تكلفة صنف معين على التاجر 5 بالمائة فيرفع السعر بنسبة أعلى، كما هو مشاهد، فمثلًا ارتفعت مدخلات إنتاج الدجاج وبيض المائدة؛ ولكن ليس بالقدر الذي رفعوا التجار به الأسعار. وليس من السهل أن تتمكن جمعية تعاونية بمفردها أن تكافح التضخم، لكنها بالتأكيد ستساهم في ضبط سعر الضروريات ضمن حدود التكلفة، بالإضافة إلى ربح محدد سيعود ما يفيض منه على الجمعية وأغراضها في نهاية المطاف.
وكما لا يخفى، فلا تنحصر أنواع الجمعيات التعاونية في تجارة التجزئة أو تسويق المنتجات الزراعية، بل قد يكون لها أغراض إبداعية جديدة، كأن تكون متخصصة في سلع معينة، كما في المثال الذي استخدمه كاتب الورقة -المنتجات الخالية من الجلوتين- أو نشاط التجزئة في الأطعمة والأشربة كما في السوبرماركت، لكن بالإمكان أن تقدم خدمات تقنية أو مالية على سبيل المثال لا الحصر.
ختامًا، فإن التدليل على القيمة المضافة التي بوسع الجمعيات التعاونية أن تقدمها للمجتمع وللاقتصاد تتضح من تجارب حولنا في منطقة الخليج العربي، تبرز منها التجربة الكويتية، وهي سباقة وعامة ولها حضور طاغٍ على الساحة، وكذلك التجربة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في إمارة دبي، وكذلك لها تأثير ولا سيما في الأحياء السكنية.
التوصيات:
- تخفيف متطلب الترخيص إلى تسجيل، للتسريع في إطلاق المزيد من الجمعيات التعاونية، حيث إن أعدادًا كبيرةً تنتظر صدور ترخيصها، فالتخفيف سيساهم في إضافة منشآت منتجة للاقتصاد وسيساهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
- إعادة النظر في حزمة الدعم والحوافز -المالية وغير المالية- التي تُقدم إلى الجمعيات التعاونية، ولا سيما في فترتي “ما قبل الإنشاء” و”الإنشاء”، بغية تعزيزها.
- أن تقوم الجهات الحكومية المعنية ببرنامج يهدف إلى تسويق فرص استثمارية يمكن أن تتحقق من خلال جمعيات تعاونية.
- التعقيب الثاني: أ. الحجاج بن مصلح
الفرق بين المنظمة التجارية والجمعية التعاونية هي في أن الثانية تهدف لمنفعة الأعضاء، بينما الأولى هدفها ربح المستثمرين. وحتى مع اختلاف الأهداف السامية، فالجمعيات التعاونية يجب أن تخضع لآليات الاقتصاد في نشأتها وفي استمراريتها.
ومن المعلوم أيضًا أن الجمعيات تنشأ عن طريق وجود أعضاء أفراد مستقلين منتجين اقتصاديا أصلًا، بغض النظر عن نوع الإنتاج: زراعي، خدمي، محلات، وغيرها. وبالتالي عند غياب هؤلاء الأعضاء في بادئ الأمر، فهو يفضي إلى التساؤل عن احتمالية نشوء الجمعية التعاونية، لأنه ما هنالك من أفراد منتجين يمكن أن يشكلوا مجموعة تتعاون، أصلًا.
بقراءة الورقة فيلاحظ أنها لم تنجح في:
- إبراز النموذج الاقتصادي المستدام، بحيث يفضي إلى انطلاق واستمرارية المشروع.
- إبراز حجم الطلب بالريال والذي يُبنَى عليه القرارات الاستثمارية والتجارية.
- إثبات وجود أعضاء منتجين اقتصاديًا يمكن لهم تكوين منظومة اقتصادية تعاونية.
- النقد السليم من منظور اقتصادي للكيانات التجارية القائمة حاليًا: مثلًا السوبرماركت.
- المقارنة بين حاجات الأمراض الأخرى التي يمكن أن تبعث التساؤل: لماذا فقط خدمة مرضى السيلياك؟ وهل يفترض أنه لكل مرض يتم اقتراح كيان اقتصادي جديد، مثلًا هنا الجمعية التعاونية؟
- توضيح لماذا تم تفضيل استراتيجية الاندماج الرأسي وليس الأفقي (فمثلًا التوجه للتصنيع) وما هي المقومات الاقتصادية والقيمة التنافسية المتوفرة بالمقارنة مع الخيارات الأخرى؟
- ما هو العائد على الاستثمار الحكومي في هذا الكيان؟ وهل يتماشى مع استراتيجيات الحكومة في نفس الوقت (مثلًا التوجه الاستراتيجي للخصخصة): هل هو حجم السوق، أم كلفة المعالجة والتداوي (لكن هناك توجه للتأمين الطبي لجميع المواطنين)؟
- تقديم أمثلة مشابهة أو مقاربة في إنشاء مثل هذه الجمعيات التعاونية في دول أخرى، حيث إن الجمعيات التعاونية في الكويت أو الشارقة تحتوي على تنويع كبير في الأصناف، وهي مشابهة لما هو موجود في محلات التجزئة التجارية (السوبرماركت).
ليس مفهوم لديَّ، هل الجمعية التعاونية المقترحة هي استهلاكية أو زراعية؟ وبالتالي معرفة تموضعها الصحيح في سلسلة التوريد وما يتعلق به من قرارات استراتيجية وتجارية. كما أوردت الدراسة مغالطة عن السوق التجاري بذكر وجود الاحتكار وأعتقد شخصيًا أنه غير موجود في سوق الأغذية والمنتجات الاستهلاكية السعودي (عدد المحلات كبير وملاكها مختلفون).
مما لا شك فيه أن الحجم الاقتصادي أو اقتصاد الحجم هو أحد الاستراتيجيات المطبقة؛ لكنه من اسمه يحتاج إلى حجم. وعلى الرغم من أن سوق المنتجات الخالية من الجلوتين يعتبر سوقًا متخصصًا (Niche Market)، وبالتالي يمكن بداهة عدم ملاءمة استراتيجية اقتصاد الحجم لها، وهذا ما يظهر في الوهلة الأولى، لكن في فحوى الفكرة أن يتم استخدام نموذج الجمعيات التعاونية لخلق الحجم الاقتصادي الملائم لاستمرارية المنظومة الاقتصادية.
- المداخلات حول القضية
- واقع وأهمية الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية.
تعد الجمعيات التعاونية الشكل الرسمي للتعاون الذي يقوم على مبادئ وقوانين وأسس محددة. وتتمثل مبادئ التعاون الأساسية (مانشستر 1995) فيما يلي:
- العضوية الاختيارية والمفتوحة.
- إدارة الأعضاء ديموقراطية.
- مساهمة العضو اقتصاديًا (يساهم الأعضاء بعدالة).
- الإدارة الذاتية والاستقلالية.
- التعليم والتدريب والإعلام.
- التعاون بين التعاونيات.
- الاهتمام بالمجتمع.
الجمعيات التعاونيّة ركيزة مهمّة من ركائز التنمية المستدامة للمجتمعات، فهي تركّز على تشارك الأعضاء معًا لتقديم خدمة ما لمجتمعهم، في الغالب لا يستطيع أحدهم تقديمها بمفرده، كما أن نظامها الداخلي يؤكّد على ديموقراطيّة القرار وإدخال البعد الاجتماعي والوطني والظروف المحلية، إضافة إلى الربحية، وهذا ما يميّزها عن القطاع الخاص. وهي مهمّة جدًا في وقت الأزمات وفي المجتمعات النائية والفقيرة. كما أن الجمعيات التعاونيّة آمنة بسبب الرقابة الداخلية المتحصلة من خلال أعضائها الذين هم عدد كبير من أفراد المجتمع المحلّي الذي يُدار فيه النشاط، وفي الغالب تُسيِّرها مجالس ولجان منتخبة. كما يمكن أن تساعد التعاونيات في مساندة قرارات الدولة في وقف ارتفاع الأسعار وفك الاحتكار لبعض السلع، ومن المفترض أن يكون لدى الجمعيّة التعاونيّة دراية بظروف وأحوال المجتمع المحلّي، ولذلك تجد التعاونيّات فعّالة في أوقات الأزمات؛ لأن التعاونيات تعتمد في الخدمات والعاملين في الغالب على العناصر المحلية. فمثلًا الجمعيّة التعاونية الاستهلاكيّة في منطقة ما يُفترَض أن يكون لديها عقود مباشرة مع المزارع المحليّة ومربي الماشية وصيادي الأسماك للتزوّد بالخضار واللحوم والأسماك، كما أن لها ارتباطات واتفاقيات مع الجمعيات والمنظمات المدنيّة الأخرى. فمثلًا في حالة الحروب -لا سمح الله- إذا انحسرت الخدمات التي تعتمد على الخارج تنشط الجمعيات بقوّة، وقد لوحظ ذلك في بعض البلدان التي تأثّرت بكورونا في وقت الإغلاق الكبير، عندما شحّت السلع وغلي ثمنها مثل مصر، حيث اعتمدت الدولة على توزيع المؤن الضروريّة من خلال الجمعيات.
وقد أعلنت الأمم المتحدة عام 2012 عامًا دوليًا للجمعيات التعاونية، إقرارًا منها بأهمية مشاركة هذا القطاع في التنمية والحد من الفقر وخفض معدلات البطالة وتوفير الاندماج الاجتماعي في مختلف أرجاء العالم. والبعض يطلق على التعاونيات “الاقتصاد الاجتماعي” أو “الاقتصاد الثالث” فهو في منزلة بين المنزلتين: اقتصاد السوق الرأسمالي، والاقتصاد الاشتراكي.
وتعكس الإحصائيات التالية جانبًا من أهمية هذا القطاع:
- يضم قطاع التعاونيات نحو 800 مليون عضو في أكثر من 100 بلد في العالم. ويوفر زهاء 100 مليون وظيفة، وكانت أعلى نسبة مئوية لمساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 45٪ في كينيا، تليها نيوزيلندا بنسبة 22٪.
- تسهم التعاونيات الزراعية بنسبة 80 إلى 99٪ من إنتاج الحليب في النرويج ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وتسهم بنسبة 71٪ من إنتاج السمك في كوريا الجنوبية و40٪ في البرازيل.
- توفر تعاونيات الكهرباء في ريف بنغلاديش الكهرباء لنحو 28 مليون مواطن، ولما يقارب 37 مليون مواطن في الولايات المتحدة من خلال 900 تعاونية.
- هناك 49 ألف اتحاد ائتماني توفر الخدمات لنحو 177 مليون عضوًا في 96 بلدًا في العالم تحت مظلة المجلس العالمي للاتحادات الائتمانية.
- يوفر نحو 4200 مصرف تعاوني أوروبي الخدمات لنحو 149 مليون عميل في أوروبا بما في ذلك مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
- في كندا 70٪ من السكان أعضاء في جمعيات تعاونية وفي فنلندا 62٪ وفرنسا 35٪ ونحو 75٪ من المنتجين الزراعيين في فرنسا هم مؤسسات تعاونية.
- في بلجيكا 5٪ من المنتجات الدوائية تنتجها مؤسسات تعاونية.
- في الكويت 70٪ من تجارة التجزئة هي قطاع تعاوني.
- في النرويج تسيطر التعاونيات على 96٪ من سوق الألبان، و55٪ من سوق الأجبان، و70٪ من سوق اللحوم، و70٪ من سوق البيض، و52٪ من سوق الحبوب، و15٪ من سوق مواد البناء، وترتفع النسبة إلى 40٪ في مدينة أوسلو، و30٪ من سوق التأمينات على غير الحياة.
وعلى مستوى المملكة فقد كانت أول جمعية تعاونية في المملكة تم تأسيسها عام 1380هـ في القريات، وكانت جهود أهلية (غير رسمية). وفي عام 1382 أُنشئت جمعية أخرى في الدرعية، ولكن بصورة رسمية وتحت مظلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاحقًا).
- المعوقات التي تحد من فاعلية الجمعيات التعاونية ودورها المأمول.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مجلسًا للجمعيات التعاونية في المملكة يقوم بعمل متميز وفق حوكمة منضبطة، ويحقق قصص نجاح خلاقة. ومن قصص النجاح تلك على سبيل المثال جمعية دواجن عسير التي أصبحت ضمن أكبر منتجي الدواجن في المملكة وغيره من النجاحات. ومع ذلك فإن عدد وحجم الجمعيات التعاونية في المملكة محدود جدًا مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني الذي تجاوز ثلاثة تريليونات ريال، كما أن معظم الجمعيات التعاونية يقتصر مجالات عملها على خدمات الزراعة والجملة والتجزئة، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان التي تعمل الجمعيات التعاونية في معظم أوجه الاقتصاد الخدمية والإنتاجية، فعلى سبيل المثال يبلغ دخل أكبر 300 مؤسسة اقتصادية تعمل وفق تصنيف المؤسسات التعاونية ما يزيد عن تريليون ونصف تريليون دولار.
وفي دول الاتحاد الأوروبي وحدها نحو 250 ألف جمعية تعاونية يملكها 160 مليون مواطن (ثلث سكان الاتحاد الأوروبي) ويعمل بها 5.4 مليون شخص، وتمثل في بعض دول الاتحاد الموظف الأكبر للشباب. وتمتلك التعاونيات حصصًا سوقية كبيرة في الصناعات، على النحو التالي:
- الزراعة: 83٪ في هولندا، 79٪ في فنلندا، 55٪ في إيطاليا و50٪ في فرنسا.
- البنوك: 50٪ في فرنسا، 37٪ في قبرص، 35٪ في فنلندا، 31٪ في النمسا و21٪ في ألمانيا.
- التجزئة: 36٪ في فنلندا و20٪ في السويد.
- الأدوية والرعاية الصحية: 21٪ في إسبانيا و18٪ في بلجيكا.
بل أحد أكبر البنوك الفرنسية المؤسسة على أساس تعاوني يبلغ دخله نحو 110 مليار دولار وكريديت اجريكول الشريك الفرنسي في البنك السعودي الفرنسي.
ويؤكد ذلك أن المجال لا يزال مفتوحًا لزيادة مساهمة التعاوني في الاقتصاد الوطني.
ويرى البعض أن من أهم الصعوبات التي تواجهها الجمعيات التعاونيّة؛ كثرة القيود الحكوميّة وعدم فهمها من قبل الجهات الحكوميّة، فهناك صعوبة في الترخيص؛ حيث ما زال الترخيص يخضع للموافقة الأمنيّة ويأخذ فترة طويلة، حتّى يتم إقراره من قبل وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخليّة؛ مع أن الترخيص للمؤسسة أو الشركة ممكن أن يتم في يوم أو يومين، والجمعيّة التعاونيّة مثل الشركة لها مساهمون يدفعون أموالهم ولها مجلس منتخب، وفوق ذلك تخضع لإشراف وزارة الموارد البشريّة. ولعل سبب صعوبة الترخيص الخلط السابق بين الجمعيات التعاونيّة والجمعيات غير الربحيّة، أضف إلى ذلك تسلّط الجهة الإشرافيّة وبيروقراطيتها وسوء فهم موظفيها لصلاحياتهم تجاه الجمعيات التعاونيّة، والتغيّر السريع في مسؤولي الوزارة وعدم إلمامهم بمفهوم القطاع التعاوني، فتجد مكتب التنمية التابع للوزارة يتحكّم في الجمعيّة ويعطّل أعمالها، بينما مجلس الجمعيّة منتخب ومخوّل من جمعيّتها العموميّة، ونادرًا ما يستطيع مكتب التنمية الإجابة على تساؤلات الجمعيّة أو يحل مشاكلها أو يتحمّل أي مسؤولية، أضف إلى ذلك ازدواجيّة التعامل من قبل الجهات الحكوميّة، فتجد وزارة التجارة تصر على سجل تجاري للجمعيّة، بينما وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية ترى أن السجل التعاوني يكفي، ولذلك تتعطّل معاملات التعاونيّة في الوزارتين، فلا ينظرون لها كقطاع خاص، وفي نفس الوقت لا ينظرون لها كقطاع أهلي من ضمن القطاع غير الربحي، وتجد صعوبات في الحصول على تأشيرات للعمالة الأجنبيّة، كما تدفع الجمعيّة التعاونيّة الزكاة وتدفع مساهمة مجتمعيّة من أرباحها. وتواجه الجمعيات التعاونية صعوبة كبيرة في فتح حساب في البنك، وليس هناك أي جهة مخوّلة بإقراضها عدا بنك التنمية الاجتماعي الذي يطلب ضمانات مبالغ فيها كصكوك عقار أو حساب بنكي وبقدر القرض بالضبط، ولا يقبل الاكتفاء برهن المشروع ويضع سقفًا أعلى قدره عشرة ملايين ريال سعودي فقط لإقراض الجمعيّة التعاونيّة. ولا تلقى الجمعيات التعاونيّة تفضيلًا أو حتّى تعاونًا من قبل البلديات في منحها أراضٍ لإقامة مشاريعها، فمع أن النظام يعطيها الحق في منحة أرض مساحتها 2500م٢، حيث تجد طلبات الجمعيات مجمّدة لدى البلديات لسنين طويلة، وهذه بعض الإشكالات التي تواجه القطاع التعاوني.
وفي الإطار ذاته وفيما يتعلق بالمعوقات التي تحد من فاعلية دور الجمعيات التعاونية في الواقع السعودي تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- الجمعيات التعاونية نشاط اجتماعي محمود، لكن ما زال نجاح المشروع في مجتمعنا ضعيفًا جدًا، في جامعة طيبة الجمعية التعاونية ظل جمع أسهمها ما يقرب شهرين، حتى أقفل الاكتتاب فيها، وعلى شاكلتها كثير من المشاريع الاقتصادية الاجتماعية.
- نلاحظ أن درجة الوثوقية في إدارة مثل هذه المشاريع لدى المساهمين منخفض جدًا، في نفس الوقت تجد أن الأعمال الخيرية كالأوقاف تجد قبولًا بدرجة أكبر.
- للأسف فإن الدعاية لمثل هذه المشاريع ضعيف، وبالتالي فإن الإقبال عليها حتى من الميسورين ضعيف للغاية، لا سيما في الإفصاح عن الفئة المنتفعة منها.
- ما زال هناك قصور من الإعلام، لا سيما الإعلام الرسمي في توضيح الدور الذي تلعبه مثل هذه الجمعيات في حل كثير من قضايا الفقر والبطالة والاندماج أيضًا.
وقد يرجع عدم انتشار الجمعيات التعاونية ونجاحها إلى أنها تندرج ضمن المجالات المشهورة التي تلامس مشاعر المواطن العادي تنافس بيوتًا ومؤسسات وتقاليد وهياكل تجارية راسخة في الوطن.. هذا الرسوخ له بلا شك مميزات كبيرة قد لا ندركها (الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يدركه إلا المرضى) فالكويت مثلًا تواجه ضعفًا شديدًا في سلاسل الإمداد والتنوع السلعي وأمور أخرى، ولكن لها عيوب ظاهرة أهمها الاحتكار بكل أنواعه.
وتشير بعض الآراء إلى أن بيروقراطيّة الجهة المشرفة وتحكمها في كل كبيرة وصغيرة والتجاوزات للنظام واللوائح، كبّلت التعاونيات وهمّشت دور مجلس الجمعيات الذي هو بمثابة اتحاد أعضائه، 13 منهم منتخبون من مختلف الجمعيات في مناطق المملكة، إضافة إلى 4 أعضاء من الوزارات الخدميّة. وفي الدورة الأخيرة أصرّت الوزارة على تعيين خمسة أعضاء في المجلس بقرار من الوزير، إضافة إلى ممثّل الوزارة في المجلس، بالرغم من معارضة مجلس الجمعيات وجمعيته العمومية، وجميع المعلومات عن القطاع التعاوني مربوطة بالوزارة وغير منظمة ولا يستفاد منها ولا يطّلع المجلس إلا على النزر اليسير منها. ولعل ربط المجلس بالوزارة هو السبب في مثل هذه الممارسات ومن أكبر العوائق في وجه تطوير القطاع التعاوني في المملكة، وسيكون القطاع في أفضل حال لو أُعطي الاستقلالية في صيغة اتحاد مستقل أو تحت هيئة تنظيميّة متخصصة ومنفصلة تُراجِع مجلس الوزراء مباشرة.
وأشارت نتائج إحدى الدراسات المتخصصة عن التعاونيات في دول مجلس التعاون إلى أن أبرز معوقات التعاونيات في المملكة تتمثل فيما يلي:
- رغم الاهتمام الرسمي بالتعاونيات، إلا أن مسيرتها التنموية لا تزال ضعيفة من حيث العدد والفعالية والنشاط والتوزيع الجغرافي. قد تتركز التعاونيات في منطقة أو مناطق وقد لا نجد لها ذكرًا في مناطق أخرى.
- على الرغم من أن المملكة شرعت للتعاونيات الاستهلاكية منذ زمن طويل، وتم تعديل نظامها عام 1429، الا أن التشريعات ساوت بين التعاونيات من حيث التخصص، ولم توفر لكل نوع تشريعات خاصة به؛ فمثلًا جمعيات الإسكان التعاوني بحاجة إلى نظام خاص بها يختلف عن نظام التعاونيات الاستهلاكية.
- يعد ضعف “ثقافة التعاون” لدى أفراد المجتمع من أهم المعوقات التي تواجه انتشار التعاونيات، حيث هناك جهل بشروط تأسيس التعاونية رغم أن 12 شخصًا يستطيعون التقدم لوزارة الموارد البشرية لتأسيس تعاونية.
- من أهم المعوقات التي تحد من انتشار التعاونيات تلك المرتبطة بفك الاشتباكات التي تثور بين المساهمين ومجالس الإدارة أو بين أعضاء المجالس أنفسهم، أو إجراءات تصفية التعاونيات. ويعود ذلك إلى إخفاق الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية التي أُنشِئت من أجلها، كخدمة أعضائها من حيث توفير السلع والخدمات بأسعار منخفضة مع ربح معقول يوزع بين المنتسبين للتعاونية نهاية كل عام.
- تواجه التعاونيات في المملكة نقص التنسيق فيما بينها، وهذا إخلال واضح بالمبدأ السادس الذي ذكرناه سابقًا (التعاون بين التعاونيات). يضاف إلى ذلك ضعف التمويل بسبب صعوبة الحصول على قروض من البنوك والجهات الممولة.
- ضعف الحوكمة وغياب الشفافية في بعض التعاونيات لا يساعد على استمرار التعاونية، ويجعل منها مرتعًا للفساد المالي والإداري.
- بيروقراطية وزارة الموارد البشرية في التصريح للتعاونيات، فتقديم طلب إنشاء تعاونية قد يستغرق عدة شهور، إن لم يكن سنوات.
- التعاونيات تظل نشاطًا تجاريًا ينافس غيره، ومن ثم قد تعد مُهدِّدًا لبعض الجهات في القطاع التجاري وخاصة التعاونيات الاستهلاكية، فسلاسل السوبرماكت الكبيرة ليس من مصلحتها نجاح التعاونيات، وبالتالي قد تعمل هذه الجهات على عدم نجاح التعاونيات أو عرقلة تأسيسها.
- غياب الإبداع والتفكير خارج الصندوق؛ فمعظم الجمعيات التعاونية إما استهلاكية أو زراعية، في حين أن هناك نشاطات أخرى تستحق الاتجاه نحوها، ومن ذلك الاتصالات والنقل، والكهرباء، والسكن، وشركات الطيران.
وفيما يتعلق بأسباب تأخر التصريح للجمعيات التعاونية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهذا يُعزى إلى أن التصريح لأي جمعية سيترتب عليه تبعات مالية لا بد أن تقدمها الوزارة للجمعية الناشئة وتشمل:
- إعانة تأسيسية لا تزيد عن 20٪ من رأس مال الجمعية، 50٪ من قيمة تأسيس وبناء مقر للجمعية.
- إعانة مشاريع، إذا قامت الجمعية بتنفيذ مشروع إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد عن 50٪ من تكلفة المشروع.
- إعانة خسارة لا تزيد عن 90٪ من الخسارة إذا تعرضت الجمعية لمخاطر.
- إعانة إدارة إذا عيَّنت الجمعية مديرًًا سعوديًا متفرغًا لا تتجاوز 50٪ من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير.
- إعانة مجلس إدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس بحيث لا تقل عن 12 اجتماعًا في السنة بما لا يتجاوز 20٪ من الأرباح السنوية.
- إعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بما لا يتجاوز 50٪ من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على تلك الآليات.
- إعانة تدريب لا تتجاوز 90٪ من التكاليف على أن لا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.
- إعانة محاسبة للجمعية وفيها تفاصيل، إعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد عن 50٪ من التكلفة.
- إعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز 50٪ مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانيتها.
وللتخلص من المتاعب والعبء المالي لكل جمعية، فإن الوزارة قد تتلكأ في التصريح للتعاونيات حتى لا يترتب عليها التزامات مالية.
- آليات دعم الجمعيات التعاونية والإفادة منها.
يلاحظ أن الجمعيات التعاونية لم تأخذ حقها من الفهم في وعي المجتمع، وتحتاج كثيرًا من الترويج مع دعم تنظيمي ذكي يسهم في توفيرها كخدمة جاذبة لا كعبء طارد. والجهات الحكومية مطالبة بتسهيل فسح الجمعيات وتقليل متطلبات وإجراءات التقديم مع تسريع إصدار الموافقات. كذلك ينبغي توفير منصات تسهيلية لأعمال هذه الجمعيات تُمارِس من خلالها أعمالها وخدماتها بمهنية عالية، دون أن تلجأ للشراء، وكمثال توفير أنظمة إلكترونية إدارية وأنظمة مخازن ومحاسبة، لتكون تحت تصرف هذه الجمعيات دون مقابل.
وممّا لا شك فيه أن القطاع التعاوني في المملكة بحاجة إلى مراجعة وتحديث للنهوض به أسوة بما تحظى به القطاعات المماثلة في الدول المتقدّمة، ومع ذلك فإن القطاع التعاوني في المملكة قد قطع شوطًا لا بأس به في السنوات القليلة الماضية، وهناك عدد من المشاريع التعاونيّة الواعدة في المجال الزراعي والاستهلاكي والتسويق، كما أن هناك تفهّمًا ودعمًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة للجمعيات الزراعيّة، ممّا أدّى إلى إحراز بعض التقدّم في هذا المجال، وتعد جمعيات النحّالين من الجمعيات الناجحة في المملكة وعلى المستوى الإقليمي وربما العالمي. وقد تم تأسيس جمعيتين مركزيتين واحدة استهلاكيّة تضم جميع الاستهلاكيات في المملكة، وتم أيضًا تأسيس جمعيّة زراعيّة مركزيّة تضم جميع الجمعيات الزراعيّة في المملكة، والمأمول من هذه الجمعيّات المركزيّة أن تنظّم وتتولّى الاستيراد الجماعي والتسويق والكثير من الإجراءات التي ستُسهِّل عمل الجمعيّات الزراعيّة والجمعيّات الاستهلاكيّة في المملكة.
وفي نظر البعض فإن دعم مؤسسات المجتمع المدني يجب أن يشمل هذه الجمعيات، والتي يمكن أن تقام لسد حاجات خاصة، ليس من الضروري أن يكون منها خفض التكاليف. وتعميم هذا النوع من المؤسسات يسهم في دعم ثقافة التعاون في السعودية. وهذه الثقافة تسهم، بدورها، في دعم الانصهار الوطني، وتلك من فوائد التعاون في كافة المجالات، ومنها مجال سد الحاجات الحياتية المشروعة.
ويمكن التغلب على عدد من المعوقات التي تواجهها الجمعيات التعاونية، بإيجاد نماذج عُليا يمكنها أن تسهم في رفع الناتج المحلي وزيادة الصادرات وتسجيل براءات الاختراع خصوصًا فيما يتعلق بالزراعة ومنتجات الألبان. كما يمكن لهذه الجمعيات أن تقوم بدور اجتماعي من خلال تنظيم الرحلات وأنشطة التعليم والتدريب، ودعم المتفوقين. وربما يكون لمثل هذه الجمعيات دور رئيس لإسماع صوت صغار المنتجين، وتمكينهم من حماية أنفسهم ضد منافسة الشركات متعددة الجنسيات؛ إلا أنها ستصطدم بالخصخصة والتي قد تكون من أكبر العقبات التي تواجه مثل هذه المنظمات.
ومن أجل زيادة كفاءة قطاع الجمعيات التعاونية يجب العمل على:
- توفير بيانات كافية عن هذا القطاع، والحل الأمثل هو أن يكون هذا القطاع من ضمن القطاعات التي يتم تغطيتها من قبل الهيئة العامة للإحصاء (إن لم يكن موجودًا حتى الآن). والهدف من ذلك وضع نقطة أساس ومستهدف لهذا القطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبالطبع وجود دراسات من دول متقدمة توضح مدى أهمية ومساهمة هذا القطاع قد تكون داعمة للتبني.
- التأكد من التقيد بالأهداف الأساسية لوجود مثل هذا القطاع وعدم الانحراف عنها لتجنب العديد من القضايا.
- الحاجة إلى مزيد من التوعية بأهمية القطاع والتي قد تستغرق بعض الوقت وتحتاج إلى الدعم من القطاع الخاص.
ومن الخطوات المهمّة التي ما زالت قيد الانتظار في المملكة، هو قصر نشاط البقالات في الحارات على الجمعيات التعاونية، لما في ذلك من أهميّة أمنيّة وتنظيميّة، ولإنفاذ ذلك مطلوب التعاون من قبل الوزارات لا سيما: وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية.
أيضًا فإن نجاح الجمعيات التعاونية يجب أن يتم وفق معايير عمل منها:
- الحوكمة الفعالة لتطوير أدوات الإشراف وقياس الفاعلية للجمعيات.
- التدقيق والمراجعة الداخلية.
- تفعيل الأنظمة واللوائح القانونية.
- الميثاق الأخلاقي.
- ميثاق عمل مجلس الإدارة.
- تفويض الصلاحيات.
- إدارة المخاطر.
- تفعيل الأهداف والوصول للمستفيدين والتمكين والحماية والموثوقية.
يضاف إلى ما تقدم ما يلي:
- الحاجة إلى مزيد من الأنظمة أو تعديل الأنظمة الحالية ذات العلاقة التي تدعم حصول الجمعيات التعاونية على حصة أكبر من السوق منها:
- تعديل المادة (45) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليشمل الجمعيات التعاونية؛ ويهدف هذا التعديل المقترح إلى إضفاء الشمولية على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وسد الفجوة القانونية في المادة (45) من خلال إضافة “الجمعيات التعاونية” لنص المادة (45) جنبًا إلى جنب مع المؤسســـات والجمعيـــات الأهليـــة، بما يحقق تكافؤ الفرص ودعم قطاع الجمعيات التعاونية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
- توعية الجهات الحكومية وغيرها بالأفضلية الممنوحة للجمعيات في ترسية المشاريع.
- زيادة المُمكنات التي تدعم تنفيذ الجمعيات للأعمال المناطة بها، ومنها التسهيلات المالية (مثلًا تجربة بنك التنمية الاجتماعية).
- رفع مستوى الكوادر البشرية اللازمة لتسيير عمل الجمعيات.
- تطبيق التحول الرقمي للجمعيات التعاونية.
- تخصيص مقرات (أو أراضٍ) للجمعيات المهنية التعاونية في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية المزمع إنشاؤها.
و قد تكون أهم مجالات دعم القطاع التعاوني هي تمكين الموارد الممتازة في هذا القطاع من العمل المؤسسي بحرية وكفاءة وإعطاؤهم مساحة مناسبة لتوظيف الموارد والابتكار والفرص والاستجابة للتحديات بالسرعة والمرونة التي تتطلبها طبيعة القطاع التعاوني، ومن الواضح أن مجلس الجمعيات التعاونية يبذل جهودًا رائعة وخلاقة؛ لكنه غير ممَكّن بالدرجة اللازمة لتطوير القطاع، وربما يواجه تحديات هيكلية ونوعًا من الرعاية الأبوية الزائدة من قبل الجهات المشرفة، حرصًا على الحوكمة والانضباط بضوابط نظام الجمعيات التعاونية الذي لم يعد مواكبًا للتحديات والفرص التنموية في ظل التطور والتسارع الذي جاءت به رؤية 2030 .وأفضل التوجهات المطروحة من قبل المعنيين وأهمهم ربما مجلس الجمعيات التعاونية نفسه، هو رفع مستوى تراتبيته الإدارية وتحويله إلى هيئة عامة مستقلة منظمة وممكنة للقطاع.
كما أن الموازنة بين الأهداف التنموية للجمعيات التعاونية والربحية وتحقيق الاستدامة والجدوى للمؤسسين المشتركين والذين دفعوا أموالهم في البداية، سيجعل دورها أكثر فعالية على المدى المتوسط والبعيد وسيظهر أثرها على المدى البعيد.
- التوصيات
- دعم استقلاليّة القطاع التعاوني ووضعه تحت الإشراف التنظيمي لهيئة مستقلّة.
- نشر الوعي حول أهمية التعاونيات من خلال ما يمكن تحقيقه من مميزات وأهداف لأعضائها، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح الفرق بينها وبين الجمعيات الخيرية وإقامة مؤتمر إقليمي أو وطني حول العمل التعاوني.
- إزالة العوائق أمام التعاونيات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل سهولة الحصول على التراخيص.
- إيجاد الحوافز المالية وغير المالية، مع توفير برامج تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع التعاونيات.
- تعديل الأنظمة الحالية ذات العلاقة التي تدعم حصول الجمعيات التعاونية على حصة أكبر من السوق منها وتعديل المادة (45) في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليشمل التعاونيات، ويهدف هذا التعديل المقترح إلى إضفاء الشمولية على نظام المنافسات والمشتريات.
- النظر في صلاحيات مجلس التعاونيّات ليمارس دوره مثل المنظمات المشابهة في الدول المتقدمة وتحديد مجالات عملها وأهدافها والخدمات التي تقدمها مع رفع مستوى الكوادر البشرية اللازمة لتيسير عملها.
- إعطاء الصلاحيات الكاملة للتعاونيات من خلال رسم مجالات عملها وأهدافها، والخدمات التي تقدمها ورفع مستوى الكوادر البشرية اللازمة لتيسير عمل الجمعيات.
- تمييز القطاع التعاوني في الرسوم والضرائب لتحفيز القطاع، بما في ذلك الإعفاء من المقابل المالي للعمالة أسوة بالقطاع الصناعي.
- اعتماد الوزارات على التعاونيّات كذراع تنموي اقتصادي لتحقيق مستهدفات الوزارة.
- اعتماد التعاونيات كإحدى وسائل القضاء على التستّر، فيما يخص البقالات الصغيرة والمتوسطة وقصر تراخيص عمل البقالات في الحارات على التعاونيّات.
- اعتماد لائحة الإقراض التعاوني من قبل بنك التنمية الاجتماعيّة بضمانات ميسّرة (ضمان المشروع) ورفع سقف الإقراض من بنك التنمية في جميع المجالات التعاونيّة عدا المجالات التي يقرض فيها بنك التنمية الزراعي.
- تسريع تنفيذ منح الأراضي المقرّة للجمعيات حسب النظام من قبل البلديات، وإعطاؤها أولويات في تحديد المكان المناسب حسب نوع الجمعيّة وخدماتها.
- دعم الجمعيّة المركزيّة الاستهلاكيّة والمركزيّة الزراعيّة اللتين تماثلان الاتحادات الاستهلاكيّة والاتحادات الزراعيّة دوليًّا. وتسهيل إقراضهما قروضًا تشغيليّة بدون ضمانات.
- اعتماد تعريفة كهرباء مخفّضة للتعاونيات أسوة بالقطاع الصناعي الذي تبلغ تعرفته 16 هللة للكيلو واط ساعة، بينما تبلغ التعريفة للتعاونيات 30 هللة للكيلو واط ساعة.
- احتساب ما تقدمه التعاونيّات للمسؤوليّة الاجتماعيّة كجزء من مبلغ الزكاة الذي يتم تحصيلها من قبل هيئة الزكاة والدخل.
- وضع خطة عمل لتسهيل الإجراءات الخاصّة بتأسيس التعاونيّات، وتخصيص أراضٍ في المخططات الجديدة للتعاونيات.
- المصادر والمراجع
- محمد بن سليمان السكران: الجمعيات التعاونية ودورها في التنمية الزراعية، سلسلة الإصدارات العلمية للجمعية السعودية للعلوم الزراعية، الإصدار السادس، السنة الرابعة، 1425هـ.
- نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 10/3/1429هـ، متاح على الرابط الالكتروني: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14290310%20%D9%86%D9%90%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
- https://www.cscs.org.sa
- https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2012/jan/04/social-enterprise-blog-co-operatives-and-mutuals )
- خالد الرديعان وهند الخليفة: التعاونيات في دول مجلس التعاون: مجالاتها ومشكلاتها وأدوارها المستقبلية، سلسلة الدراسات الاجتماعية، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنامة، البحرين، العدد (76)، مارس 2013م.
- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية: مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437هـ، متاح على الرابط الإلكتروني:
- https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1
- المبادئ والأهداف التعاونية، متاح على الرابط الإلكتروني: https://mcs.org.sa/files/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
- المشاركون.
- كاتب الورقة الرئيسية: أ. ماهر الشويعر
- المعقبون:
- د. احسان بوحليقة
- أ. الحجاج بن مصلح
- مدير الحوار: د. مها العيدان
- المشاركون بالحوار والمناقشة:
- م. عبدالله الرخيص
- د. أحمد المحيميد
- د. محمد الملحم
- أ. سالم المري
- د. عائشة الاحمدي
- د. خالد المنصور
- د. عبدالاله الصالح
- د. حسين ابوساق
- د. خالد الرديعان
- اللواء فاضل القرني
- أ. فهد الاحمري
- د. محمد الثقفي
- أ. عبدالرحمن باسلم
- د. زياد الحقيل
- د. حامد الشراري
- م. إبراهيم الصحن
- د. مساعد المحيا
- د. عاصم العيسى
- د. فائزة الحربي
- د. حميد الشايجي
- د صدقة فاضل
القضية الثالثة
الاحتيال المالي الإلكتروني في بيئة الأعمال السعودية الواقع والأموال والفجوة
(15/6/2022م)
- الملخص التنفيذي.
تناولت هذه القضية الاحتيال المالي الإلكتروني في بيئة الأعمال السعودية، وأشار د. محمد الزهراني في الورقة الرئيسة إلى أن بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية تعرضت في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية إلى مجموعة من العمليات الاحتيالية المنظمة من خلال أفراد وعصابات احتيالية تعمل بطريقة احترافية وممنهجة من داخل وخارج السعودية.
ويعرف الاحتيال على أنه جميع الأعمال الخداعية والمتعمدة التي يقوم بها الفرد بصدد الربح غير القانوني، وهناك عدة أنواع للاحتيال، أهمها الاحتيال الإلكتروني والذي أصبح من أشهر الأنواع مع تطور التكنولوجيا، وذلك من خلال تقديم خدمات مزيفة عبر شبكات الإنترنت وكذا تزوير الهوية الإلكترونية. ومن أهم أهداف هذا الأخير سرقة الأموال سواءً باختراق حسابات الضحايا وسرقة أرقام بطاقاتهم أو البيع المزيف للمنتجات، إلى آخره من الطرق الخداعية.
بينما أكَّد المستشار عاصم بن عبد الوهاب العيسى في التعقيب الأول على أن المملكة تشهد تطورًا ملحوظًا سريعًا في أتمتة تقنياتها في شتى المجالات، ومن ذلك استخدامات التقنية في شتى أنواع التعاملات البنكية والتمويلية والمالية، ومن ذلك الترخيص لشركات وساطة التمويل الرقمية، وأتمتة ورقمنة شتى العمليات. وقد واكبَ ذلك تحديات وخصومات واستغلالات، عصابات تَمَرَّسَتْ وامتهنت استهداف اقتصادنا وثرواتنا، عبر أساليب احتيال مالي مُتعدد الأنماط، استهدف الجميع صغيرًا وكبيرًا، تاجرًا ومواطنًا، وقد شاع أن الكثير قد تعرض لاحتيال مالي، بقصص مُحزنة عديدة، وليس سرًا القول أن البعض قد صُفِّرَ حسابه البنكي، عبر تحويل جميع رصيده، وبعضه بالملايين، خلال دقائق!
في حين ذكر د. محمد بن حميد الثقفي في التعقيب الثاني أن دراسة جرائم الاحتيال الإلكتروني تحظى بأهمية قصوى؛ بسبب انتشار التعاملات من خلال الإنترنت، وتزايد التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية والبنوك، وأن نسبة كبيرة من الأفراد والشركات أصبحت تعتمد في حصولها على كثير من السلع والخدمات عن طريق التعاملات الإلكترونية.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- واقع جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني ومخاطرها.
- أسباب تزايد جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني المعاصرة.
- وسائل الحد من جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:
- إنشاء لجنة دائمة من (البنك المركزي – الأمن السيبراني -هيئة الاتصالات – الأمن العام) تتابع آخر المستجدات وتسد الثغرات مع الجهات المعنية، لتكون جهة رقابية في حركة وسلامة وأمن العمليات المصرفية، ومنها الاحتيال المالي ترتبط بالبنوك وبالجهات الدولية المسؤولة لتبادل الخدمات والمعلومات ACFE على غرار إنتربول متخصص للاحتيال المالي.
– الجهة ذات العلاقة (البنك المركزي).
- توفير خط ساخن لتلقي بلاغات المتضررين من جرائم الاحتيال المالي وربطها مع البنك المركزي والبنوك، يملك صلاحية إيقاف العمليات المصرفية لحسابات العملاء الذين يشتبهون بوجود احتيال مالي أو تحويلات مشبوهة، وتوفير الحماية القانونية والدعم والتوجيه الفني والمشورة للعملاء الذين يتصلون بالخط الساخن؛ للإبلاغ عن وجود شبهة احتيال مالي لإيقاف حساباتهم بصفة عاجلة.
– الجهة ذات العلاقة (البنك المركزي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
- سرعة الحكم في قضايا الاحتيال المالي من جهات مختصة، مع مراعاة أنها جرائم عابرة الحدود.
– الجهة ذات العلاقة (وزارة العدل).
- تطوير برنامج توعية نوعي للتقليل (ليشمل المقروء، المرئي، المسموع، صناع المحتوى…إلخ) من جرائم الاحتيال المالي يتم تمويله عن طريق لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، ويتم تطويره بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وفق نظام حماية المستهلك من الغش والخداع والإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة المؤدية إلى الاحتيال المالي، ورفع مستوى الرقابة على ممارسات الاحتيال المالي وتجريمها، ورفع مستوى وعي المستهلك، بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والمنظومات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
– الجهة ذات العلاقة (وزارة الإعلام).
- التأكيد على المنظومة البنكية والبنك المركزي إعداد الدراسات العلمية لظاهرة الاحتيال المالي وسن التشريعات والإجراءات الحمائية والتعويضية لذلك.
– الجهة ذات العلاقة (البنك المركزي).
- الورقة الرئيسة: د. محمد الزهراني
” يتركز الموضوع حول حالات الاحتيال المالي والاختراقات للحسابات البنكية التي حصلت في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة”.

مقدمة \ أهمية طرح القضية:
في الآونة الأخيرة أصبحت تُمارَس أبشع طرق الاحتيال المالي والتلاعب بالناس بهدف الربح وكسب الأموال بطرق غير مشروعة، ومثل هذه الممارسات باتت تهدد المجتمعات في جميع بيئات الأعمال في أغلب دول العام المتقدمة والنامية.
وقد تعرضت بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية إلى مجموعة من العمليات الاحتيالية المنظمة من خلال أفراد وعصابات احتيالية تعمل بطريقة احترافية وممنهجة من داخل وخارج السعودية على ضوئها، أصدر البنك المركزي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، عددًا من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقًا من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
البيانات في Table هي من التقرير الأممي لجمعية فاحصي الاحتيال الدول ACFE Report to the Nations 2020

إن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
لذا فطرح قضية كهذه أصبح أمرًا لا بد منه من أصحاب الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني، للبحث عن أفضل الوسائل والطرق للتوعية وتحذير الناس من الاحتيال المالي، وأيضًا إيجاد الحلول والبحث عن الثغرات.
لذا فقد تم تخصيص هذا الورقة \ البحث بغرض طرح قضية الاحتيال الإلكتروني المالي في بيئة الأعمال -المملكة العربية السعودية ولذلك سوف نحاول الإجابة على الأسئلة التالية:
- ما مفهوم الاحتيال وما أهمية طرح مثل هذه القضية؟
- ما الأساليب المستعملة والشائعة في ارتكاب الاحتيال الإلكتروني؟
- ما الإجراءات القانونية والتقنية لهذه الجريمة؟
- كيف يمكننا الحد من مثل هذه الجرائم المالية في بيئة الأعمال في السعودية؟
- ما التوصيات التي يجب العمل بها حتى لا يقع الفرد ضحية لهذه الجريمة؟
ما مفهوم الاحتيال وما أهمية طرح مثل هذه القضية :
يعرف الاحتيال على أنه جميع الأعمال الخداعية والمتعمدة التي يقوم بها الفرد بصدد الربح غير القانوني، وهناك عدة أنواع للاحتيال، أهمها الاحتيال الإلكتروني والذي أصبح من أشهر الأنواع مع تطور التكنولوجيا، وذلك من خلال تقديم خدمات مزيفة عبر شبكات الإنترنت، وكذا تزوير الهوية الإلكترونية. ومن أهم أهداف هذا الأخير سرقة الأموال سواءً باختراق حسابات الضحايا، وسرقة أرقام بطاقاتهم، أو البيع المزيف للمنتجات، إلى آخره من الطرق الخداعية. وحاليًا يشهد جل العالم الكثير من عمليات الاحتيال الإلكتروني وخاصة بيئة الأعمال في السعودية، والتي شهدت العديد من حالات الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة، وترتكز أغلب عمليات الاحتيال المالي في الخدمات المالية المقدمة من القطاع المصرفي.
لذا فقد بات واجبًا اجتماعيًا ومهنيًا الحديث عن هذا الموضوع الهام، وطرح مثل هذه القضية للتوعية وللتحذير، وكذا تعريفها للناس التي لم يسبق لها السماع بمثل هذه الجرائم.
المحتالون وجدوا من الإنترنت فرصة عظيمة للتضليل والخداع على الأبرياء بشتى الطرق، فقد وجدوا من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الأخرى فرصًا للنصب بغرض الربح، ففي الآونة الأخيرة سجلت السعودية ارتفاعًا غير مسبوق لعملية الاحتيال المالي، أهمها اختراق حسابات العملاء وخاصة في القطاع المصرفي والبنكي. والجدير بالذكر أنه في معظم الأحيان “يد واحدة لا تصفق” لذا فهذه العمليات لا يكون وراءها مجرم واحد بل مجرمون ( جريمة ماليه منظمة من قبل أفراد ) يديرون حسابات بنكية في عدة بنوك في السعودية وخارجها ومؤسسات تجارية وهمية، فكما ذكرنا فقد قامت هذه العصابات باختراق حسابات العملاء والاستيلاء على أموالهم، وقد تعددت الطرق في هذا الفعل الإجرامي كإيهام الضحية بأن لديهم فروعًا وإجبارهم بالكلام الجاذب على إعطاء أرقام حساباتهم أو تحويل بعض المبالغ، وبهذا فقد تمت السرقة والاستيلاء على الكثير من أموال المواطنين الأبرياء.
ونظرًا لأهمية هذه القضية والتي تخص القطاع المالي والمصرفي، وتوثر على سمعة وثقة القطاع بالكامل، فإن عقوباتها أصبحت صارمة، ومنها ضبط الأشخاص المعنيين وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية ليتم اكتشاف أكثر من جريمة مالية، ومنها قضايا غسل أموال وليس قضية احتيال فقط.
من جهة أخرى فقط سبق وأن حذر البنك المركزي من العمليات الاحتيالية المالية عبر الإنترنت؛ حيث إن بعض الضحايا نجدهم يثقون في متاجر إلكترونية مجهولة وغير موثقة وبأسماء غير معروفة ومجهولة، فمثل هذه القضايا أصبح من الواجب النظر إليها، ولربما البحث فيها أكثر لمعرفة وفهم سلوك المحتالين في بيئة الأعمال في السعودية، لكي نستطيع مواكبة تطورها وسد الثغرات القانونية والإلكترونية.
كما لوحظ أن هناك بعض العمليات الاحتيالية لا يتم التبليغ عنها وخصوصًا عندما تكون الضحية المستهدفة من كبار السن، وبذلك تكثر العمليات الاحتيالية، ويجد المحتالون فرصة أكبر، لأنه تم تجاهلها وعدم التبليغ عنها، مما يشجع المجرمون على ممارسة عمليات احتيالية أكثر وأكبر، وكما لوحظ أن هذه العمليات الإجرامية تتم بالتواطؤ في بعض الأحيان مع مواطنين سعوديين ويبقى للمجرمين سبلًا وطرقًا جديدةً، وقد يكون من الصعب في البداية معرفتها؛ ولكن ليس من المستحيل محاربتها واكتشافها.
مفهوم وتعريف الخدمات المالية:
تفتقر الخدمات المالية إلى تعريف واضح ودقيق وشامل، حيث إن معظم أدبيات تسويق الخدمات المالية تتغاضى عن تقديم تعريف محدد لها، وذلك لعدة أسباب، إن القوانين التي تخضع لها الخدمات المالية معمول بها في كل دولة على حدة (بيئة الأعمال في السعودية تعتبر بيئة unique متفردة وذلك لعدة أسباب أيضًا، تعدد وتنوع المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات المالية، وأيضًا المؤسسات البنكية التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية وغير الإسلامية).
ولذلك فقد تم تعريف الخدمات المالية على أنها “أي نشاط ومنفعة أو أداء له طبيعة مالية، يُقدِّمه طرف إلى طرف آخر، ويخضع إلى قوانين أو محكوم بتشريعات أو أنظمة أو تعليمات أو سياسات صادرة من قبل جهة، أو من قبل مؤسسة عامة تمارِس سلطة تنظيمية أو رقابية مُنِحت لها بموجب القوانين المعمول بها في دولة معينة”.
ويمكن تعريفها أيضًا بأنها عبارة عن خدمات اقتصادية تؤديها المؤسسات المالية التي تشمل طائفة واسعة من المؤسسات التي تدير الأموال بما فيها الاتحادات الائتمانية والبنوك وشركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات المضاربة المالية وشركات إدارة الاستثمارات وبعض الشركات التي تمولها الحكومات.
تعريف الجريمة المعلوماتية
الجريمة الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف أو يستخدم جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة، وتُرتكَب معظم الجرائم الإلكترونية من قبل مجرمي الإنترنت أو المتسللين الذين يريدون جني الأموال، ويتم تنفيذ الجرائم الإلكترونية من قبل الأفراد أو المنظمات.
بعض مجرمي الإنترنت منظمون ويستخدمون تقنيات متقدمة ولديهم مهارات فنية عالية، والبعض الآخر قراصنة مبتدؤون، ونادرًا ما تهدف الجرائم الإلكترونية إلى إتلاف أجهزة الكمبيوتر لأسباب أخرى غير الربح، ويمكن أن تكون هذه سياسية أو شخصية.
حجم وأساليب ارتكاب هذه الجرائم، وإجراءات التعامل القانوني والتقني معها.
مع تطور الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، تتطور أساليب الاحتيال المالي وتتجدد بين فترة وأخرى، متخذةً أشكالًا وصورًا متعددة؛ إلا أن هدفها واحد وهو الاحتيال على الأفراد والكيانات الاقتصادية للحصول على بياناتهم المالية والشخصية وسرقة أموالهم ومدخراتهم؛ ولكن مهما تعددت أساليب الاحتيال، من الضروري معرفة أن تجنب عمليات الاحتيال المالي تبدأ بعدم الاستجابة إلى أي طرف مجهول يطلب منك الإفصاح عن بياناتك المالية والشخصية مهما بدا واثقًا؛ فالثقة سلاح المحتال لطمأنتك وإقناعك بمصداقيته، فنلاحظ أن المجرمين يأخذون الأموال من الضحايا بطريقة خداعية سهلة تجعل الضحية يدفع بمحض إرادته، ومن ثم يصدم بأن ماله قد أُخِذ منه بطريقة خداعية، ويكون هناك صعوبة ولا يستطيع استرجاعه في غالب الأحيان.
واقع الاحتيال الإلكتروني في بيئة الأعمال السعودية:
- %20 من السعوديين تعرضوا لقضايا نصب واحتيال عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
- 3 مليارات دولار خسائر انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة.
- 203 أشخاص تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني في العالم.
- الحالات الموثقة لا تمثل سوى%20 من الحالات أكثر العمليات شيوعًا.
- 71%سرقة الهوية.
- 66 %التصيد الاحتيالي.
- 63 %سرقة الحساب.
- خسائر تجار التجزئة على مستوى العالم من الاحتيال الإلكتروني:
- سنة 2011 حوالي 9.84 مليارات دولار.
- منذ سنة 2017، أصبح%45 زيادة في عمليات الاحتيال.
- سنة 2020 حوالي 32.4 مليار دولار.
- ويوجد %14 زيادة متوقعة حتى 2023.
- المتوقع في 2027 حوالي 40.6 مليار دولار

كشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول عن حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت، وأن هناك خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا استُخدم فيها 24 أسلوبًا إجراميًّا للوصول للضحايا.
وأوضحت الدراسة المعنونة بـ (دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية) والصادرة مطلع يناير 2022م؛ وجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني، حيث تبين من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم، تصدرتها 5 طرق احتيالية في مجالات الاستثمارات، والبريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الجنسي.
وبينت الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الأدوات والأساليب والتكتيكات الإجرامية للمحتالين عبر الإنترنت وآلية وصولهم إلى الضحايا عن أسلوب إجرامي مُركَّب صُمِّم لاستهداف الضحية مرتين وبطريقتين مختلفتين تتطلب في المرة الأولى وقوع الضحية عن طريق الإعلانات الاحتيالية الاستثمارية، تمهيدًا للإيقاع به في الطريقة الإجرامية الثانية عبر إعلانات شركات استشارات قانونيَّة تدعي استرداد الأموال.
وأكدت نتائج تحليل الإعلانات الاحتيالية أن المحتالين ينشرون إعلاناتهم في المواقع المشهورة والموثوقة عبر وكلاء الإعلانات، وكذلك استغلالهم لنماذج الإعلانات الإلكترونية لوكلاء الإعلانات عبر الإنترنت، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الإعلانات للوصول إلى الضحايا المحتملين.
وظهر خلال الدراسة أن أعلى خمسة نطاقات محتالة نُشِرت في حدود 40 ألف رابط إعلاني عبر الإنترنت باستغلال آلية تسجيل نطاقات الإنترنت، حيث سجل 93% من النطاقات الاحتياليَّة في نطاقات المستوى الأعلى العامَّة، و7% من النطاقات الاحتياليَّة في نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول.

أما واقع الاحتيال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب تقرير منظمة الاحتيال الدولية الأممي والذي يصدر كل عام ACFE Report to the Nations 2020وهي أكبر منظمة عالمية تكافح الاحتيال، تصدر تقريرًا سنويًا عن واقع الاحتيال عالميًا من خلال قضايا الفساد المالي التي يتم جمعها مع المتعاونين والمحققين حول العالم، وحسب بيانات التقرير فإن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية حسب عدد حالات الاحتيال.
أبرز طرق الاحتيال المالي:
- قيام جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات رسمية مثل البنوك أو مؤسسات حكومية كالبنك المركزي السعودي بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني، تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية بحجة تحديث بياناتك أو فوزك بجائزة أو وجود مشكلة بحسابك المصرفي يستلزم حلها.
- استغلال الحاجات النفسية لدى الأفراد مثل رغبتهم بالثراء السريع أو الفوز بجوائز مالية أو عينية.
- التعامل مع جهات غير مرخصة وأفراد يعملون بطريقة غير نظامية يعرضون خدمات تتعلق بمنح القروض بشروط وأسعار أفضل، أو سداد القروض والمتعثرات المالية بلا شروط منطقية، إذ قد يقومون بالتسديد عنك مقابل توقيعك على مستندات تلزمك بدفع مبالغ أكبر.
- تعرُض بيانات حساباتك البنكية وبطاقاتك الائتمانية إلى التسريب بسبب عدم وجود برامج حماية في حاسبك الآلي أو الجوال عند استخدام القنوات الإلكترونية للمصارف أو استخدام مواقع تسوق إلكترونية غير موثوقة عند الشراء.
أمثلة من البيئة السعودية:
وهنا نذكر مثالًا عن إحدى الضحايا الذي قال إنه تعرض للاحتيال المالي من خلال شركة تدعي أنها تقدم خدمات استقدام العمالة المنزلية، وقد أرسل له المحتال شاشة مماثلة لشاشة البنك الخاصة به، وذلك للدخول على حسابه البنكي في نفس الوقت المحتال يكون معه على الخط؛ لكي يساعده في إنهاء الإجراءات لتقديم الطلب ودفع الرسوم الأولية. بعد ذلك يتم تحويل حوالات متتالية مبلغ 19999 ريالًا لعدة مرات متتالية حتى سحب كامل المبلغ من الحساب.
ومن أهم الأساليب التي لفتت الأنظار في السعودية هو ما تم تسميته بـ “التسول الإلكتروني” وهو نظام جديد اتبعه المحتالون لغاية التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فقد حددت المملكة عقوبة السجن بهذه الجريمة أيضًا. وهو محاولة الحصول على الضحية من تصميم مواقع وإرسال رسائل نصية توحي أنها منصة للتبرع مثل منصة إحسان وغيرها.
من جهة أخرى، فقد أفاد أحد الأشخاص أنه تم الاستيلاء على أمواله من خلال شركة توظيف وهمية، تدعي أنهم يقومون بتوظيف الصيادلة، وبهذا يطلبون من الأشخاص إرسال مبالغ من أجل عمل تدريب على أن يتم تعويضهم فور ما يبدؤون العمل؛ إلا أن هذا لا يحصل أبدًا عند أخذ الأموال، فلا يمكن الولوج إلى موقعهم ثانية ولا حتى التواصل معهم، وهذا النوع من الاحتيال نراه موجودًا بكثرة في الآونة الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك فإن إرسال روابط مزيفة لاستقدام العمالة المنزلية أو استخراج رخصة قيادة وخصوصًا للنساء أصبح أيضًا مشهورًا مؤخرًا، ويكمن هذا في أن إرسال مثل هذه الروابط يساعد المجرمين على اختراق حسابات ضحاياهم، وهذا من خلال نقر الضحية والولوج إلى الرابط المرسل إليه ليرى أنه تم اختراق حسابه، وما أن يتم اختراق حسابه تتم سرقة معلومات بطاقته الانتمائية أو حسابة البنكي وتعريف المستفيد (المحتال)، ومن ثم سرقة أمواله بسهولة تامة.
وأحد الأساليب الاحتيالية هو شراء المنتجات من غير تسليمها؛ أي أن المحتالين يبيعون سلعًا مزيفةً بأسعار قد تكون رخيصة في بعض الأحيان، ولا تكون البضاعة موجودة أصلًا، فلا يتم تسليم البضاعة بتاتًا، بل تتم سرقة الأموال فقط. ومن هذا فإننا نلاحظ أن هناك أساليب لا تعد ولا تحصى للنصب والاحتيال وعلى رأسها الروابط الإلكترونية المزيفة والمزورة والضغط على الضحايا للولوج إليها ومن ثم اختراق حساباتهم والولوج إلى بياناتهم، بالإضافة إلى إرسال الروابط التي تزعم بربح جوائز قيمة ومادية كبيرة، ليتم إرسال الأموال من الضحايا بطريقة خداعية، فتختلف الأساليب وتبقى الجريمة والهدف واحدًا ألا وهو الأموال والربح غير القانوني، إذاً فإن حجم هذه الجريمة يبقى كبيرًا مهما اختلفت سبل ارتكابه ويجب على القانون تطبيق أقصى عقوبة بشأنه.
أنواع الجرائم الإلكترونية
هناك عشرات الطرق التي يمكن من خلالها تفسير الجريمة الإلكترونية، وتحتاج إلى معرفة ماهيتها من أجل حماية نفسك، تحتاج إلى معرفة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتهاك خصوصيتك. في هذا الجزء، نناقش أنواع الجرائم الإلكترونية الشائعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت سوف نتطرق لنوعين فقط:
التلاعب بالبيانات
هو تغيير غير مصرح به للبيانات قبل أو أثناء الدخول إلى نظام الكمبيوتر، ثم تغييرها مرة أخرى بعد انتهاء المعالجة، باستخدام هذه التقنية، فقد يقوم المهاجم بتعديل الإخراج المتوقع ويصعب تتبعه، بمعنى آخر يتم تغيير المعلومات الأصلية التي سيتم إدخالها، إما عن طريق شخص يكتب البيانات، أو فيروس مُبرمَج لتغيير البيانات، أو مُبرمِج قاعدة البيانات أو التطبيق، أو أي شخص آخر يشارك في عملية الإنشاء والتسجيل أو ترميز البيانات أو فحصها أو فحصها أو تحويلها أو نقلها.
هذه واحدة من أبسط الطرق لارتكاب جريمة متعلقة بالكمبيوتر، لأنه حتى هواة الكمبيوتر يمكنهم فعل ذلك، على الرغم من أن هذه مهمة سهلة، يمكن أن يكون لها آثار ضارة.
سرقة الهوية والاحتيال على بطاقات الائتمان
تحدث سرقة الهوية عندما يسرق شخص ما هويتك ويتظاهر بأنه أنت للوصول إلى موارد مثل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية والمزايا الأخرى باسمك، وذكر استفتاء أجرته شركة الدفع الإلكتروني Worldpay.com وشارك فيه 274 تاجرًا من مختلف الصناعات من 6 دول أن سرقة الهوية تعتبر من أكثر أنواع الاحتيال عبر الإنترنت شيوعًا.
قد يستخدم المحتال أيضًا هويتك لارتكاب جرائم أخرى، «الاحتيال على بطاقة الائتمان» مصطلح واسع النطاق للجرائم التي تنطوي على سرقة الهوية، حيث يستخدم المجرم بطاقة الائتمان الخاصة بك لتمويل معاملاته، فالاحتيال على بطاقة الائتمان هو سرقة الهوية في أبسط أشكالها.

كيف يتم انتحال صفة البنك المركزي للقيام بعمليات احتيالية:
- التواصل بالهاتف أو بالرسالة النصية أو عبر التواصل الاجتماعي وادعاء المحتال أنه يعمل لدى البنك.
- استخدام برمجيات لإخفاء الأرقام الحقيقية للمتصل منها وإظهار رقم البنك أو المؤسسة المالية.
- إنشاء مواقع إلكترونية مزورة تحمل اسم وشعار البنك / المؤسسة المالية.
- ادعاء وجود مبالغ مالية أو ودائع مستحقة للعميل لدى البنك.
الغرض هو التغرير بالضحية والوصول إلى إقناعه، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والحسابات البنكية والبطاقات المصرفية للوصول إلى أموال الضحية ومن ثم سرقتها والاستيلاء عليها.
وهنا يجب التنبيه أنه لا البنك المركزي أو البنوك والمؤسسات المصرفية في بيئة الأعمال في السعودية تطلب من الأفراد الإفصاح عن بيانات حسابتهم الشخصية أبدًًا.
كيف يمكن الحد من هذه الجرائم المالية وطرق الحماية:
- يقال إن المحتالين يسبقون الأنظمة والقوانين بـ 20 خطوة، وأنا أقول إنه ربما أكثر في ظل هذا العدد الكبير من العمليات الاحتيال المالي التي وقعت مؤخرًا في بيئة الأعمال السعودية، بلا شك هناك العديد من الإجراءات التي سوف تحد من وقوع الاحتيال؛ لكن لن توقفه. والسبب أن المحتالين يبحثون دئمًا عن الثغرات في الأنظمة والقوانين واصطياد الفرص لممارسة أعمالهم الإجرامية والاحتيالية.
- التوعية سوف يكون لها الأثر الكبير في ردع الكثير من العمليات الاحتيالية في المجتمع، كثير من العمليات الاحتيالية التي وقعت بسبب الجهل من الناس في كثير من الأحيان.
- تأهيل كوادر سعودية في مجال ردع الاحتيال المالي، وتدريبهم في هذا المجال.
- هناك مسؤولية مشتركة بين العميل والبنك عن الحفاظ على سرية المعلومات وحماية أموال المستفيدين.
طرق الحماية وردع من عمليات الاحتيال المالي:
- عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية.
- عدم التعامل مع جهات غير مرخصة، ويجب البحث و[التعرف على قائمة شركات التمويل المرخصة في المملكة].
- حماية جهاز الحاسب الآلي وجوالك من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فعالة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أمانًا.
- فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتك المصرفية، وكذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية لمراجعة العمليات المالية المنفذة.
- إبلاغ البنك فورًا عن أي عملية احتيال تتعرض لها لأخذ الإجراءات اللازمة وتوعية عملاء البنك الآخرين.
- تغيير اسم المستخدم والرقم السري الذي تستخدمه للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بصورة دورية.
من المهم معرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المالية الخاصة أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أية ظرف، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط. ولحمايتك خصصت شركات الاتصالات في المملكة خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية SMS التي تطلب تحديث البيانات البنكية أو تعدك بالفوز بمكافآت وجوائز مالية، وذلك بإعادة إرسالها متضمنة رقم جوال المرسل إلى الرمز الموحد (330330). وفي حال -لا قدر الله- وقعت ضحية لأحد صور الاحتيال المالي: أبلغ البنك الخاص بك وتوجه إلى أقرب مركز شرطة لتبلغ عن واقعة الاحتيال أو قم برفع بلاغ عن طريق تطبيق (كلنا أمن).
المراجع:
- الزهراني، بدر بن أحمد بن محمد. جريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي. 2014.
- حبيباتني, and بثينة. الإجرام الإلكتروني. Diss. Université d’Alger 1-Benyoucef Benkhedda.
- قراوي, and كلتوم. جريمــــــــــــة الاحتيال الإلكتروني. Université d’Alger 1-Benyoucef Benkhedda.
- الدويكات, et al. “صور الاحتيال والتزوير في البطاقات الائتمانية.” (2013).
- دابل، سليمان علي أحمد, and عادل عبد الله خميس المعمري. مشرف. ضوابط الدليل الجنائي في جرائم المعلومات. Diss. جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا, 2013.
- نجاح محمد فوزي. “وعي المواطن العربي تجاه جرائم الاحتيال: بطاقات الدفع الإلكتروني نموذجا.” (2007).
- القبيسي، and فهد بن عبدالعزيز. التنفيذ الإلكتروني في الأحكام القضائية (دراسة تأصيلية مقارنة). 2017.
- فيصل امين, ياسر. “المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني: دراسة تحليلية.” L’Egypte Contemporaine530 (2018): 375-451.
- فيصل امين, ياسر. “المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني: دراسة تحليلية.” L’Egypte Contemporaine530 (2018): 375-451.
- صحراء, and الزهرة. “الالتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني.” (2020).
- محمود محمد زيدان محمد. “المشكلات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية.” (2012).
- الرشيدي, et al. المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على البريد والموقع الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي. Diss. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 2020.
- KADARI, I. (2014). مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون الدولي (Doctoral dissertation).
- Huey, Nathan A. “E-Mail and Iowa’s Statute of Frauds: Do E-Sign and UETA Really Matter.” Iowa L. Rev.88 (2002): 681.
- Cortelyou, George B. “Frauds in the Mail. Fraud Orders and Their Purposes.” The North American Review613 (1907): 808-817.
- Compton, W. P. “The Law of Negotiable Instruments in Mail Frauds.” Virginia Law Review(1945): 671-678.
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: المستشار عاصم بن عبد الوهاب العيسى
تشهد المملكة تطوراً ملحوظًا سريعًا في أتمتة تقنياتها في شتى المجالات، ومن ذلك استخدامات التقنية في شتى أنواع التعاملات البنكية والتمويلية والمالية، ومن ذلك الترخيص لشركات وساطة التمويل الرقمية، وأتمتة ورقمنة شتى العمليات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التوسع في فتح الحسابات رقميًا دون الحاجة لمراجعة الفروع، مُستفيدين من البنية التحتية الرقمية العظيمة المتواجدة في مملكتنا الغالية، ومن الربط مع نظام “أبشر” وتفعيل التوقيعات الرقمية وبصمة العميل، ومن ذلك: رقمنة إجراءات الحصول على التمويل، من بداية الطلب إلى حين حصول طالب التمويل على تمويله ونزول المبالغ في حساباته، دون الحاجة لمراجعة الفرع!، وغيرها الكثير مما تتسارع بشأنه الشركات بداعي مواكبة العصر والتميز.
مخاطر التقنية وعمليات الاحتيال:
واكبَ ما سبق تحديات وخصومات واستغلالات، عصابات تَمَرَّسَتْ وامتهنت استهداف اقتصادنا وثرواتنا، عبر أساليب احتيال مالي مُتعدد الأنماط، استهدف الجميع صغيرًا وكبيرًا، تاجرًا ومواطنًا، وقد شاع أن الكثير قد تعرض لاحتيال مالي، بقصص مُحزنة عديدة، وليس سرًا أن نقول إن البعض قد صُفِّرَ حسابه البنكي، عبر تحويل جميع رصيده، وبعضه بالملايين، خلال دقائق!
وقد نشر البنك المركزي السعودي عددًا من الأوراق التوعوية، منها ما يوضح (أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي)، وكذلك (نبذة عن الاحتيال المالي)، توضح أبرز أساليب عمليات الاحتيال المصرفي.
وكانت للبنوك حملات توعية، مُلخصها توعية المواطنين بالحفاظ على معلوماتهم السرية، والحذر من المواقع المشبوهة، وأجزم أن ذلك لم يكن كافيًا، بل ولم يكن على مستوى الحدث، والمطلوب رسميًا واقتصاديًا وعُرفيًا من بنوك مُحترفة، تُساهم في حماية ثروات عملائها من الاختراق والضياع.
ومن خلال الاستماع إلى القصص المؤلمة لمن تعرَّض لاحتيال مالي واختراق لحساباته البنكية والاستيلاء على أرصدته، نجد أن العامل المُشترك في كثيرٍ منها، (عدم وضوح الإجراءات الواجب اتباعها لدى البنوك، ولدى الجهات الرسمية، في التعامل مع شكوى أو بلاغ من عميل تعرَّضَ حسابه لاحتيال مالي واختراق)، وكثيرًا ما يلجأ العميل فورًا – عند وصول رسالة لجواله بأن مبالغ قد سُحبت من حسابه وطارت – إلى بنكه، يُبَلِّغه بأن عملية حوالة غير نظامية تمت على حسابه ومن غير موافقته، ويرغب من بنكه اتخاذ أي إجراءات لحماية مبلغ الحوالة، ومن ذلك إيقافها أو تجميدها، أو التواصل مع البنك المحلي الآخر المُحوَّل له المبلغ، في سبيل إيقاف الحوالة قبل أن تطير وتُسافر بلا رجعة خارج البلاد! ومع ذلك وبكل أسف، كانت – في الغالب ولن نقول الجميع – السلبية من بنوكنا المُحترمة، ودون اتخاذ ما يلزم، كأقل واجب على البنك ومسؤولية تجاه حماية عملائه وحساباتهم!.
ثم تكون سلسلة الضياع لدى من تعرض للاختراق، في دوامة من المُراجعات، تتقاذفه كل جهة للأخرى، والدوامة لا تخلو من إجراءات لدى (بنك العميل، بنك المستفيد من الحوالة، البنك المركزي، إدارة حماية العملاء، أقسام الشرط، النيابة العامة، وزارة التجارة، لجنة المنازعات المصرفية)، ولعلَّ الانطباع الذي يخرج به العميل، يتلخص بخذلان الإجراءات له.
وأول الخذلان – فيما أجزم – هو من بنك العميل، حيث يتملص من التزامه مُدعيًا أن الحوالة قد خرجت منه، ويترك العميل وشأنه، ولا شك أن ذلك يعد خطأً وتقصيرًا وتفريطًا من بنوكنا الكريمة، وقد أتاح لي عملي سابقًا مستشارًا بلجنة المنازعات المصرفية، معرفة حدود مسؤولية البنوك والتزاماتهم تجاه عملائهم، بأمل الرجوع إلى بعض ما كتبته سابقًا بهذا الشأن من مقالات في صحيفة “مال”، ومنها مقال “إقراض مواطن بالاحتيال، مسؤولية من؟” المنشور بتاريخ 29/3/2021م، والذي تعرضتُ فيه دارسًا وناقدًا تصريحًا للبنك المركزي بشأن حالة احتيال تعرض لها مواطن، ومقال آخر بعنوان “اختراق الحسابات والبطاقات البنكية، مسؤولية من؟” المنشور بتاريخ 21/4/2021م، ومُلخصها أن هناك مسؤولية على البنوك بحماية عملائها وحساباتهم، وأن القضاء المُختص في المملكة له سوابق وأحكام عديدة في تحميل هذه المسؤولية على البنوك في الحفاظ على أموال العملاء، كونها أمانة لديها، وأنه لا مسؤولية على العميل متى أُجريت العمليات على حسابه دون توقيع منه (يدويًا أو رقميًا) ودون إرادة، على التفصيل الذي ليس مكانه هنا.
أؤكد على ما سبق، لأنني أقرأ كثيرًا من يقول إن المسؤولية تقع على العميل في حفظ معلوماته الشخصية وبياناته البنكية والمحافظة عليها، وإنه متى ما استطاع اللص الحصول على بيانات العميل فالمسؤولية عليه، دون التركيز على مسؤولية البنوك القانونية في المحافظة على أموال العملاء لديها، وأن لا تخرج إلا بتوقيع يدوي أو إلكتروني يُمثل إرادة العميل بإجراء العملية، وإلا كانت مزورة عليه، ويلحق البنك حينها مسؤولية عن العمليات المزورة على العميل، ناهيك عن مسؤولية البنوك عن سلامة نظامها التقني، بحيث لا تمتد إليه أيادي اللصوص باختراق الحسابات، أو تغيير بياناتها، أو إجراء العمليات المُزورة غير النظامية على الحسابات، من غير تأكيد العميل للعملية برمز تحقق.
وببساطة فإن البنوك عندما تُنشِئ أساليب رقمية لعملياتها، فهي مسؤولة عنها، بحيث يكون النظام البنكي التقني مُحكَم السلامة، مُتقَن الأمن السيبراني، وأنه لا عبرة بتقنية قد تؤدي لتمكين اللصوص من اختراق العملاء، وليس سرًا أن بعض من اخترق، تمكنت منه الأيادي، دون خطأ منه، وبعبارة أوضح؛ تمرير العملية من غير رمز تحقق (الكود) من العميل!.
ولا يفوتني هنا بشكر بنكنا المركزي، والذي سبق أن أصدر في أغسطس 2020م (دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية)، والذي تضمن ممَّا تضمنه على إلزام البنوك بإنشاء وحدات لمكافحة الاحتيال المالي، ولوضع السياسات والأدلة وإجراءات العمل المُتعلقة بالتعامل مع حالات الاحتيال المالي، بما يكفل حماية العملاء.
ثم إن بنكنا المركزي قد أصدر بتاريخ 8/4/2022م تعميمه الشامل بشأن (التعليمات والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الاحتيال المالي)، والمُتضمِّن لعدد من الإجراءات الاحترازية لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، وباستقرائها، فإنه يُستفاد منها الآتي:
- إقرار البنك المركزي بأنه رصد ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، ولا شك أن الخطوة الأولى في المعالجة تكمن في الاعتراف بوجود الإشكالية.
- أنه ألزم البنوك باتخاذ الإجراءات الواجبة لحماية حسابات العملاء، ومكافحة وسائل الاحتيال المالي، الأمر الذي يؤكد على مسؤولية البنوك وهي الأجهزة المالية الحساسة، وهي مَنْ تحفظ أموال الناس، وهي الشريان الذي لا غنى للاقتصاد والتجار عنه، مسؤوليتها بأن تكون على قدر التطور والمسؤولية في تعاملاتها البنكية التقليدية والرقمية.
- أنه لا يكفي أن نقول: على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وأن عليهم عدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، وأهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المُتعامل معها.
- شمولية التعليمات والإجراءات والاحترازات التي على البنوك اتخاذها للحدِّ من حالات الاحتيال المالي، والتي تُساهم بتصيد اللصوص وعدم تمكينهم من عملياتهم المزورة المُخترقة، ومن ذلك: وضع حدٍّ أعلى لمبالغ الحوالات اليومية، وأن لا تُنفَّذ الحوالات الدولية عن طريق القنوات الإلكترونية إلا بعد (24) ساعة إذا كانت للمرة الأولى، وبعد ساعتين على الأقل للحوالات التالية لنفس المستفيد، ووضع التدابير الاحترازية لإيقاف أو استعادة الحوالات المالية الدولية الإلكترونية بعد تنفيذها من قبل العميل، والأهم من ذلك الإجراءات الخاصة ببلاغات الاحتيال: بأن تضع البنوك إجراءات داخلية فعّالة تضمن سرعة التجاوب مع حالات الاحتيال بعد اكتشافها أو بعد شكوى العميل، وعلى أن تشمل جميع الإدارات ذات العلاقة وعلى مدار (7/24)، ووضع إجراءات فعالة وسريعة للتجاوب مع حالات الاحتيال الواردة من البنوك الأخرى، ولعلَّ هذا القسم من أهم ما تضمنَه التعميم.
- تأكيد التعميم على البنوك تسليم خطة تشمل: الاستثمار في البنى التحتية والأنظمة المُتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي، وتصحيح الحسابات المفتوحة عن بُعد سابقًا، وبرامج التدريب والتوعية.
ويظهر أن التعميم، والذي كان شاملًا مُباشرًا للبنوك، بإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمُكافحة الاحتيال المالي، قد واجه ضغطًا في الاتجاه الآخر، والذي يريد للتقنية الانطلاق بما تُقدمه من خدماتٍ في عالم المال والحركة التجارية، لذا نجد أن البنك المركزي السعودي قد أعلن بتاريخ 12/4/2022م، أي بعد أربعة أيام، تعديله لتعميمه الصادر بتاريخ 8/4/2022م، المُشار إليه آنفًا، وبالأخص فيما تضمن إعادة رفع حدِّ الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقًا، وإتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، مع العودة في التعميم المُحدَّث إلى “التأكيد على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المُتعامل معها”.
وبصفتي مُراقبًا ومُتابعًا لحالات الاحتيال، فإنني أوصي بالآتي:
أولًا: التأكيد على المنظومة البنكية والبنك المركزي إعداد الدراسات وسن التشريعات والإجراءات الحمائية والتعويضية، حمايةً للمنظومة البنكية الآمنة الشاملة، وللمُتعاملين معها، وبالأخص دراسة الحالات الواردة إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي، للاطلاع على حالات الاحتيال وأساليب اللصوص، للمُساهمة في الحد والقضاء على حالات الاختراقات والاحتيالات، في سبيل أن تكون مملكتنا الغالية دائمًا مملكة المُبادرة والحفظ والسلامة والأمن والأمان للجميع، في بيئة أعمال مهنية راقية محفوظة.
ثانيًا: الاستفادة من مبادئ وقرارات لجنة المنازعات المصرفية، فيما تصدره من أحكام قضائية بموضوع الاختراقات والاحتيال المالي، وتحديد المسؤولية والالتزامات بين البنوك وعملائها.
ثالثًا: إعداد دليل إجراءات للبنوك وعملائها، يوضح ويحدد الإجراءات التي للعميل أن يتخذها، في حال تعرض لاختراق أو احتيال، ولمن يتقدم، ويوضح الإجراءات التي على البنوك أن تتخذها فورًا في سبيل حماية العميل وتجميد وإيقاف الحوالات والعمليات غير النظامية محل الاختراق.
رابعًا: إنشاء وحدة مركزية من الجهات المعنية، وأقلها: البنك المركزي السعودي، والشُرطة، والنيابة العامة، تختص بالتعامل مع بلاغات الاحتيال، وتتمتع بالصلاحيات القانونية التي تُمَكِّنُها من اتخاذ اللازم، وحماية العملاء وأموالهم، وتتبع ومساءلة اللصوص والمُتعاونين معهم.
خامسًا: التأكيد على تطبيق الأنظمة والتشريعات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، إذ لا يكفي وجود التشريعات مع ضعف التنفيذ والتطبيق.
سادسًا: التأكيد على بنوكنا والبنك المركزي، ليكون دورهم فعّالًا حازمًا في سبيل حماية العملاء وتوثيق مصداقية البنوك، وسلامة العمليات البنكية.
سابعًا: التأكيد على الموازنة والمواءمة بين تسهيل الإجراءات البنكية والرَّقمنة، مع إتقان الأمن السيبراني وسلامة الأنظمة التقنية البنكية والإجراءات ذات الصلة، في سبيل تحقيق رؤية مملكتنا الغالية.
ثامنًا: التأكيد على توعية عملاء البنوك بمخاطر التعاملات البنكية وأساليب الاحتيال، والمحافظة على بياناتهم البنكية، وأخذ الحيطة والحذر.
- التعقيب الثاني: د. محمد بن حميد الثقفي
أولًا: أهمية طرح الموضوع:
تحظى دراسة جرائم الاحتيال الإلكتروني بأهمية قصوى؛ بسبب انتشار التعاملات من خلال الإنترنت، وتزايد التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية والبنوك، وأن نسبة كبيرة من الأفراد والشركات أصبحت تعتمد في حصولها على كثير من السلع والخدمات عن طريق التعاملات الإلكترونية، وتكمن أهمية ومناقشة جرائم الاحتيال المالي في النقاط التالية:
- ازدياد عدد الجرائم.
- الصعوبة التي تواجهها جهات العدالة الجنائية في السيطرة على هذه الجرائم.
- تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني.
- نقص الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، بآليات الوقاية من الوقوع ضحايا لهذه الجريمة.
ثانيًا: مفهوم وخصائص جرائم الاحتيال الإلكتروني:
تعد ظاهرة الجريمة إحدى الظواهر الاجتماعية التي تتأثر كثيرًا بما يحدث من تغيرات في المجتمع، وخصوصًا التغيرات التقنية التي تحدث في مجالي الاتصالات والمعلومات، وأن ما حدث من تسارع في تلك التقنيات أدى إلى تطور واحتراف الجريمة، بمعنى أن هذا التطور المتمثل في ظهور أنماط حديثة من الجرائم غير المعروفة سابقًا أو التطور في أساليب ارتكاب الجرائم التقليدية قد يؤدي تبعًا لذلك إلى وضع نشاطات المجرمين بعيدًا عن أيدي رجال العدالة، نظرًا لما تمتاز به هذه الجرائم من خصائص تميِّزها عن الجرائم التقليدية، سواء من حيث ارتكابها أو من حيث كيفية ضبطها.
ويعرف الاحتيال المالي الإلكتروني بأنه: الحصول على مال الغير بالحيلة والخداع والتضليل، وباستخدام التقنية، بحيث لا يشعر الضحية بالوقوع عادة إلا بعد تنفيذ الجريمة، وتستهدف عمليات الاحتيال الناس من كل الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل في كل أنحاء أستراليا. كل شخص معرّض لعمليات الاحتيال، لذا يحتاج الجميع إلى معلومات عن كيفية التعرُّف عليها وتفاديها. المحتالون أذكياء، وإذا لم تعرفوا ما الذي يجب أن ينتبهوا له، يمكن لأي شخص أن يقع ضحية عملية احتيال.
وتعد جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني إحدى أنماط الجرائم المستجدة، التي أفرزتها التقنية، والتي تتميز بعدد من الخصائص التي تميِّزها عن الجرائم التقليدية، ومن أبرزها:
- استخدام التقنية الحديثة والأساليب المبتكرة في كل عملية.
- تدويل الجريمة المستجدة وإخراجها من الحدود الوطنية والإقليمية.
- تعدد جنسيات الأشخاص والمنظمات المرتبطين بها.
- عدم توافق الظرف الزماني والمكاني بين الجاني والضحية.
- ارتفاع تكلفتها وآثارها على الأبنية الاجتماعية مقارنة بالجرائم التقليدية..
- عدم ظهور غالبية هذه الجرائم عادة في الإحصاءات الجنائية الرسمية.
- ارتفاع مستوى المهارة في درجة استخدام أحدث التقنيات لتنفيذ جرائمهم.
- نقص المعرفة والمهارة المتعلقة بهذه الجرائم لدى رجال العدالة الجنائية.
- بروز عنصر الحداثة وعدم الألفة.
- أن مصطلح الاستحداث في هذه الجرائم مصطلح فضفاض وغير محدد، ومتطور دائمًا.
- الحاجة الملحة للتدخل بآليات تشريعية وأمنية مُواكِبة.
- تميُّز ضحايا الجرائم المستجدة عن ضحايا الجرائم التقليدية.
ونظرًا لحداثة مصطلح الجرائم المستجدة في الثقافة الأمنية عمومًا، فإنه لا توجد تصنيفات معتمدة للجريمة تحدد الجرائم التقليدية من الجرائم المستجدة، حيث لا يوجد في التقارير الإحصائية وتصنيفات الجريمة ما يُعبِّر عن الجرائم التقليدية والجرائم المستجدة، ولكن هناك العديد من التصنيفات التي تنطبق على هذه الجرائم، ويمكن تصنيفها وفقًا لدوافعها وأدوات استخدامها، وذلك وفقًا لما يلي.
- الجرائم التي تنطلق من دوافع اقتصادية: وتتمثل في الجرائم المنظمة، والجرائم المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وجرائم غسيل الأموال، وجرائم التهريب، وأخيرًا جرائم الاتجار في المخدرات، وبالتالي تعد جرائم الاحتيال المالي إحدى أنماط هذا النوع من الجرائم.
- الجرائم التي تنطلق من دوافع سياسية: ومن أمثلتها؛ جرائم الإرهاب، وتكوين تنظيمات سرية، والاغتيالات السياسية.
- الجرائم التي تنطلق من خلل في القيم الأخلاقية: ومن أبرزها: جرائم الاتجار بالنساء والأطفال، وجرائم صناعة وتهريب الأفلام الجنسية، والفساد الإداري.
- الجرائم التي تعتمد على بروز التقنية الحديثة: ومن أبرزها: جرائم الحاسب الآلي، ونظم المعلومات، وجرائم النقل والمتاجرة بالأعضاء البشرية.
ثالثًا: كيف يمكن الحد من هذه الجرائم:
تتطلب الجرائم المستجدة ومنها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني التي اتضحت خصائصها، مهارات وتشريعات ودراسات نوعية تتناسب مع الابتكار والاستحداث المستمر في ارتكاب هذه الجرائم، ومن أبرزها:
- إعداد قوات أمن محترفة وذات مهارة عالية في مواجهة الجريمة: وتتضمن التطوير المعرفي والمهاري والتحديث التقني، وهي هنا تتطلب الاختيار الجيد للمعينين الجدد، وصقل الملتحقين بالعمل الأمني بالتدريب، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وسيبرز هنا العمل الأمني المتقن وفق أحدث المعارف العلمية وأعلى المهارات الأدائية.
- تأهيل الجهات المرتبطة بجرائم الاحتيال المالي: كالبنوك، والادعاء العام، ومنظمات الأمن السيبراني.
- تطوير ومتابعة الأنظمة واللوائح: المرتبطة بتجريم هذه السلوكيات، وكيفية تحريزها، والادعاء العام والحكم فيها.
- التوعية المستمرة لأفراد المجتمع: من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم، حيث تشير الدراسات إلى أن للضحية دورًا كبيرًا في تعرضه ضحية للجريمة.
- التعاون الدولي: تتطلب الجرائم المستجدة ومنها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني تعاونًا دوليًا قويًا، يمكن الدولة والضحايا من الحصول على ممتلكاتهم المأخوذة.
- الدراسة العلمية المستمرة: يعد البحث العلمي والرصد المستمر لأحدث أساليب الاحتيال، ونشر النتائج أولًا بأول.
الجدير بالذكر أن كثيرًا من جرائم الاحتيال الإلكتروني نجحت المؤسسات الأمنية والمالية والتقنية المختصة في الحد منها، ويظل الدور الأساس في هذا النوع من الجرائم رهينًا بزيادة الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.
رابعا المقترحات:
- تكثيف برامج التوعية بالوعي الأمني من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
- التطوير المستمر للمهارات اللازمة لجميع مؤسسات العدالة الجنائية.
- الدراسة العلمية المستمرة للظاهرة، وكيفية التخفيف منها.
- المداخلات حول القضية
- واقع جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني ومخاطرها.
من المُسلَّم به أن معضلة الاحتيال المالي الإلكتروني جديرة بالبحث، وذلك لخطورتها على المجتمع وأفراده والاقتصاد الوطني ومدى الموثوقية به عالميًا وبالأجهزة القائمة عليه، وفي هذا السياق يمكن القول أن عمليات الاحتيال المالي تستهدف جميع أفراد المجتمع بمختلف الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. فكل شخص مهما بلغ ذكاؤه وحرصه مُعرَّض لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني التي يتميز المجرمون القائمون بها بالحرفية والذكاء، لذا وجب على الجهات المالية وعلى رأسها مؤسسة النقد تزويد جميع المواطنين والمقيمين بالمعلومات المحدثة التي تساعدهم في التعرُّف على وسائل الاحتيال وتفاديها، فالمحتالون أذكياء، ومدربون ولديهم مافيا خطيرة وتشكيلات عصابية عالمية عابرة للحدود، ويستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة، والمنتجات أو الخدمات الجديدة والمناسبات الكبرى لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناع الناس بتقديم المال أو تفاصيل المعلومات الشخصية، لدرجة أن المحتالين ينتحلون صفة الموظفين الحكوميين ويطلقون ادعاءات كاذبة، أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلًا، والاعتقال والترحيل عن البلاد لتخويف الأفراد وحملهم على دفع المال، ومن وسائلهم أنه قد يحصل هؤلاء المحتالون على بعض المعلومات الشخصية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ليجعلوا مطالبهم تبدو مشروعة وأكثر مصداقيةً وقبولًا لدى الضحايا.
ونظرًا للتطور الكبير والسريع في الخدمات المالية التي تقدمها البنوك عبر القنوات التقليدية والإلكترونية، ازدادت عمليات الاحتيال المالي وتعددت أساليبها وطرقها وتتجدد بين فترة وأخرى وتتخذ أشكالًا وصورًا متغيرة.
وثمة أساليب مختلفة للاحتيال الإلكتروني منها حالات الاختراق للحسابات البنكية، وهو يتم بعدة طرق، منها بالاستفادة من جهل العميل والتغرير به ليُرسل كود تحقق إلى المحتال، والذي يستفيد منه في تمرير العملية، وهنا لا شك أن هناك مسؤولية تقع على العميل، وهؤلاء يجب التركيز على جانب التوعية معهم.
إلا أنه في المقابل هناك عمليات اختراق محترفة يتمكن فيها المحتال، من الدخول إلى إعدادات عميل البنك وتغيير رقم جوال العميل، وتغيير إعدادات الحساب، ومن ثم التصرف فيه وإجراء الحوالات، ويتم بعضها من غير أي كود من العميل، وهنا لا شك أن المسؤولية الأكبر على البنك كونه المسؤول عن حماية حسابات العملاء، وأن تكون التقنية البنكية سليمة مُتقنة لحماية العملاء.
وقد أصدر البنك المركزي تعميمه للحد من الاحتيال، والذي تضمن تأكيدات عدة على البنوك اتخاذها للتعامل مع شكاوى العملاء الخاصة بحالات الاحتيال، ولإيقاف الحوالات بل ولتتبعها مع البنوك المُحوَّل لها، وقد يسهم ذلك في تقليص أعداد الاحتيالات.
والمشكلة أن أغلب جرائم الاحتيال والسرقة المالية تكون من خارج الدولة، حتى لو كان فيه وسيط محلي، وأيضًا عامل الوقت حتمي، فلا بد من تعاون دولي إلكتروني سريع ولو كان إلى أفضل، للتعرف والتعريف بالمحتال أو الكيان الذي انطلق منه والعنوان الإلكتروني له ip address وتحديد موقعه الجغرافي على الخريطة وتحديد المواقع البينية لتنقل الأموال -إن وُجدت-.
كما أن طرق المحتالين تتجدد باستمرار بعد متابعة دقيقة لكل المستجدات في مجتمعنا ؛ فلم تبقَ وسيلة تسهل عليهم الاحتيال ولم يلجؤوا لها، فعلى سبيل المثال لا الحصر: مع بداية رجب تزداد رسائل الاستثمار الوهمية لأموال المتقاعدين، وقبيل رمضان تتعرض العديد من العوائل للاحتيال بسبب الحاجة لاستقدام عاملة منزلية، وقبل العيد تزداد الرسائل المشبوهة عن وجود طرد لك ولتتبع الطرد يضعون رابطًا ومن هنا تبدأ المأساة لمن يفتحه .ومع دخول وقت السفر قد يتعرض بعض الأشخاص للاحتيال بسبب تجديد جواز السفر وعن طريق تزوير مواقع رسمية.
أما الطرق المستمرة للاحتيال طوال العام كانت بسبب استغلال حاجة شبابنا للوظائف، والفجوة الإلكترونية الكبيرة لدى كبار السن كونهم لا يعرفون استخدام التقنية ولا يعرفون كيف ينهون معاملاتهم إلكترونيًا، ويضطرون للاستعانة ببعض المعلنين عن إنجاز المعاملات سواء بتويتر أو عبر الواتس وغيره، ويرسلون لهم كافة المعلومات ورموز التحقق، وبعضهم قد يكون أمينًا، وبعضهم يحتال عليهم.
لكن السؤال هنا: مَنْ يُسرِّب لتلك العصابات أرقام وأسماء وبعض معلومات المستهدفين لدى البنوك؟!! كما أن اتصالات المحتالين المهددة ” سنوقف حسابك، إن لم تقم بتحديث معلوماتك خلال ربع ساعة وإلا..” لا زالت مستمرة ولم تتوقف، والغريبة أن كل الأرقام المتصلة تبدو داخلية، فهل حقق التواصل مع الرقم (( 330330 )) فائدة ؟
وهناك جرائم مالية سوف تكون متصلة بجريمة الاحتيال المالي بشكل مباشر، وهي جريمة غسل الأموال؛ لأن المحتالين عند الحصول على الأموال سوف يبحثون عن طرق مختلفة لإخفاء المصدر الأساسي لهذه الأموال ومحاولة إرجاعها إلى النظامي البنكي بطرق مختلفة، وهنا سوف يكون هناك أضرار مباشرة على الاقتصاد في بيئة الأعمال السعودية والقطاع المالي والمصرفي بشكل خاص منها (تشويه سمعت هذا القطاع).
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عضو أساسي في مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force (FATF) من شهر June 2019، وهذا يعني أن المملكة ليس عضوًا منظمًا ولكن أيضًا عضوًا يشارك في استحداث وتطوير نظم لمكافحة جريمة غسل الأموال وردعها. وهذا يضع المملكة أمام مسئولية كبيرة.
- أسباب تزايد جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني المعاصرة.
يبدو أن أهم سبب في هذا النوع من الجرائم هو التوسع المذهل والمتسارع في الاعتماد على الإنترنت والتحويلات الإلكترونية وإنجاز المعاملات المالية عن بُعد دون أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما عُرف عنا من منح الثقة للآخرين دون تحرٍّ كافٍ، ناهيك عن الثقة شبه المفرطة في التعاملات الإلكترونية، علمًا أن هذه الممارسات، أي الاحتيال ليست بالجديدة.
نحن نتذكر مثلًا في التسعينيات الماضية رسائل البريد الإلكتروني التي كانت تصلنا من بعض دول إفريقيا كنيجيريا، حيث يشرح المرسل أن لديه مبلغًا كبيرًا وغالبًا بالملايين يود تحويله إلى حساب بنكي خارج بلده وأنه بحاجة إلى من يساعده في ذلك نظير جزء من المبلغ، وذلك بعد حصول انقلاب وما شابه ذلك من أحداث، ثم يطلب في النهاية رقم الحساب البنكي للمرسل إليه لوضع المبلغ في حسابه، يسبق ذلك تحويل مبلغ صغير لإنجاز المهمة كرسوم، وهكذا من قصص الاحتيال التي اعتدنا على قراءتها في تلك الرسائل البائسة.
أيضًا هناك من يتواصلون من خارج المملكة لطلب مساعدة مالية من خلال تحويل بنكي وهي ظاهرة مستمرة. ومثل ذلك المكالمات التي قد تردنا من أرقام غريبة وعادة من جزر ودول إفريقية وآسيوية.
السبب الثاني لشيوع الظاهرة هو جهل البعض منا بالرقمنة وسبل التعامل معها بطرق صحيحة ومأمونة، يضاف إلى ذلك إفشاء البعض لمعلوماته البنكية والمالية التي يفترض أن تكون سرية كرقم الحساب، والأرقام السرية لبطاقات الصرف الآلي أو الفيزا وعدم أخذ الحيطة والحذر مع التذكير أن هناك عدة إجراءات احترازية كثيرًا ما نبه عليها المختصون لتلافي الاحتيال لكن البعض لا يعيرها اهتمامًا كافيًا.
سبب إضافي هو التهاون في إعطاء أجهزتنا كالجوالات لأطفالنا وعبثهم بها، مما قد يحدث معه أخطاء يترتب عليها تسريب بيانات أو معلومات قد تُستخدم للتحايل المالي.
وبنظر البعض فإن هناك ثمة تقصير من الجهات المختصة بشأن التوعية بالاحتيال المالي الإلكتروني، حيث يجب أن لا يُكتفى برسالة جوال تحذيرية من الجهات المختصة لا تتجاوز في طولها الأربعة أسطر حول هذا الموضوع المهم، والذي تم من خلاله سلب أموال آلاف المواطنين نصبًا واحتيالًا.
وتذهب عدد من وجهات النظر إلى أن المسؤولية تقع بشكل واضح على البنوك في حال الاختراقات لأنظمتها تحت عاصفة الإرهاب المالي الإلكتروني الذي حصل في الفترة الأخيرة، ويتشارك معها البنك المركزي وأجهزته لإهمالها وتراخيها إن حدث، والأفراد في حال إهمالهم يتحملون المسؤولية، ومن يكشف ذلك جهات القضاء القوية المصرفية، مع التحفظ الكبير على مسار اللجان القضائية القائمة التي غالبًا ما تجامل البنوك على حساب الأفراد.
والواقع أنه لدى البنك المركزي، إدارة حماية العملاء، تتلقى شكاوى العملاء ضد البنوك في حالات الاختراق وغيرها، ولكن الملاحظ أن عدد الشكاوى في السنة تزيد على مائة ألف، مما يؤكد كثرة شكاوى الناس من تعاملاتهم مع البنوك، وفي ذات الوقت ضعف المعالجة من البنك المركزي، كون البنوك تجيب على الشكوى بأن موقف البنك سليم، ثم تقفل الشكوى في الغالب، الأمر الذي يؤكد ضعف المعالجة.
وفي ذات الإطار، فلعل من الأسباب الرئيسة للاحتيال المالي الإلكتروني عدم وجود جهة رسمية متخصصة ومعلومة لدى الجمهور تقوم بتلقي شكاوى المواطنين الذين تعرضوا لحالات الاحتيال وتكون موجودة 24/7 ترد على الضحية بشكل فوري وتُسجِّل بلاغًا حول الشكوى وتقوم بالمعالجة الفورية. للأسف الوضع الحالي كل جهة تحيلك للجهة الأخرى وفي النهاية تضيع حقوقك وأموالك. والجميع يعرف أشخاصًا تعرضوا لحالات احتيال مالي إلكتروني وسُرِقت منهم مبالغ ضخمة ولهم أشهر لم يتم حل قضاياهم. وعليه فمن المفيد تحديد جهة مختصة رسمية يمكن الرجوع لها حالًا تُعالِج كل قضية برمتها وبشكل عاجل.
كما أن من نقاط الضعف عدم وجود كوادر وطنية مدربة في مجال الاحتيال المالي الإلكتروني (وهذا تعتبر ثغرة كبيرة)، فنحن نحتاج تأهيل مَن يردع ومَن يكتشف ومَن يحقق ومَن يقوم بالتوعية… في (الشرطة/ النيابة/ البنوك/ البنك المركزي/ …..).
ويرى البعض أن مرجعية البنوك في المملكة إلى البنك المركزي، ومن خلال التجارب فإن هناك تراخيًا لدى بعض البنوك في التطبيق، وربما قد شغلتها الربحية عن الحمائية والتطوير. وعلى العموم فالتنسيق ضعيف بين الجهات ذات العلاقة المرتبطة بالاحتيال المالي (البنوك والشرطة والنيابة والبنك المركزي).
- وسائل الحد من جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
جرائم الاحتيال الإلكتروني المنتشرة هذه الأيام تعد من الجرائم المستحدثة التي تحتاج إلى حلول مستحدثة لمواجهتها والحد منها. فالحلول التقليدية لا تستطيع أن تكافحها، فالمجرم السيبراني تطور بشكل كبير جدًا وسبق جهات المكافحة والضبط، ولذلك يجب أن تكون المعالجة مبتكرة. فعندما تحدث عملية نصب واحتيال مالي إلكتروني ويراجع الضحية البنك، يطلب منه البنك الذهاب لمركز الشرطة ويبلغ، وإذا ذهب الضحية لمركز الشرطة يدخل في دوامة الاختصاص. وبعد ما تُدوَّن القضية يكون المجرم قد فلت من يد العدالة. لذلك لا بد من تيسير وتسهيل وتسريع وجديّة إجراءات التبليغ والمتابعة.
ومما لا شك فيه أن موضوع الحد من جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، أو أي جريمة يتطلب:
1- التجريم القانوني: وهو موجود ومن خلال أحدث الأنظمة، جرائم المعلومات.
2- الشكوى، أو الإبلاغ عن الجريمة.
3- الرصد والتحري الأمني (تقنيًا، وميدانيًا).
4- التحقيق والادعاء.
5- إصدار الحكم.
6- إعادة التأهيل.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، وذلك في إطار جهودها للحد من جرائم الاحتيال المالي.
ويتطلب بالتوازي مع إصدار القوانين توعية الجمهور، لعدم الوقوع في هذه الجرائم!! علمًا بأن هذه الجرائم من الجرائم الكبرى المُوجِبة للتوقيف، وأن الحكم فيها -إضافة الحق الخاص فيه- حكم عام مغلظ وفقًا للعقوبات المحددة في انتهاك جرائم المعلومات، ومن خلال حلقة إجراءات العدالة الجنائية المشار إليها أعلاه، والتي تتطلب التكامل، والوعي، والمهارة المناسبة، يمكن ضمان الحد من الجريمة، سواء الاحتيال أو غيرها!!
وبالتأكيد فإن الحماية الوقائية هي أول إجراء يجب تفعيله بصورة أكبر مع التقدير التام للجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضرورة تعاون الإعلام في رفع الثقافة الحمائية وتفعيل الأنظمة والقوانين المالية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتخاذ البنوك وسائل وإجراءات حمائية أقوى، للحد من الاحتيال المالي الإلكتروني بصورة أكبر.
ويجب على الجهات المعنية العمل على نشر كل الأدلة والإجراءات والمعلومات التوعوية والتحذيرية ذات العلاقة بالموضوع بشكل تفصيلي وعلى نطاق واسع يصل إلى غالبية المجتمع. كما توجد ضرورة لأن يكون هناك وضوح حول الخطوات والإجراءات المتبعة في حال تم تعرض أي مواطن أو مقيم لحالة نصب واحتيال. بمعنى آخر ماذا ينبغي على من وقع في حالة نصب واحتيال (الضحية) أن يقوم به لاسترداد حقه وماله؟ لأنه في مثل هذه الحالات كل جهة تحيله إلى جهة أخرى حتى يمل الضحية ويضيع حقه. وعلى نحو أكثر تحديدًا من المهم في هذا الإطار التأكيد على ضرورة تكثيف التوعية كمًا ونوعًا في مجال الاحتيال المالي، فضلًا عن توضيح الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال تعرض شخص ما لعملية احتيال مالي.
أيضًا فإن على الدول تطوير جدران نارية إلكترونية تمنع نقل أي نوع من التحقق الإلكتروني الثنائي أو الثلاثي Two way authontication إلا بين جهاز العميل المعرف لديهم وجهاز البنك مباشرة.
وفي سياق متصل يعد من أبرز مهام وصلاحيات البنك المركزي، وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء. وبناءً على ذلك قام البنك المركزي، باتخاذ إجراءات عاجلة ومؤقتة ترتبط بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال. لكن يبقى على البنك المركزي دور مؤثر وفعال في إصدار قرارات تقف في صف عملاء البنوك أمام تقاعس البنوك في الوقوف مع عملائها وحمايتهم والعمل بصورة جادة في استرداد مبالغهم في حال ثبتت عملية التحايل المالي.
نقطة مهمه يجدر الإشارة إليها هنا، أنه مع تغير وتطور طرق الاحتيال تحاول الجهات المعنية سواء كانوا مُنظِّمين أو بنوك تطوير بيئتها التحتية للكشف عن طرق الاحتيال والتلاعب. لعل آخر هذه الطرق هو استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات غسيل الأموال والاحتيال والاستيلاء على بطاقات الائتمان والحسابات البنكية عن طريق استخدام لوغاريتمات معينة لمعرفة سلوك المحتالين باستخدام تقنيات مثل .ML
ومن المهم حث البنوك على مراجعة أنظمتها التقنية، وأمنها السيبراني، وتنفيذ وتطبيق ما يصدره البنك المركزي من تعليمات وتعاميم، وعدم ترك العميل يتخبط عندما يأتي إلى البنك يخبره أن حسابه قد اخترق، ويطلب تجميد الحوالة، في حالة واضحة للاختراق والاحتيال، وربما قد مضى عليها دقائق محدودة، ومع ذلك لا يتخذ البنك أي إجراء عملي لحماية عميله، في حين أنه ملزم بتطبيق تعميم البنك المركزي، ويستطيع أن يتتبع الحوالة مع البنك المُحوَّل له.
وثمة أهمية لإعداد دليل إجراءات واضح ليعمل به من يتعرض إلى عملية احتيال، ودليل آخر إلى الجهات الرسمية، يحدد لها آلية التعامل مع بلاغات الاحتيال. حيث المُلاحظ أن الإجراءات الرسمية والبنكية غير واضحة المعالم، وقد تتأخر، مما يتسبب عنه التأخير، وبالتالي خروج الأموال إلى خارج المملكة.
وثمة أهمية لوجود هيئة مركزية تشترك فيها الجهات المعنية (الشرطة والنيابة والبنك المركزي ومَن يمثل البنوك) لتلقي بلاغات الاحتيال، والتعامل معها مِن خلال جهة واحدة يتمثل فيها الجميع.
ومن ناحية أخرى فإن أمن المعلومات أو ما يسمى الأمن السيبراني يتطلب وضع سياسات الكشف، وآلياته، وأساليب ضبط الجرائم المستجدة، ومنها جرائم الاحتيال، وبالرغم من وجود جهة معنية بالأمن السيبراني خارج المؤسسات الأمنية؛ إلا أن الجهات الأمنية أبدعت كثيرًا في ضبط كثير من هذه الجرائم، والدليل على ذلك الوسم الجميل الذي نفرح برؤيته على وسائل التواصل #تم_القبض !!
لكن من الضروري التأكيد على البنك المركزي وإدارة حماية العملاء، والتعامل بجدية ومسؤولية أكثر مع شكاوى العملاء، والتدقيق والتحقيق فيما تدعيه البنوك. في سبيل تحقيق بيئة استثمارية وبنكية ذات مصداقية أعلى تتناسب مع مكانة المملكة وما تصبو إليه القيادة ورؤيتها الثاقبة.
ولعل من المهم إدراج مواد دراسية وكراسٍ بحثية في الجامعات المحلية لموضوع الاحتيال النقدي الممنهج تحت مظلة الأمن السيبراني، فبالإضافة إلى نشر التوعية للمجتمع من خلال ندوات إلكترونية ومواد منشورة وبوجه الخصوص لفئات كبار السن الأكثر عرضة للاحتيال.
ووفقًا لأحدث الممارسات الدولية القانونية يمكن تفادي الوقوع كضحية للاحتيال المالي، عبر اتباع الوسائل التالية:
- التيقظ لعمليات الاحتيال المالي وذلك، أنه عندما تتعامل مع اتصالات متطفلة من قِبل أشخاص أو مصالح تجارية، سواء كانت عبر الهاتف، البريد، الرسالة الإلكترونية، شخصيًا أو على موقع لشبكات التواصل الاجتماعي، خذ في الاعتبار دائمًا احتمال أن يكون الاتصال عملية احتيال، بمعنى تقديم سوء النية.
- اعرف مع من تتعامل، إذا كنت قد التقيت بشخص ما عبر الإنترنت فقط، أو إذا لم تكن متأكدًا من شرعية مصلحة تجارية، خذ وقتًا لتقوم ببعض الأبحاث الإضافية. قم ببحث عن الصور في محرك Google للصور أو ابحث عبر الإنترنت عن أشخاص آخرين من المحتمل أن يكونوا قد تعاملوا معهم.
- لا تفتح نصوصًا أو نوافذ تظهر أمامك أو رسائل إلكترونية مشبوهة – قم بإلغائها. إذا لم تكن مألوفة، وتأكد من هوية المتصل عبر مصدر مستقل مثل دليل الهاتف أو بحث على الإنترنت. ولا تستعمل تفاصيل الاتصال المتوافرة في الرسالة المرسلة إليك.
- احتفظ بتفاصيلك الشخصية بشكل آمن. ضع قفلًا على صندوق بريدك ومزّق فواتيرك وغيرها من الوثائق المهمة قبل أن ترميها. احتفظ بكلمات السر والأرقام السرية الخاصة بك في مكان آمن. كن حذرًا جدًا لناحية كمية المعلومات الشخصية التي تشارك بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
- حافظ على أجهزة هاتفك والكمبيوتر الخاص بك بشكل آمن. استخدم دائمًا الحماية بكلمة سر، لا تشارك الآخرين الدخول (حتى من بُعد)، قم بتحديث برنامج الكمبيوتر الأمني واحتفظ بنسخة احتياطية للمحتوى. احمِ شبكتك الخاصة بالـ WiFi بوضع كلمة سر عليها وتفادى استخدام أجهزة كمبيوتر عامة أو النقاط الساخنة في الـ WiFi للقيام بعمليات مصرفية أو تقديم معلومات شخصية على الإنترنت.
- اختَرْ بعناية كلمات السر الخاصة بك. اختَرْ كلمات سر تكون صعبة على الآخرين ليحزروها وقم بتحديثها بانتظام. لا تستخدم كلمة السر ذاتها لكل حساب/نبذة، ولا تشارك كلمات السر الخاصة بك مع أحد.
- راجع ترتيباتك المتعلقة بالخصوصية والأمن على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كنت تستخدم مواقع شبكات للتواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك، كن حذرًا مع من تتواصل وتعلّم كيف تستعمل ترتيباتك المتعلقة بالخصوصية والأمن لضمان بقائك بأمان.
- احذر من أي طلبات تتعلق بتفاصيلك أو مالك. لا ترسل مالًا أبدًا و لا تعطِ تفاصيل بطاقة الائتمان أو تفاصيل الحساب على الإنترنت أو نسخًا من وثائق شخصية إلى أيّ شخص لا تعرفه أو لا تثق به.
- كن حذرًا عندما تتسوّق على الإنترنت. احذر العروض التي تبدو مغرية جدًا لتكون صحيحة، واستخدم دائمًا خدمة تسوّق على الإنترنت تعرفها وتثق بها.
- التوصيات
- إنشاء لجنة دائمة من (البنك المركزي – الأمن السيبراني -هيئة الاتصالات – الأمن العام) تتابع آخر المستجدات وتسد الثغرات مع الجهات المعنية، لتكون جهة رقابية في حركة وسلامة وأمن العمليات المصرفية ومنها الاحتيال المالي، ترتبط بالبنوك بالجهات الدولية المسؤولة لتبادل الخدمات والمعلومات ACFE على غرار إنتربول متخصص للاحتيال المالي.
– الجهة ذات العلاقة (البنك المركزي).
- توفير خط ساخن لتلقي بلاغات المتضررين من جرائم الاحتيال المالي وربطها مع البنك المركزي والبنوك، يملك صلاحية ايقاف العمليات المصرفية لحسابات العملاء الذين يشتبهون بوجود احتيال مالي أو تحويلات مشبوهة، وتوفير الحماية القانونية والدعم والتوجيه الفني والمشورة للعملاء الذين يتصلون بالخط الساخن للإبلاغ عن وجود شبهة احتيال مالي لإيقاف حساباتهم بصفة عاجلة.
– الجهة ذات العلاقة (البنك المركزي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
- سرعة الحكم في قضايا الاحتيال المالي من جهات مختصة مع مراعاة أنها جرائم عابرة الحدود.
– الجهة ذات العلاقة (وزارة العدل).
- تطوير برنامج توعية نوعي للتقليل (ليشمل المقروء، المرئي، المسموع، صناع المحتوى…إلخ) من جرائم الاحتيال المالي يتم تمويله عن طريق لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، ويتم تطويره بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وفق نظام حماية المستهلك من الغش والخداع والإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة المؤدية إلى الاحتيال المالي، ورفع مستوى الرقابة على ممارسات الاحتيال المالي وتجريمها ورفع مستوى وعي المستهلك، بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والمنظومات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
– الجهة ذات العلاقة (وزارة الإعلام).
- التأكيد على المنظومة البنكية والبنك المركزي إعداد الدراسات العلمية لظاهرة الاحتيال المالي وسن التشريعات والإجراءات الحمائية والتعويضية لذلك.
– الجهة ذات العلاقة (البنك المركزي).
- الاستفادة من مبادئ وقرارات لجنة المنازعات المصرفية، فيما تصدره من أحكام قضائية بموضوع الاختراقات والاحتيال المالي، وتحديد المسؤولية والالتزامات بين البنوك وعملائها.
– الجهة ذات العلاقة (البنك المركزي).
- توظيف وترقية دور الأمن السيبراني في جميع العمليات المصرفية وسلامة الأنظمة التقنية البنكية والإجراءات ذات الصلة، في سبيل تحقيق رؤية المملكة.
– الجهة ذات العلاقة (هيئة الأمن السيبراني).
- التأكيد على هيئة الاتصالات بتكثيف جهودها في التفاعل الفوري مع بلاغات الجمهور المتعلقة بطلب حجب المواقع أو الأرقام الهاتفية الاحتيالية (جوال، ثابت) والمرسلة من قبل المتضررين على رقم بلاغات الهيئة (330330). وخط ساخن مرتبط بصلاحية ايقاف العمليات المصرفية حال التعرض للاحتيال الالكتروني.
– الجهة ذات العلاقة (هيئة الاتصالات).
المصادر والمراجع
- دليل الوقاية من عمليات الاحتيال المالي، البنك المركزي السعودي، متاح على الربط الإلكتروني: https://samacares.sa/uploads/2022/01
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ.
- دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤسسة النقد العربي السعودي، ربيع الأول 1441هـ.
- البنك المركزة السعودي: أبرز إحصاءات أساليب الاحتيال المالي لعام 2021م، إبريل 2022م.
- وائل محمد نصيرات وغادة عبدالرحمن الطريف: جريمة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية: دراسة مقارنة للنظام السعودي والقانون الأردني، دفاتر السياسة والقانون، العدد (19)، جوان 2018م.
- بولحية شهيرة وسويح دنيا زاد: الاحتيال الإلكتروني، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد (2)، العد (2)، ص ص 37-46.
- تيسير أحمد حسين الزعبي: جريمة الاحتيال الإلكتروني، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات القانونية، جامعة جدارا، 2010م.
- بدر بن أحمد بن محمد الزهراني: جريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014م.
- عبدالله دغش العجمي: المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 2014م.
- المشاركون.
- كاتب الورقة الرئيسية: د. محمد الزهراني
- المعقبون:
- أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى
- د. محمد الثقفي
- مدير الحوار / اللواء فاضل القرني
- المشاركون بالحوار والمناقشة:
- د. عبدالرحمن الهدلق
- د. محمد العامر
- د. خالد الرديعان
- د. محمد المقصودي
- أ. أحمد المحيميد
- د. عبدالرحمن العريني
- الفريق د. عبد الإله الصالح
- د. خالد المنصور
- د. مها المنيف
- أ. فهد القاسم
- د. عبدالله الرخيص
- د. حسين أبو ساق
- أ. عبدالله الضويحي
- م. سالم المري
- د. زياد الحقيل
- د. علي الطخيس
- د. فايزة الحربي
- د. وفاء طيبة
- أ. فائزة العجروش
- د. هناء المسلط
- د. ماهر الشويعر
- د. عائشة الأحمدي
- د. حميد الشايجي
- د. زياد إدريس
- أ. لاحم الناصر
- م. أسامة كردي
- د. رياض نجم
- أ. فهد الأحمري
- أ. بسمة التويجري
- أ. عبدالرحمن باسلم
- د مساعد المحيا
القضية الرابعة
مستقبل جودة التعليم من
خلال التعليم الأهلي
(27/6/2022م)
- الملخص التنفيذي.
تناولت هذه القضية مستقبل جودة التعليم من خلال التعليم الأهلي، وأشار د. محمد الملحم في الورقة الرئيسة إلى أنه حتى 2020 شــكَّل قطـاع التعليـم الأهلي بالمملكـة حصـة 10% مـن إجمالـي نشـاط التعليـم النظامـي. وعلى الرغم من أن التعليم الأهلي يواجه تحديات وصعوبات ويناشد الوزارة باستمرار للاستماع إلى مطالبه، لتسهيل عمله، كما أن هناك من يطالبون أيضًا بأهمية وضع استراتيجيات طويلة الأمد لتنمية هذا القطاع؛ إلا أن غالبية هذه الجوانب كمية في المقام الأول، وتنظر إلى الجانب المادي سواء في ما يخص نموذج الأعمال للتعليم الأهلي Business Model وضمان حيويته، وبالتالي ضمان العطاء على المستوى الفردي لكل مؤسسة أهلية أو في مجال الاهتمام بالقطاع عمومًا للحفاظ على قيمته الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتظل هذه النظرة أيضًا نظرة كمية لا تهتم كثيرًا بالجانب النوعي، لذلك فهي غالبًا تحوم حول التشريعات والنظم التي تُسهِّل عمل التعليم الأهلي.
بينما أوضح د. زياد الحقيل في التعقيب الأول أن كثيرًا من الطروحات عن جودة التعليم الأهلي تركز على القياسات الكمية. مثلًا درجات الثانوية، درجات اختبار القياس والتحصيلي، الدرجات في الجامعة. وهي بلا شك جوانب مهمة، لكنها ليست كل شيء. فهناك بُعد العلاقات والمهارات والثقافة وغيرها. كما أنه يمكن التوسع في الاستفادة من توفر معلومات الطلاب، في مدارسهم ونتائجهم في اختبارات القياس والتحصيلي ومن ثم في الجامعات، في إجراء دراسات كمية ومقارنة وتصنيف وترتيب جميع المدارس الحكومية والأهلية. وهذا النوع من التصنيف، مع ما عليه من مآخذ، قد يدفع المدارس بشكل عام إلى تجنب منح الدرجات بشكل زائد للطلاب. وهو أمر لوحظ في الولايات المتحدة من قبل.
في حين ذكر د. ناصر الملحم في التعقيب الثاني أنه برغم الإنجازات الكبيرة والنتائج الإيجابية التي تحققت لعدد من المدارس الأهلية والعالمية في المملكة العربية السعودية؛ إلا أن ذلك لا يعكس مستوى الأداء التعليمي لدى شريحة كبيرة من مدارسها، وفي ضوء ذلك ومع التنامي الكبير في أعدادها تبرز الحاجة إلى وجود نظام لتقويم أداء تلك المدارس واعتمادها، بهدف تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وتوفير البيانات الموثوقة التي تساعد أولياء الأمور وصانعي السياسات التعليمية من اتخاذ القرارات المناسبة لأبنائنا.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- واقع التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية.
- أهمية استشراف مستقبل جودة التعليم الأهلي.
- آليات تعزيز الجودة في التعليم الأهلي.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:
- لكي يمكن للتعليم الأهلي “ذو الجودة” أن يؤثر على التعليم الحكومي (على مستوى المدرسة)، فيمكن أن تتبنى الوزارة نشاطًا منظمًا يقوم على تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات للمدارس المجاورة بشكل دوري منتظم.
- على الوزارة أن تشجع جودة التعليم الأهلي من خلال شروط نوعية فيمن يملكون أو يشرفون على هذه المدارس، ليتمكن التربويون من الاستثمار فيها وتقليل حجم الاستثمار التجاري البحت، ومن هذه الشروط مثلا: ألا تقل شهادة من يشرف على المدرسة الأهلية (بكامل الصلاحيات المالية والإدارية) عن درجة الماجستير في أحد تخصصات التعليم مع خبرة عملية “قيادية” لا تقل عن عشر سنوات في التعليم، تكون حافلة بالعطاء، وتُوضع لذلك معايير واضحة ومحددة مع اجتياز تدريب أو شهادة معتمدة في إدارة المشاريع.
- أهمية تخصيص كل المدارس وتقوم الوزارة بثلاثة أمور: مواصفات المباني ومواصفات المدرس ومواصفات الكتاب.
- إنشاء هيئة حكومية للتعليم الأهلي، وتشمل رياض الأطفال ودور الحضانة، يكون دورها التنظيم والتشريع والرقابة.
- أهمية تفعيل الحوكمة وأيضًا دمج إدارة التعليم الأهلي مع الحكومي، وتطبيق ذات المعايير في التوجيه والرقابة والإشراف على كافة المدارس الحكومية والأهلية لتوحيد الجهود.
- الورقة الرئيسة: د. محمد الملحم
حتى 2020 يشــكل قطـاع التعليـم الأهلي بالمملكـة حصـة 10% مـن إجمالـي نشـاط التعليـم النظامـي (وزارة التعليم، 2022) وبحسب إحصائية نشرتها مكة نيوز فإنه بعد جائحـة كورونـا انخفضـت هذه النسبة بسبب تسـرب نسبة لا تقل عن 35% من طلاب المدارس الأهلية إلى المـدارس الحكوميـة، مما كبَّـد قطـاع التعليـم الأهلي خسـائر بلغـت قيمتهـا حوالـي 4.2 مليـار ريـال. وتقـدر إجمالـي مشاركة التعليـم الأهلي في هذا المجال بأكثـر مـن 30 مليـار ريـال، وهو ما ينعكس كتوفير لخزينة الدولة (صحيفة مكة نيوز الإلكترونية، 2021). وفيما يلي حقائق متنوعة حول التعليم الأهلي:
- عام 2017 أنفق المواطنون 7640 مليون ريال أي أكثر من 5 مليار ريال على الرسوم الدراسية التي يدفعونها لأبنائهم في التعليم الأهلي، ولا يشمل ذلك النقل المدرسي والذي وصل إلى قرابة 2 مليار ريال (الهيئة العامة للإحصاء، 2022).
- الزيادة السكانية التي تتخطى 3% سنويًا تؤدي بدورها إلى زيادة سنوية كبيرة في عدد منهم في سن التعليم العام، ومع الاتجاه نحو الخصخصة فإن هناك إقبالًا من رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال التعليم، حيث العائد مضمون ونسبة المخاطر في هذا المجال تكاد تكون صفرًا (الخضاري، 1441).
- الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن 29% من مباني مدارس الأهلية صُمِّمت لتكون مدارس، بينما 71% من هذه المدارس غير مناسبة للعمل التربوي في معظم الأحيان (الخضاري، 1441).
- بمقارنة التعليم الأهلي أمام الحكومي (دون النظر للأجنبي) فإنه وبحسب الإحصائية الوطنية لعام 2017 حقق نسبة 11% من مجموع التعليمين وعلى مستوى كل مرحلة يمثل طلاب المدارس الثانوية الأهلية 13% والمتوسطة 6% والابتدائية 9% ورياض الأطفال 54% والحضانة 69% (النسب محسوبة لكل مرحلة مستقلة: نسبة التعليم الأهلي بها إلى مجموع التعليمين الأهلي والحكومي) (الهيئة العامة للإحصاء، 2022). وهذه القيم تدل على أن للمرحلة الثانوية الأهلية جاذبية خاصة، وأن كلًا من رياض الأطفال والحضانة تشكو النقص الحاد في أعداد تلك الحكومية مقابل الأهلية.
وعلى الرغم من أن التعليم الأهلي يواجه تحديات وصعوبات ويناشد الوزارة باستمرار للاستماع إلى مطالبه، لتسهيل عمله، كما أن هناك مراقبين يطالبون أيضًا بأهمية وضع استراتيجيات طويلة الأمد لتنمية هذا القطاع (صحيفة عكاظ، 2021)، إلا أن غالبية هذه الجوانب كمية في المقام الأول، وتنظر إلى الجانب المادي، سواء فيما يخص نموذج الأعمال للتعليم الأهلي Business Model وضمان حيويته وبالتالي ضمان العطاء على المستوى الفردي لكل مؤسسة أهلية، أو في مجال الاهتمام بالقطاع عمومًا، للحفاظ على قيمته الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتظل هذه النظرة أيضًا نظرة كمية لا تهتم كثيرًا بالجانب النوعي، لذلك فهي غالبًا تحوم حول التشريعات والنظم التي تسهل عمل التعليم الأهلي.
أُوضِّح أولًا أن هذه الورقة لا تناقش هذه الجوانب الكمية، وإنما تحاول أن تطرح أهمية التعليم الأهلي في “تجويد” التعليم وممارساته في بلدنا، فمن المعروف عالميًا أن المدرسة الأهلية أو المدرسة الخاصة Private School هي رمز للجودة النوعية والتميز عن المدرسة الحكومية حتى في الدول المتقدمة تعليميًا، فعندما تقول إنك خريج مدرسة أهلية، فهو يعني أنك غالبًا متميز دراسيًا، لكن المعادلة نفسها لا تنطبق على مدارسنا الأهلية بالضرورة، فمع وجود مدارس أهلية غاية في الجودة والتميز، بل هي تنافس مدارس عالمية في مخرجاتها؛ إلا أنها لا تمثِّل غالبية المدارس الأهلية ولا حتى “أكثرها”، بل هي تظل أقلية معدودة معروفة بالأسماء في كل مدينة من المدن الكبيرة وفي المدن الصغيرة، فقد تكون مدرسة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. هذا الواقع يطرح تساؤلًا: إذن لماذا يستمر التعليم الأهلي عمومًا في الوجود طالما أنه لا يقدم جودة تعليمية عالية؟ والجواب له عدة تفرعات أولها أن هناك فئة من أولياء الأمور يحب أن يؤسس ابنه في مدرسة ابتدائية توفر له “الرعاية” فقط حتى يكبر قليلًا ويتعوَّد على جو المدرسة الحكومية، والذي قد يكون صعبًا عليه في بداية حياته صغيرًا، فيتحمل نفقات ثلاث أو ست سنوات ثم ينقله إلى مدرسة أخرى حكومية أو إلى المتوسطة الحكومية، وثانيها أن هناك فئة تضع أولادها في المدرسة الأهلية لقلة المدارس الحكومية الموثوق فيها في الحي أو الأحياء المجاورة وصعوبة توصيله أبنائه لمدارس حكومية جيدة بعيدة أو حتى عدم قبولها لهم بحكم النظام في توزيع الأحياء، وحيث يكثر التنمر وسوء معاملة المعلمين في المدارس الحكومية القريبة منه، فإنه يلجأ إلى المدرسة الأهلية، وثالثها فئة تأخذ أولادها للمدرسة الأهلية، اعتقادًا أنها الأفضل لأولادهم لضمان درجات عالية على الدوام، وهو ما تفهمه جيدًا تلك المدارس الأهلية وتقدمه على طبق من الذهب لهذه الفئة من أولياء الأمور “أو الزبائن في الواقع”، وتكثر هذه الظاهرة في المرحلة الثانوية على وجه الخصوص لأسباب معروفة. وفي الماضي كان هناك سبب رابع وهو توفر تدريس اللغة الإنجليزية والحاسب منذ صفوف مبكرة؛ ولكن تراجع تأثيره مؤخرًا بعد تدريس الإنجليزية في المدرسة الحكومية، وكذلك انتشار جهاز الحاسب لقلة ثمنه ووفرة الخبراء بتطبيقاته الشائعة.
بعيدًا عن هذا التشخيص الذي ليس هو هدف الورقة بقدر وضع مقدمة مهمة لشرح الواقع، فإن المسألة المطروحة تتناول جوانب مهمة في الجودة التعليمية قدمها التعليم الأهلي في بلدنا وتتساءل لماذا لا يستمر العطاء أو كيف يستمر وينتشر عبر المؤسسة التعليمية الحكومية كلها؟
أُولى هذه الجوانب هي المشاركة التاريخية المهمة للمدرسة الأهلية في تدريس اللغة الإنجليزية ثم الحاسب الآلي مبكرًا في الصفوف الابتدائية، حيث أثمرت هذه التجربة عن اقتناع الوزارة بتطبيق نفس التجربة (وإن كان بعد سنوات طوال!).
وثانيها ما قدَّمه نوع معين من المدارس الأهلية وهي تلك المتميزة تعليميًا (على قلتها) من عينات منافسة من الطلاب المتفوقين نتيجة رعايتها لهم واهتمامها بمعلميها، خاصة في مجال “التدريب على رأس العمل”، الأمر الذي انعكس على المؤسسة التعليمية الأكبر، فراحت تهتم بالجانب التدريبي للمعلمين وتشجع الممارسات الجيدة، كما أن المدارس الحكومية النشطة أصبحت تستفيد من جاراتها الأهلية وتتعلم منها وتنافسها، مما انعكس على حيوية تلك المدارس الحكومية الجيدة (على قلتها أيضًا).
وثالثها، البيئة المدرسية الجميلة والمريحة التي قدمتها تلك المدارس الأهلية، مما ساهم في تشجيع المؤسسة الحكومية على تطوير نماذج مبانيها.
رابعها: الاهتمام المبكر برياض الأطفال وتقديم مناهج متميزة ورائدة عالميًا مثل منهج منتسوري.
وهناك مظاهر أخرى متنوعة للجودة التعليمية لدى التعليم الأهلي “المتميز”، لا شك أنها جديرة بتحقيق قيمة مضافة لجودة التعليم في المملكة، وليس هدف هذه الورقة الإحاطة بها شموليًا وإنما إعطاء لمحات لما قدمه التعليم الأهلي، وما يمكن أن يقدمه مستقبلًا لصالح “جودة” التعليم العام لدينا، ومن هذا المنطلق تبرز الأسئلة التالية كملخص لما تستهدفه هذه الورقة:
- إلى أي مدى يمكن للتعليم الأهلي أن يؤثر على التعليم الحكومي (على مستوى المدرسة) من خلال “نشاط منظم” تتبناه وتشرف عليه الوزارة؟
- بالنسبة للفئة الشائعة من المدارس الأهلية المنتشرة في أغلب مدن المملكة والتي لا تزيد عن المدرسة الحكومية سوى في بيئتها الآمنة فقط وبعض الجوانب الشكلية الأخرى، فإلى أي مدى يمكن للجهات التعليمية (سواء الوزارة أو هيئة التقويم) أن تقدم مشروعًا تنمويًا لتحسين “جودة” التعليم الأهلي تقود فيه برنامجًا تحويليًا transformative ينقل هذه المدارس من واقعها الحالي “العادي” إلى مستوى يماثل أو يقارب المدارس الأهلية المتميزة أكاديميًا، لتضمن هذه الجهات الرسمية لأولياء الأمور أن استثماراتهم المالية في أبنائهم وُضِعت في مكانها الصحيح، كما تضمن هي أيضًا أن ذلك يمثل بالنسبة لها عمقًا “نوعيًا” باعتبار أن هذه المدارس تمثلها في نهاية الأمر.
- كيف يمكن للوزارة أن تشجع جودة التعليم الأهلي من خلال شروط نوعية فيمن يشرفون على هذه المدارس، ليتمكن التربويون من الاستثمار فيها وتقليل حجم الاستثمار التجاري البحت.
ويمكن طرح أسئلة موازية لهذه وتوصيات على نمطها لأجل الخروج برؤية حول مستقبل جودة التعليم العام في بلدنا من مدخل المدرسة الأهلية، ومع أنه لن يكون الحل الشامل (ولا يوجد حل شامل للقضية التعليمية بل هي عدة مداخل)؛ ولكنه مدخل مهم ومؤثر -لو أُحسِن استثماره- حسبما ترى هذه الورقة، مع الشكر للجميع.
مراجع
- الخضاري، محمد بن مترك (1441) التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية: ورقة عمل مقدمة ضمن مقرر دكتوراه (التعليم العام النظرية والتطبيق)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، https://www.academia.edu/41681394
- الهيئة العامة للإحصاء، 2022، https://www.stats.gov.sa/ar/903
- صحيفة عكاظ، 2021، https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2082914
- صحيفة مكة نيوز الإلكترونية، 2021، https://makkahnewspaper.com/article/1547551
- وزارة التعليم، 2022 وزارة التعليم | مؤشرات التعليم (moe.gov.sa)
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: د. زياد الحقيل
أولًا: جودة التعليم الأهلي القائم حالي
أذكر أنه عندما كنت عميدًا للقبول والتسجيل في جامعة الملك سعود في الفترة من 1995 – 2000 م كان هناك انطباع لدى البعض بانخفاض الجودة ورفع الدرجات لخريجي المدارس الأهلية. الأمر الذي دفع إلى إجراء دراسة إحصائية لمقارنة أداء طلاب المدارس الأهلية بنظرائهم من المدارس الحكومية، حيث إن الكم المتوفر من البيانات إلكترونيًا يُمكِّننا من عمل ذلك. وقد كانت النتيجة غريبة في التقارير الأولية، حيث كان أداء طلاب المدارس الأهلية أفضل. وبعد البحث اتضح أن السبب هو مقارنة أداء طلاب المدارس الأهلية الموجودة في مدينة الرياض مع جميع الطلاب القادمين من مختلف مناطق المملكة. فقمنا بعد ذلك بحصر الدراسة في مقارنة أداء طلاب المدارس الأهلية في شمال مدينة الرياض مع نظرائهم من المدارس الحكومية في شمال الرياض أيضًا، ولم نجد فرقًا يذكر في الأداء. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يوجد دليل واضح على انخفاض جودة التعليم في المدارس الأهلية مقارنة بالحكومية. كما أنها “في المعدل العام” ليست أفضل من الحكومية. وكنا نجد دائمًا طلابًا متفوقين جدًا من المدارس الحكومية والأهلية.
أحببت ذكر هذه النقطة ابتداءً لتأكيد أن الانطباعات السائدة ليست بالضرورة صحيحة، أقصد “الانطباع بأن المدارس الأهلية دون الحكومية تمنح الطلاب درجات أكثر مما يستحقون”.
ثانيًا: قياس جودة التعليم الأهلي
لاحظت أن كثيرًا من الطروحات عن جودة التعليم الأهلي تركز على القياسات الكمية. مثلًا درجات الثانوية، درجات اختبار القياس والتحصيلي، الدرجات في الجامعة. وهي بلا شك جوانب مهمة، لكنها ليست كل شيء. فهناك بُعد العلاقات والمهارات والثقافة وغيرها. وكم تمنيت وجود أدوات لقياس ذلك.
كما أرى أنه يمكن التوسع في الاستفادة من توفر معلومات الطلاب، في مدارسهم ونتائجهم في اختبارات القياس والتحصيلي ومن ثم في الجامعات، في إجراء دراسات كمية ومقارنة وتصنيف وترتيب جميع المدارس الحكومية والأهلية. وهذا النوع من التصنيف، مع ما عليه من مآخذ، قد يدفع المدارس بشكل عام إلى تجنب منح الدرجات بشكل زائد للطلاب. وهو أمر لوحظ في الولايات المتحدة من قبل.
ثالثًا: مدى المرونة المتاحة للتعليم الأهلي
بحكم تعاملي مع المدارس الأهلية كأب، وفي السابق كرئيس لشركة تملك شركة تعليمية قبل 10 سنوات، لاحظت أن أحد الجوانب التي تحتاج نظرًا وتأملًا هو طبيعة الإشراف التربوي من قبل وزارة التعليم على المدارس الأهلية. فهو في وجهة نظري إشراف ضمن قوالب تضمن قدرًا معينًا من ضبط الجودة، إلا أنه في نفس الوقت ربما سلب المرونة اللازمة للإبداع. فهو قد يكون مناسبًا للمدارس الأهلية متدنية أو متوسطة الإمكانيات وغير مناسب للمدارس الأهلية القوية ذات الرسوم المرتفعة والموارد البشرية والتجهيزات العالية.
وأرى أنه من المهم إعطاء المدارس الأهلية قدرًا من المرونة في أعمالها يتناسب مع حجمها وإمكانياتها، خاصة المدارس التي تنتمي لشبكة لديها إدارات للإشراف، وضبط ومراقبة الجودة والمخرجات. وربما تصنيف المدارس إلى فئات، فمن غير المعقول أن يكون للمدارس خيار اتباع المنهج الدولي أو ما يسمى العالمي، وهو يختلف كثيرًا عن المنهج السعودي، ولا يكون لها الخيار في التعديل ولو قليلًا على المنهج السعودي أو في الاختيار بين طرق تقديمه للطلاب، وربما أن إتاحة هذه المرونة ستشجع المدارس الأهلية المعتبرة على ابتكار طرق جديدة تأخذ طريقها للقبول والاعتماد المستقل عن الوزارة ومن ثم انتقالها لمدارس أخرى.
وهنا لا أقصد المرونة التي مارستها بعض المدارس الأهلية في إضافة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، إنما أقصد مرونة أكبر من ذلك، وعلى سبيل المثال اختيار كتاب مختلف لمنهج الرياضيات أو الفيزياء عن الكتاب المقرر من وزارة التعليم، أُسوة بما هو متاح في الجامعات. فلماذا يكون لنفس القسم في الجامعات، بل لأستاذ المقرر، حرية اختيار الكتاب وأسلوب تقديم المنهج. ولا يكون لإدارة مدرسة كبيرة وعريقة حرية هذا الاختيار، بضوابط قابلة للتطبيق. وأمر المرونة لا ينتهي عند اختيار الكتاب الذي ذكرته كمثال فقط.
وتذكرت هنا تجربة لمدارس حكومية في التسعينيات، أظنها في مدينة بوسطن، تابعتها عبر الراديو. حيث تم تأسيس مدارس ثانوية متخصصة بمجالات مختلفة Theme schools. الرياضة، الرسم، الرياضيات، الفضاء … إلخ. وهي تُعنى بنفس أهداف التعليم الثانوي؛ لكن مع تركيز إضافي على اهتمام معين داخل الصف وخارج الصف في الأنشطة الطلابية. هذا التركيز جلب طلابًا مهتمين لتلك المدارس من مناطق مختلفة من المدينة (مع بعض التحديات في النقل)، وكانت نتيجته انخراطًا للطلاب بشكل أفضل في العملية التعليمية والتربوية، كما سمعت عن تجارب وممارسات أخرى، وربما أن هذه المرونة المتاحة للمدارس “للتجريب في بضع مدارس” في الدول المتقدمة هي أحد العوامل في تقدم التعليم لديهم، ولعل هذا يدخل ضمن ما قصده د. محمد في ورقته.
رابعًا: القيود الموضوعة على المدارس الأهلية في التوظيف
تعاني المدارس الأهلية -فيما أذكر- من صعوبة استقطاب المعلمين السعوديين المؤهلين بشكل جيد والمحافظة عليهم، وذلك لتدني الرواتب من جهة ولرغبة المعلمين في الوظيفة الحكومية من جهة أخرى، ومن وجهة نظري أن شروط السعودة في قطاع التعليم الأهلي تم تطبيقها بشكل مبكر وقبل توفر الظروف الملائمة، وهي تحتاج مزيدًا من الحوافز. وأقلها أن تدفع الدولة للمدارس دعمًا معتبرًا عن كل طالب يدرس فيها، يُمكِّنها من استقطاب معلمين وتوفير إمكانيات مناسبة. مثلًا خُمس أو سُدس التكلفة (الكلية وليس التشغيلية فقط) للطالب في المدارس الحكومية، ومع تفعيل اختبارات القياس للمعلمين، أو السماح بتوظيف غير السعوديين المؤهلين بشكل جيد، حيث إن السعودة لا ينبغي أن تكون على حساب جودة التعليم، وأشك أن لدى الدول المتقدمة قيودًا على المدارس الأهلية في جنسية المعلمين.
خامسًا: المركزية
قد يكون هذا خارج نطاق الورقة، لكنني أجد أنه من المهم الإشارة إليه، فالإبداع والتطوير يتطلب قدرًا من المرونة والتجريب، وأسلوب الإشراف المركزي يقيد ذلك، فلماذا لا يكون لدينا مناطق تعليمية مستقلة بقرارها ضمن إطار وأهداف تعليمية أُسوة بما هو ممارَس في العديد من الدول المتقدمة، وهذه المرونة ستنعكس على مرونةٍ في إدارة وتوجيه المدارس الأهلية بحسب طبيعة كل منطقة تعليمية وظروفها وبالتعاون مع الجامعات في تلك المناطق. وربما أوجدت قدرًا من المنافسة ومناخًا محفزًا للبحث والتطوير، وربما أبدعت إحدى المناطق في تطوير مناهج أو كتب تستفيد منها مناطق أخرى، وربما أبدعت بعض المناطق في تطوير مناهج تناسب طبيعتها وتوجهات التنمية لها، كتلك الموجودة على ساحل البحر الأحمر على سبيل المثال.
- التعقيب الثاني: د. ناصر الملحم
برغم الإنجازات الكبيرة والنتائج الإيجابية التي تحققت لعدد من المدارس الأهلية والعالمية في المملكة العربية السعودية، إلا أن ذلك لا يعكس مستوى الأداء التعليمي لدى شريحة كبيرة من مدارسها، وفي ضوء ذلك ومع التنامي الكبير في أعدادها تبرز الحاجة إلى وجود نظام لتقويم أداء تلك المدارس واعتمادها، بهدف تجويد التعليم وتحسين مخرجاته وتوفير البيانات الموثوقة التي تساعد أولياء الأمور وصانعي السياسات التعليمية على اتخاذ القرارات المناسبة لأبنائنا.
التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية
يُعد قطاع التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية – الذي نشأ مبكرًا قبل التعليم الحكومي والنظامي – أحد أهم قطاعات التعليم العام، ونصّت على ذلك سياسة التعليم في المملكة (1416، ص32) وفي ضوء ذلك صدرت العديد من اللوائح التي تدعم التعليم الأهلي، ومنها لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) بتاريخ 13/8/1395هـ، ولائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4/2/1418هـ.
الوضع الراهن للتعليم الأهلي:
| العام الدراسي | عدد طلاب المدارس الأهلية | عدد طلاب المدارس الأجنبية | المجموع | عدد طلاب المدارس الحكومية | المجموع الكلي | نسبة المشاركة |
| 1436/1437هـ | 711625 | 325015 | 1036640 | 5108799 | 6145439 | 87,16% |
| 1437/1438هـ | 741032 | 378358 | 1119390 | 5089616 | 6209006 | 03,18% |
| 1438/1439هـ | 686910 | 375089 | 1061999 | 5201668 | 6263667 | 95,16% |
| 1439/1440هـ | 646409 | 308259 | 954668 | 5154727 | 6109395 | 63,15% |
| 1441هـ | 690552 | 388871 | 1079423 | 5258770 | 6338193 | 03,17% |
| 1443 هـ | 467065 | 346550 | 813.615 |
والمتتبع لواقع النمو في قطاع التعليم العام الأهلي في المملكة العربية السعودية يجد أن هنالك تفاوتًا في النمو في القطاع، وذلك في ظل تذبذب الإقبال على الالتحاق بالمدارس الأهلية والعالمية، ويوضح الجدول الآتي الإحصائيات الخاصة بالنمو في القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة:
* (وزارة التعليم، وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير- مركز إحصاءات التعليم ودعم القرار، 1441هـ)
مساهمة التعليم الأهلي في تحقيق أهداف الرؤية:
تتبنى المملكة العربية السعودية رؤية واعدة وخطة اقتصادية إصلاحية، تعتزم فيها تنويع وارادتها وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية وخاصة قطاع التعليم من خلال رؤية 2030؛ إذ تهدف إلى تشجيع وتمكين الاستثمار في المدارس الأهلية خاصة مرحلة رياض الأطفال.
وقد أشار تقرير الهيئة العامة للاستثمار الربعي (2019) إلى أن حجم سوق التعليم في المملكة يقدر بنحو 37.2 مليار دولار (139.5 مليار ريال)، حيث يمثِّل قطاع التعليم في المملكة أكبر بند في الميزانية المالية العامة؛ وتعادل قيمته 80% من مجموع نفقات التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019. كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم العام الأهلي (1,3) مليار ريال وفقًا لتقرير إنجازات جذب وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب (الهيئة العامة للاستثمار، 2018).
التوجه للبرامج الدولية والمدارس العالمية:
وفقًا للإحصاءات التي أعلنتها هيئة المدارس العالمية، يُظهِر أولياء الأمور توجهًا وميلًا متزايدًا إلى تسجيل أبنائهم في البرامج الدولية أو المدارس العالمية؛ إذ نمت حصة البرامج الدولية والمدارس العالمية في دول المنطقة نموًا استثنائيًا خلال السنوات العشر الماضية بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص؛ حيث ارتفع عدد المدارس من 8,067 في يناير عام 2012 إلى 12,853 في عام 2022م بنسبة نمو 59%، وارتفع عدد الطلاب خلال الفترة ذاتها بنسبة 54% من 3.72 مليون إلى 5.73 مليون طالب، كما حقق كادر الهيئة التعليمية والإدارية نسبة نمو قدرها 61% مرتفعًا من 345,972 إلى 557,723 موظفًا، ولتقدير ضخامة هذا النمو من جانب اقتصادي، فقد ارتفع حجم دخل المدارس من الرسوم الدراسية فقط من 27.4 مليار دولار إلى 53.5 مليار دولار ( 200.6 مليار ريال سعودي) بنسبة نمو قدرها 96%.(ISC Research 2022)
ورغم أن دخول المدارس العالمية والبرامج الدولية الموجهة للطلبة السعوديين في المملكة العربية السعودية جاء متأخرًا في عام 2007 م، إلا أنها سرعان ما حلت في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات في عدد المدارس التي بلغت 292 مدرسة و319 ألف طالب في عام 2021 كأسرع الدول نموًا في المدارس العالمية.
مساهمة التعليم الأهلي في تحسين الجودة التعليمية:
تتنوع مساهمات التعليم الأهلي في تحسين جودة التعليم، والقائمة في ذلك تطول ومن ذلك:
- المشاركة في تجويد تنفيذ عدد من البرامج التعليمية الجديدة كما توضحه نماذج مثل:
- تطبيق التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية.
- تطبيق نظام المقررات في المرحلة الثانوية.
- الأخذ بمبادرات بدأت في المدارس الأهلية وأثبتت نجاحها وتبنتها لاحقًا وزارة التعليم مثل:
- تدريس الصفوف الدنيا ضمن المرحلة الابتدائية للبنات.
- تدريس اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي لجميع الصفوف.
- كما تتمثل في برامج إثرائية مثل:
- تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.
- تدريس رياضيات سنغافورة ومادة الإلكترونيات وبرامج ريادة الأعمال.
- وتطبيق الاعتماد المدرسي الدولي.
وغيرها الكثير.
ولذا فلا غرابة أن يحقق طلاب التعليم الأهلي والعالمي مستويات أعلى من قرنائهم في المدارس الحكومية في الاختبارات الوطنية والدولية والقدرات والتحصيلي والمنافسات العلمية الدولية.
التقويم والاعتماد المدرسي كمحفز للجودة التعليمية:
في ضوء نمو قطاع التعليم الأهلي والدولي ووجود الحاجة إلى توفير بيانات دقيقة عن مستوى أداء المدارس الأهلية والحكومية ولمساعدة هذه المؤسسات في تحسين جودة أدائها تأسست في الكثير من الدول هيئات مستقلة حكومية أو أهلية لتقويم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ذات استقلالية تامة عن وزارات التعليم، بعضها تغطي المدارس الحكومية والأهلية، وبعضها موجه للمدارس الأهلية، وبعضها موجه لاعتماد المدارس الخاصة أو المستقلة، وتهدف هذه الهيئات إلى تقديم تقارير مستقلة عن مستوى أداء المؤسسات التعليمية تساعد قطاعات واسعة بدءًا من صانعي السياسات التعليمية وأصحاب القرارات التنفيذية في وزارات التعليم إلى أولياء أمور الطلاب على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية أو بتعليم أبنائهم، وأصبحت هذه الكيانات من الممارسات التعليمية التي أثبتت كفاءتها ومن أمثلة هذه المؤسسات :
- هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والتي تمت إعادة تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 108 في عام 1440هـ لتكون الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما.
- هيئة جودة التعليم والتدريب في دولة البحرين والتي تأسست عام 2008م بهدف مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
- هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والتي تتولى مسؤولية الارتقاء بجودة التعليم الخاص في دبي، وهيئة دائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي.
- هيئات الاعتماد المؤسسي في الولايات المتحدة، ومنها الهيئات الإقليمية الخمس، ومن أشهر الهيئات المتعلقة بالمدارس الخاصة المنظمة الوطنية للمدارس المستقلة National Association of Independent Schools
- مكتب المعايير في التعليم OFSTED في بريطانيا، وهي أشهر هيئات التقويم المدرسي الحكومية على مستوى العالم.
- رابطة المدارس الدولية (CIS) وتعد الأشهر على المستوى العالمي.
ولا يتسع المقال لذكر الكثير من هذه النماذج.
الاعتماد المدرسي في المملكة العربية السعودية
بموجب قرار مجلس الوزراء أصبحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز) الجهة المسؤولة عن تقويم الأداء المدرسي، كما تأسست فيه الإدارة العامة للاعتماد المدرسي عام 2020م لتكون الجهة المسؤولة عن تقويم واعتماد المدارس الأهلية والعالمية لرفع جودتها وتحسين مخرجاتها التعليمية، ومن أبرز البرامج التي تقوم بها الإدارة العامة للاعتماد المدرسي:
- برنامج الاعتماد الوطني: والذي يتم تنفيذه مباشرة من هيئة تقويم التعليم.
- برنامج الاعتماد الدولي: من خلال تنظيم عمل الجهات الأجنبية المانحة للاعتماد وترخيصها في المملكة العربية السعودية.
الاعتماد المدرسي الوطني:
تتولى الهيئة إدارة وتنفيذ كافة مهام الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية بالتنسيق مع وزارة التعليم، من خلال إعداد كل ما يرتبط به من أطر ولوائح وأدلة للسياسات والإجراءات، كما تصدر من خلال تنفيذ إجراءات الاعتماد قرارات الاعتماد أو تجديده أو حجبه، وترصد بانتظام مستويات التحسن في الأداء المدرسي ونواتج التعلّم، وتُعِد التقارير اللازمة لنشر النتائج ومقارنتها مع التقويمات الوطنية والدولية. ومن أبرز ملامح برنامج الاعتماد الوطني:
- تقويم واعتماد مبني على فلسفة التحسين المستمر، ويهدف إلى التحسين والتطوير بالدرجة الأولى، وإن كان يتضمن المساءلة.
- تقويم اختياري في المرحلة الأولى ثم سينظر في جعله إلزاميا ًلجميع المدارس الأهلية والعالمية.
- تقويم مبني على المعايير في أربعة مجالات: (القيادة – والتعليم والتعلم -ونواتج التعلم -والبيئة المدرسية).
- اعتماد مبني على النتائج Outcome Based Accreditation من خلال التركيز على نواتج التعلم بوزن نسبي يصل إلى 50%.
- الاستفادة من نتائج الاختبارات الوطنية في مواد القراءة والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر، لتعكس مدى تحقق معايير نواتج التعلم في الإنجاز التعليمي لتكون أكثر صدقًا.
- تطوير منصة تقنية مؤتمتة بالكامل تتم من خلالها عمليتا التقويم الذاتي للمدرسة ثم التقويم الخارجي، بما فيها تحليل البيانات والتغذية الراجعة لتقليل الفوارق البشرية.
- تطوير برنامج تأهيل لأخصائي التقويم والاعتماد بمن فيهم غير السعوديين من ذوي الخبرة في المدارس الأهلية والعالمية ومن ثنائيي اللغة.
وتم إطلاق مشروع الاعتماد المدرسي بالشراكة مع وزارة التعليم بدءًا بنشر ثقافة الاعتماد وتوقيع اتفاقيات مع العديد من الشركات التعليمية خلال العامين الماضيين، والمخطط أن تُطلَق بوابة التقويم الذاتي مع بدء العام الدراسي 1443هـ ثم التقويم الخارجي واعتماد المدارس.
ومن المؤمل أن يسهم في رفع كفاءة وجودة المدارس الأهلية والعالمية وتحسين مخرجاتها، كما يؤمل أن يسهم من خلال توأمته مع نظام التقويم المدرسي للمدارس في نشر الممارسات الجيدة والذي تعتزم الهيئة أن يكون منصة لاستفادة المدارس الحكومية والأهلية.
- المداخلات حول القضية
- واقع التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية
لقد انتشرت المدارس الأهلية الخاصة في السنوات الأخيرة بشكل لافت وغير صحي، إذ باتت تُمثِّل خيارًا جيِّدًا لدى كثير من المستثمرين، بعد أن أصبحت العديد من الأسر حريصة على تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة؛ بحثًا عن رفع مستواهم الدراسي عبر حصولهم على تعليم جيِّد في بعض الأحيان، وفي جوانب أخرى الحرص على أعلى الدرجات لدى بعض المدارس التي تهدف للمال ولا تبحث عن المستوى ، حتى إنْ صاحَبَ ذلك دفع مبالغ مالية كبيرة في السنة الواحدة، في الوقت الذي باتت فيه الرسوم الدراسية تصل في بعض المدارس إلى (40) ألف ريال في العام الدراسي الواحد، وربما أكثر من ذلك، فكلَّما تميزت المدرسة فيما تقدمه من إمكانات، كان هناك ارتفاع في أسعار رسومها الدراسية، وبالرغم من ذلك فإنَّ العديد من الطلاب والطالبات باتوا يتسربون من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، نظرًا لمرونتها وسهولة التسيب بها، والحصول على الدرجات دون جهد، وينطبق ذلك على بعض الجامعات الخاصة للأسف الشديد، رغم الجهود الوزارية المبذولة لضبط ذلك التسيب.
وفي مقابل ذلك وجد المعلمون في المدارس الخاصة فرصة وظيفية تحمل طابع تخصصهم الذي يحبون أن يعملون به، خاصةً أن التوظيف في هذه المدارس والجامعات قائم على المقابلة الشخصية والتجربة الزمنية التي ستقرر مدى قبولهم من عدمه، ورغم مرور سنوات طويلة على تجربة التعليم الخاص في المملكة، إلاَّ أن هناك جدلًا قائمًا حول وجود العديد من الجوانب السلبيَّة في هذا النوع من التعليم مرتفع التكاليف، وهناك من يرى أن قرار رفع رواتب المعلمين الذين يعملون في القطاع الخاص ربَّما حسَّن من أوضاعهم، بَيْد أنَّه لا تزال هناك كثير من الإشكالات القائمة في قطاع التعليم الخاص، إذ تؤكد الدراسات القائمة محليًا أنَّه لم يُقدَّم بجودة عالية، كما أنَّه إنْ حدث ذلك فإنَّه يتم بشكل محدود جدًا، حتى بات كثير من المعلمين في هذا القطاع يحاولون البحث بشكلٍ دائم عن فرصة بديلة في مكان آخر.
ويُعاني التعليم الأهلي من مشكلات كثيرة ومتعددة، أهمها تدني مستوى الجودة، نتيجةً لسياسات بعض المدارس التي تبحث عن المعلم الأقل تكلفة مادية وليس الأكفأ علميًا وتربويًا، كذلك أساليب وطرق التدريس المتبعة، تعتمد على أساليب مرنة وميسرة ومحببة للطلاب، وليس الطرق والأساليب التي تُقدِّم التعليم الأفضل، إضافةً إلى نسبة الغياب المرتفعة من الطلاب نتيجة عدم الحزم والجدية في المحاسبة.
كما أن طرق التدريس المتبعة تعتمد على أساليب مرنة؛ ولكنها لا تقدم الأفضل علميًا، والنتائج أكبر دليل على ذلك والتي تكون بنسب عالية جدًا مقارنةً بالتعليم الحكومي.
وفي تصور البعض فإن مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمة التعليم العام تبدو مرتفعة نسبيًا في المملكة العربية السعودية، إذا ما قورنت بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية والشمالية. في الولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثال- لا يصل القيد في المدارس المستقلة والمدارس الدينية إلى 8%، والنسب أقل في بريطانيا، وفي دول أوروبا الغربية. نعم هناك في أوروبا نماذج محاكاة السوق (quasi market)، التي تأخذ روح التنافس من الخصخصة، بربط تمويل المدارس جزئيًا بجودتها، لكنها ليست خصخصة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مدارس التفويض، وهي مدارس حكومية يديرها القطاع الخاص، فهي خصخصة إدارة فقط، فلا تعد مدارس خاصة مناظرة للمدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية. في أستراليا تتجاوز نسبة المدارس الخاصة 30%، وهي إما مدارس مستقلة أو دينية، وهي كلها مدعومة ماليًا من الحكومة الأسترالية، خاصة المدارس الدينية.
وتتبنى العديد من المدارس الأهلية بعض البرامج التي تنمي شخصية الطالب من كل الجوانب، فبالإضافة إلى مهارات التعلم الذاتي تنمي مهارات التفكير والتواصل والابتكار، وتنهج عدد من المدارس التقويم المبني على المشاريع وبرامج ريادة الأعمال حتى في سن مبكرة، وهذا ما يشكل التعلم الاصيل أو الحقيقي الذي يماثل إلى حدٍّ ما الخبرات الحقيقية خارج المدرسة، وكل ذلك يسهم في تطور شخصية الطالب ومقدرته على الإسهام في تنمية المجتمع، وهذا ما يميز النظام الأمريكي الذي يتميز بمرونته وقدرته على تبني البرامج النابعة من حاجات التلاميذ.
وتمثل نواتج التعلم إحدى المجالات الأربعة في نظام التقويم والاعتماد المدرسي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وفي الأنموذج الذي تبنته الهيئة في الاعتماد المبني على المخرجات (Outcome Based Accreditation ) شكَّل هذا المجال وزنًا نسبيًا أعلى من كل المجالات وهو مقسم إلى معيارين رئيسين :
- الإنجاز التعليمي وسيتم قياسه من خلال نتائج الاختبارات الوطنية (نافس)، ولا سيما في التقويم الخارجي، وقد يُسمح للمدارس في التقويم الذاتي فقط باستخدام الاختبارات التكوينية لقياس هذا المعيار.
- الثاني النمو الشخصي للطالب، ويقاس من خلال أدوات متنوعة كالاستبانات والمقابلات ودراسة الوثائق والملاحظة الصفية.
وتعتزم الهيئة بعد تجربتها الموسعة في الاختبارات الوطنية (نافس) تنفيذها على أساس سنوي -بإذن الله- وستكون نتائجها كنزًا ثمينًا من البيانات على المستوى المدرسي وعلى المستويات جميعها ومنها المستوى الوطني.
وفي تصور البعض فإن التعليم الأهلي يأتي في فئتين: ربحي خالص، وربحي تربوي. وبالتركيز فقط على الأول الذي يمكن معرفته من مباني مدارسه التي لا تصلح كبيئة تعليمية، ويضم معلمين يعملون برواتب ضئيلة تغطي المدرسة ضآلتها بدروس خصوصية، وخدمات أخرى كدروس تقوية مدفوعة، ورحلات طلابية بمقابل ومقصف مدرسي بائس لا يراعي الشروط الصحية في الوجبات التي يقدمها لتلاميذه.
وتؤسس مدارس هذا النوع عادة شريحة يمكن تسميتهم “متسببين”، وهم من صغار رجال الأعمال، وأحيانًا بعض العقاريين وتجار الأراضي الذين لم يجدوا أفضل من المدارس الخاصة، وسيلة للتربح والاسترزاق بصرف النظر عن نوع التعليم الذي يقدمونه وبيئته. ولإدارة المدرسة يستقطبون مدراء مدارس متقاعدين مع مراعاة شروط السعودة وذلك كيفما اتفق.
هذا النوع من المدارس والتعليم الذي يقدمه وبال على العملية التعليمية برمتها بل ومضر للغاية؛ لأنه يخرج “تنابلة”، فقط لأنهم يدفعون رسومهم بانتظام.
والكارثة أنه يخرّج طلاب الثالث ثانوي حتى لو كانت مستوياتهم متدنية، وهو يفعل ذلك بسبب رغبة الأهالي في حصول أبنائهم على الشهادة الثانوية، لكي يلتحقوا بالجامعات حتى لو لم يكونوا مهيئين للتعليم العالي.
وقد يكون لدينا ندرة في المدارس التي تجعل الطالب يحب التعليم، فالدافعية للتعلم وحبه لها عناصر كثيرة منها الدافعية الطبيعية في الطالب نفسه والتي قد يقتلها النظام التعليمي للأسف بمفرداته المختلفة. فمما يلفت النظر جاذبية المدارس في الكثير من الدول ذات النظم التعليمية الأكثر خبرة؛ ولكن حتى مع النظم التعليمية الأكثر صرامة، كما هو الحال في الشرق الآسيوي تبرز نظرة المجتمع نحو أهمية وتأثير التعليم على حياة الطالب والتي تعكسها الكثير من المؤثرات المجتمعية في الأسرة ووسائل الإعلام والمدرسة ذاتها، وكل ذلك يبدأ في مراحل مبكرة من العمر في مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، والذي للأسف لا تزال نسبة الملتحقين به في المملكة العربية السعودية دون المعدل العالمي بكثير، ولذا فإن من أهداف رؤية المملكة رفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال لتقترب من المعدلات العالمية.
لم نستطع حتى الآن وبعد انتشار المدارس الأهلية في المملكة أن نلمس اختلافًا في مستوى جودة التعليم والاستثمار في الإنسان، ويبدو أن هناك قصورًا واضحًا في المراقبة على أداء المدارس الأهلية، التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في الأحياء السكنية وبين الحواري الشعبية وفي بيوت مستأجرة، فأي مستثمر يرغب في زيادة دخله يضع ماله في مشروع مدرسة أهلية، والسؤال المهم هنا: لماذا لا تعمل وزارة التعليم على وضع ضوابط صارمة لتصنيف مستوى المدارس الأهلية من حيث جودة الخدمات المقدمة؟!
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم سعت وتسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات والمعايير لتصنيف المدارس الأهلية على فئات (أ، و ب، …)، ولكن مع التوسع في قبول السعوديين في البرامج والمدارس العالمية في برامج متنوعة كالدبلوم الأمريكي، والنظام البريطاني، والبكالوريا الدولية، وغيرها ازدادت الحاجة إلى تقييم أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، ولذا فالوزارة تعمل بالشراكة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب وفي ضوء برنامج تصنيف المدارس (ضمن مبادرة تنمية الموارد البشرية في رؤية المملكة 2030) على توفير اعتماد وطني يلبي التوقعات ويرفع من جودة التعليم، كما تم إطلاق مسار لتنظيم عمل جهات الاعتماد الدولية التي تعمل في المملكة بمستويات متباينة وترخيص جهات الاعتماد الدولية الأكثر فاعلية. ومن المؤمل أن ينطلق هذان البرنامجان مع بداية العام الدراسي 1444هـ.
- أهمية استشراف مستقبل جودة التعليم الأهلي.
إن استشراف مستقبل جودة التعليم يُعد ضرورة حتمية، تتطلب من دول العالم مضاعفة الاستعداد لكافة مستجدات التعليم وتغيّراته”، بالإضافة إلى أن التعليم حاليًا يُواجه تحديات غير مسبوقة، أبرزها ضمان التعافي من آثار جائحة كورونا ولعل أبرزها الفاقد التعليمي، والتسارع نحو عجلة التطوّر المعرفي والتكنولوجي؛ إضافة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية.!!
إن تحسين جودة مخرجات نظام التعليم في مدارس القطاع الخاص بما يتناسب وبناء الإنسان الواعي والمتعلم والمتفاعل مع قضايا مجتمعه ومحيطه العالمي الواسع، وملاءمته مع متطلبات سوق العمل يعتبر هدفًا أساسيًا؛ لذا من المهم معرفة ما مدى تطبيق معايير الجودة في هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان الحصول على مخرجات تواكب متطلبات العصر.
وقد تختلف وجهات النظر حول مفهوم ضمان جودة التعليم في هذا القطاع؛ كونه مفهومًا واسعًا، إلا أن الجميع لا بد أن يتفق على أن هذا المفهوم يركز على أنظمة تعليمية تساعد على مخرجات معتزة بهويتها، ملتزمة بقيم المجتمع، مخرجات تتسم بالإبداع والابتكار من خلال عمليتي التعليم والتعلم الشامل والمستدام، وتشمل جميع الأنشطة والإجراءات والعمليات لقياس امتثال النظام التعليمي في هذه المدارس، وأن يتم تصنيفها وفقًا للمواصفات أو المعايير المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أعدت ثمانية أهداف استراتيجية في مجال التعليم لتحقيق ستة أهداف وضعتها رؤية المملكة 2030 وجاء الهدف الثامن من أهداف الاستراتيجية: مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم، ولضبط فاعلية الأثر المتوقع لتحقيق هذا الهدف حددت وزارة التعليم مؤشر الأداء بنسبة التحاق 25%..
ولم يغب موضوع جودة التعليم عن وزارة التعليم منذ بدأ التركيز على الكيف في العملية التعليمية بعد أن أنهت الوزارة عملية الكم من انتشار التعليم في كافة أرجاء المملكة المترامية الأطراف وقفل منابع الأمية، ولقد تزامن ذلك مع اعتماد مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وتوفير الدعم المالي اللازم، ومن ثم إنشاء هيئة تقييم التعليم العام ثم إنشاء شركة تطوير التعليم وشركاتها الفرعية لتخصيص الكثير من المهام التي كانت تقوم بها الوزارة.
وأيضًا مع تزامن موافقة المقام السامي على إعداد دراسة عن موضوع خصخصة التعليم العام التي من توصياتها إعداد – استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام – بالتعاون مع شركة استشارية عالمية، حيث تضمنت في الاستراتيجية في أحد محاورها -المدارس الأهلية – وتضمنت أهدافها الآتي:
- تعزيز الإطار التنظيمي وتوضيح المسؤوليات للمدارس الأهلية، وكان من ضمن مشروعاتها تطوير معايير وآليات ومراقبة الجودة، بما في ذلك وضع آليات وأنظمة قياس على مستوى المملكة، ومن هنا تم تأسيس هيئة تقييم التعليم العام ووضع جدول زمني لتطبيق المعايير وانظمة القياس.
- تشجيع الالتحاق بالتعليم الأهلي، حيث طَرحت الاستراتيجية نظام الدعم الحكومي من خلال القسائم لتحفيز القطاع الخاص أسوة بالدعم الذي تم للكليات والجامعات الأهلية.
- تشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمات التعليم من خلال إنشاء شركات تعليمية كبرى ذات مهنية وخبرة واعتماد نموذجFranchise بحيث تقوم هذه الشركات بتقديم الدعم والتطوير والرقابة على المدارس الصغيرة.
- تشجيع الكوادر الوطنية على العمل والاستقرار في قطاع التعليم الأهلي من عدة مشروعات من أهمها قيام صندوق الموارد البشرية بدعم رواتب المعلمين وتوحيد ساعات العمل بين معلمي القطاع الحكومي والأهلي وسهولة الانتقال للمعلمين بين القطاعين.
- وضع خطة شاملة للتغطية الجغرافية للتعليم الأهلي Master Plan ووضع آليات التنفيذ باعتبار المدارس الأهلية عنصرًا مكملًا للمدارس الحكومية.
ولقد وُضِعت خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية من ثلاث مراحل رئيسية:
- مرحلة بناء القدرات من 2-3 سنوات.
- مرحلة المراقبة والتقييم والمراجعة من 2-3 سنوات.
- مرحلة النمو والمتابعة من 2-3 سنوات.
وكل مرحلة تتكوَّن من عدة بنود. كما أُعِدت استراتيجية أخرى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائية.
- آليات تعزيز الجودة في التعليم الأهلي.
أكدت بعض وجهات النظر فيما يتعلق بآليات تعزيز الجودة في التعليم الأهلي على ما يلي:
- إعطاء المرونة في النظام التعليمي مهم للغاية في إبداع وتميز المدارس، سواء كانت حكومية أو أهلية، وهي بالتأكيد أكثر أهمية في الأخيرة.
- كلما تميزت الدولة باللامركزية التعليمية وسمحت للمدارس بقدر من المرونة، كلما كانت الحاجة إلى المدارس الأهلية أقل.
- عند التوجه إلى منح المرونة الكافية للمدارس الحكومية والأهلية، لا بد من وجود أنظمة تقويم ومساءلة على المدارس بنوعيها: وليس شرطًا أن تكون مساءلةً وتقويمًا حكوميًا، بل إن الهيئات العلمية والتربوية المستقلة من مثل أنظمة الاعتماد المدرسي في الولايات المتحدة، وكذلك المساءلة المدنية وانخراط أولياء الأمور ومشاركتهم في مجالس الإدارات وصنع القرار هي في مجملها مساهمة مجتمعية ومدنية.
وبالعودة إلى تجربتنا التعليمية في المملكة تزداد الحاجة إلى أنظمة مراقبة وتقويم مدرسي مستقل في ضوء ازدياد أعداد المدارس الأهلية والعالمية. وهذا ما يمكن أن تقوم به هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال التقويم والاعتماد المدرسي لضمان وضبط جودة مخرجاتها التعليمية.
وثمة ضرورة لوضع مقاييس ومواصفات عالية للمدارس الخاصة مبنى ومنهج ومعلم وإدارة ونقل، لكن هيهات يحصل ذلك طالما كانت المدارس الحكومية مكتظة بالتلاميذ، وطالما كان بعض القائمين على هذه المدارس الخاصة موظفين في القطاع العام، لكنهم سجلوا هذه المدارس بأسماء زوجاتهم وحمواتهم.
ومع الوضع في الاعتبار أن الدافعية نحو التعلم هي العنصر الأهم من عناصر الإنجاز التعليمي والتطور الشخصي للطالب، وهي نتيجة تراكمية لعوامل ذاتية وخارجية؛ لذا فمن المهم للمدرسة للتقليل من تأثيرها أن تُعزِّز جاذبية التعليم والتعلم والتنوع في أساليبه وبرامجه؛ فالتحدي الحقيقي أمام أي مؤسسة تعليمية هو كيف تجعل الطلاب يشعرون أن التعليم وليس فقط الشهادة يصنع فارقًا في حياتهم.
وفي الجانب الآخر فإنه لتعزيز الجودة في التعليم الأهلي ينبغي أن يكون هناك نظامًا لتقويم المؤسسات التعليمية واعتمادها، سواء في التعليم العام أو العالي يساعد أصحاب القرار وجميع المستفيدين ومنهم أولياء الأمور على اختيار المؤسسات التعليمية الأفضل لأبنائهم، وهذا ما تعمل عليه الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم وهو أحد محاور رؤية 2030 في مبادرة تنمية القدرات البشرية.
وقد يكون أحد أهم العناصر هو التركيز على اكتساب المعلومة (حفظها وتذكرها) أكثر من الوصول لها تجريبيًا أو بالبحث؛ الأمر الذي يعزز الشعور بالكفاءة لدى الطالب وينمي الدافعية للتعلم.
وثمة آراء تذهب إلى أن المدارس الأهلية والكليات الجامعية يجب أن تكون لا ربحية أو أن الشريك الأساس (المسيطر) فيها جهة لا ربحية أو المعلمين مثلًا.. ويصعب تصور تعليم أولي وعام يعمل على أسس تجارية بحتة يُقصَد منه الربحية التي تزيد أو تعتمد على أهم عنصر وهو نوعية المعلم وتخفيض قيمة التشغيل. فهناك تناقض صارم وواضح بين التعليم ومراقبة النوعية فيه والروح والرسالة خلفه ومحركات الذمة فيه، فضلًا عن التميز من جهة والربحية على أساس الاتجار بالمعلمين والتعليم والأبناء وتقدير الكفاءة من جهة أخرى. وبمراجعة تاريخية عميقة لبدايات التعليم السعودي أيام الملك عبد العزيز الذي بدأ أهليًا ثم تحول حكوميًا، نجد أنه كانت مؤشراته الإدارية والهيكلية خيرية أو لا ربحية، وكون الدولة حولت التعليم من أهلي لحكومي بالتدريج، كان على أساس أن التعليم ليس تجارة وليس مجالًا للاتجار به.
وجودة التعليم الذي نسعى إلى تحقيقه في القطاع الأهلي، يمكن قياسها وفق مؤشرات بناءً على الأداء الفعلي والممارسات التطبيقية. وهذا لن يتم إلا من خلال تطبيق منظومة الأداء الفردي والإجادة المؤسسية لكل مدرسة أهلية، على أن تكون آلية تطبيقها تتم بمتابعة وإشراف كل من وزارة التعليم والموارد البشرية. وأن يتم اطلاع مُلاك المدارس ومُديرها بالإطار العام لهذه المنظومة ، والذي يجب أن يتضمن (أدوات تحليلية)، من أهمها على سبيل المثال : “الملاءمة والاستجابة، بيئة التعليم، المناهج الدراسية، تكنولوجيا التعليم، التعلم مدى الحياة، كفاءة المعلمين، استفادة الطلاب، فعالية النظام التعليمي، التقويم، الحوكمة، التمويل، والمساواة والشمول”، والهدف المتوقع بعد تطبيقها في تطوير منظومة الموارد البشرية في جميع المؤسسات التعليمية بالقطاع الأهلي؛ للكشف عن نقاط القوة والضعف لكل مؤسسة تعليمية، وكيفية الوصول إلى التدابير ذات الأولوية للنهوض بها.
وما نحتاجه لإنجاح هذه المنظومة، لن يتم إلا من خلال بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي في هذه المدارس، وتحسين نظم تقييم الأداء، وجعله أكثر احترافية، وربط الإنتاجية بالحوافز؛ مما يقود للإجادة المؤسسية. وهذا بلا شك سوف يرفع من مستوى الأداء المؤسسي التعليمي للقطاع الخاص، والتي سيُسهم بدوره في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لطلاب هذا القطاع، وتعزيز ثقة المجتمع بأداء هذه المدارس، وبلا شك ستكون هذه المنظومة صمام أمان لضمان جودة المخرجات التعليمية للمؤسسات التعليمية الخاصة، والتحسين المستمر في أدائها، بما يضمن لنا ضمان جودة التعليم وتطبيق المعايير والمواصفات القياسية المتوقعة؛ كونها ستعمل على إيجاد انسجام وربط بين أهداف المؤسسة التعليمية، ووضوح مهام ومسؤوليات المعلمين وكافة الموظفين العاملين فيها.
وحينها ستتمكن الجهة المشرفة على النظام التعليمي من قياس جودة التعليم وإظهار أوجه القصور واتخاذ اللازم لتطوير وتحسين الأداء، وتمكين المعلمين والمعلمات من إنجاز العمل بكفاءة، ومكافأة المجيدين منهم. كما أنها ستمثل الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية بين المدارس المختلفة في هذا القطاع.
كما أن من وسائل تطوير التعليم التركيز على السلوك والانضباط وبناء المهارات الأساسية والحياتية. ووضع ضوابط حازمة تعزز مكانة العلم والتعلم في نفوس الطلاب وتقدير المعلم والمدرسة.
وربما هناك حاجة لبناء خطة استراتيجية تعزز دور القطاع الخاص في تحسين وتطوير التعليم الأهلي، ولا بد أن يشمل التطوير التنظيمات والإجراءات وآليات الإشراف وأدوات التحفيز والتقويم.
وعلى نحو محدد فإن المتوقع من التعليم الأهلي تحقيق أهداف عدة منها على سبيل المثال:
- تعزيز مساهمته في النظام التعليمي كمًا وكيفًا.
- ضبط وضمان جودته والتحسين المستمر لمخرجاته من قبل وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم من خلال معايير تتسم بالشفافية والوضوح.
- تلبية مخرجاته في التعليم العام والعالي لحاجات سوق العمل في المملكة وتواءمها مع هوية وقيم المجتمع.
- التركيز على المهارات المستقبلية الشخصية والمهنية (من خلال استشراف المستقبل).
- مساعدة نتائج التقويم في تحسين الأداء على مستوى الطالب والمدرسة والنظام.
وبنظر البعض فإن دفع مستوى الجودة في التعليم عامةً والتعليم الأهلي خاصةً، المُحرِّك الأساسي له هو وزارة التعليم، من خلال بعض الآليات من موقع مركزيتها سواءً في إعطاء الإذن لفتح المدرسة، أو حتى إيقافها، من خلال المحاسبية والشفافية في آن واحد، وهو ما يتطلب في البداية وضع مؤشرات لقياس نتائج التعلم للطلبة في كلا القطاعين الأهلي والعام، ويتطلب ذلك إجراء اختبارات وطنية مركزية كتلك المعمول بها في النظم المتقدمة- بريطانيا، سنغافورة وغيرها- تقيس مخرجات المدارس في نهاية كل عام وفي نهاية كل مرحلة وربط الدعم المالي وكافة الحوافز بهذه النتائج. كما أن معايير استمرار المدارس الأهلية من عدمه يرتبط بتلك النتائج، هنا فقط يمكن أن يسهم التعليم الأهلي الذي كما يتضح هدفه الأساسي هو الربحية، وتطبيق هذه المعايير هو ما يمكن أن يرفع درجة التنافسية بين القطاعين العام والأهلي.
غير أن محاولة إرغام مؤسسات التعليم الأهلي في عمليات التجويد، وتطبيق برامج الاعتماد المدرسي، دون تحفيز حكومي حقيقي، سيحد من فاعلية البرامج المؤسسية التي تحفز على التنافس والتميز المدرسي، سيما أن بعض المدرس الأهلية لديها بيئات تعليمية تفوق كثيرًا المدارس الحكومية، لكنها تعيش معوقات وتحديات كبيرة في الوضع الراهن.
وإذا كان موضوع جودة التعليم هدفًا ساميًا، في حد ذاته، ومن أجل تحقيق غايات وطنية، تتمثل في الارتقاء بمستوى التعليم والتعلّم، فثمة تساؤلات مع ذلك؛ منها: هل هذا التوجه سيشمل المدارس الحكومية؟ ثم كيف يمكن ضمان تجاوب المستثمرين في التعليم الأهلي بتحقيق الجودة والتميز في التعليم؟ وما هي الاستراتيجيات الممكنة، انطلاقًا من عناصر القوة في هذه المؤسسات، والفرص المتاحة لهم، سيما إذا عرفنا حجم التحديات الخارجية ونقاط الضعف التي يعانون منها، وقد تحُول دون التجاوب المخطط والمنشود.
وفي هذا الصدد يُلاحظ أنه سيكون هناك برنامج موازٍ لتقويم المدارس الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم، وستكون بمعايير قريبة من معايير الاعتماد، وسينطلق التقويم الذاتي مع بداية العام الدراسي 1444هـ بإذن الله، ثم سيتبعه التقويم الخارجي المتضمن الإفادة من نتائج الاختبارات الوطنية نافس. كما سيكون الاعتماد المدرسي اختياريًا في بداية انطلاقه ثم سيتحول إلى إلزامي على المدى الطويل، وستكون فرصة للمدارس الأكثر جاهزية بالتقدم له، وأما المدارس التي تود الاستعداد له فسيكون أمامها وقت، ولا سيما أن التقويم الذاتي وخطة التحسين قد تمتد من فصل دراسي إلى عام ونصف، والهدف الأساس هو التحسين والتطوير الذي يؤمل أن يسهم في رفع جودة التعليم لأبنائنا.
- التوصيات
- لكي يمكن للتعليم الأهلي “ذو الجودة” أن يؤثر على التعليم الحكومي (على مستوى المدرسة) فيمكن أن تتبنى الوزارة نشاطًا منظمًا يقوم على تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات للمدارس المجاورة بشكل دوري منتظم.
- بالنسبة للفئة الشائعة من المدارس الأهلية التي لا تزيد عن المدرسة الحكومية سوى في بيئتها الآمنة فقط وبعض الجوانب الشكلية الأخرى، فينبغي على الجهات التعليمية (سواء الوزارة أو هيئة التقويم) أن تقدم مشروعًا تنمويًا لتحسين “جودة” التعليم الأهلي في مثل هذه المدارس تقود فيه برنامجًا تحويليًا transformative ينقل هذه المدارس من واقعها الحالي “العادي” إلى مستوى يماثل أو يقارب المدارس الأهلية المتميزة أكاديميًا، وذلك لتضمن هذه الجهات الرسمية لأولياء الأمور أن استثماراتهم المالية في أبنائهم وُضِعَت في مكانها الصحيح، وفي هذا الصدد تقدم هيئة تقويم التعليم المعايير والمقاييس التي تعكس مستوى الأداء، وعلى الوزارة أن تفعل ما تتوصل إليه هذه القياسات من خلال المحاسبية أو الدعم والمساندة بالخبرات الإشرافية حسب نوع وحدة المشكلات التي تبرزها القياسات، كما أنها من جانب آخر تضع الحوافز المشجعة لتلك المدارس التي حققت نتائج جيدة أو حتى تلك التي تحقق “تقدمًا” سنة بعد سنة، كل ذلك ليكون للمعايير والمقاييس التي تُطبَّق قيمة نوعية وأثر عميق في واقع الممارسة .
- على الوزارة أن تشجع جودة التعليم الأهلي من خلال شروط نوعية فيمن يملكون أو يشرفون على هذه المدارس، ليتمكن التربويون من الاستثمار فيها وتقليل حجم الاستثمار التجاري البحت، ومن هذه الشروط مثلًا: ألا تقل شهادة من يشرف على المدرسة الأهلية (بكامل الصلاحيات المالية والإدارية) عن درجة الماجستير في أحد تخصصات التعليم مع خبرة عملية “قيادية” لا تقل عن عشر سنوات في التعليم تكون حافلة بالعطاء وتُوضَع لذلك معايير واضحة ومحددة مع اجتياز تدريب أو شهادة معتمدة في إدارة المشاريع.
- أهمية تخصيص كل المدارس وتقوم الوزارة بثلاثة أمور: مواصفات المباني، ومواصفات المدرس، ومواصفات الكتاب.
- إنشاء هيئة حكومية للتعليم الأهلي وتشمل رياض الأطفال ودور الحضانة يكون دورها التنظيم والتشريع والرقابة.
- أهمية تفعيل الحوكمة وأيضًا دمج إدارة التعليم الأهلي مع الحكومي، وتطبيق ذات المعايير في التوجيه والرقابة والإشراف على كافة المدارس الحكومية والأهلية لتوحيد الجهود.
- ينبغي مراعاة اختلاف تركيبة الطلبة الاجتماعية الاقتصادية بين المدارس الحكومية والأهلية عند مقارنة هذين النوعين من المدارس، حتى تكون المقارنة عادلة وداعمة لقرارات التحسين.
- مراعاة النظر في مخرجات التعلم ببُعديها المعرفي وغير المعرفي، عند تقويم أداء المدارس الأهلية ومقارنتها إلى المدارس الحكومية.
- أن يكون لمؤشرات قياس مخرجات التعليم في النظامين العام والأهلي.
- تفعيل دور المجتمع في المنظومة التعليمية، بحيث يكون نمط الحياة من حول الطالب مشجعًا على ترسيخ المعلومة، وتصويرها بأشكال مختلفة.
- القيام بدراسة شاملة لتطبيق مستقبل الجودة في التعليم الأهلي، تشمل جميع أصحاب المصلحة.
المصادر والمراجع
- ندى فيصل: ورقة عمل بعنوان (معايير الجودة والاعتماد في التعليم) مقدمة إلى المؤتمر العلمي (نحو الاعتمادية في كليات التربية)، قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للبنات، جامعة عين شمس، 2019م.
- خالد مطهر العدواني: الجودة الشاملة في التعليم، مقدم لإدارة الجودة والاعتماد بوزارة التربية والتعليم، متاح على الرابط: https://kenanaonline.com/files/0062/62040
- عبداللطيف حسين حيدر: تجويد التعليم بين التنظير والواقع، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 2016م.
- نجيب سليم: الجودة في التعليم، مفهومها، معاييرها، وآلياتها، 2015م، متاح على الرابط: https://www.new-educ.com
- رشدي أحمد طعيمة وآخرون: الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2005م.
- رياض رشاد البنا: إدارة الجودة الشاملة في التعليم، المؤتمر التربوي العشرون، 20-21 يناير 2006م.
- المشاركون.
- الورقة الرئيسة: د. محمد الملحم
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: د. زياد الحقيل
- التعقيب الثاني: د. ناصر الملحم
- إدارة الحوار: د. صالحة آل شويل
- المشاركون بالحوار والمناقشة:
- د.. نياف الجابري
- د. صدقة فاضل
- د. فوزية البكر
- د. خالد الرديعان
- د. وفاء طيبه
- م. ا. ماهر الشويعر
- د. عبدالاله الصالح
- م. اسامه كردي
- ا. فائزة العجروش
- د. عبدالعزيز العثمان
- د.عبدالرحمن العريني
- م. عبدالله الرخيص
- د. خالد المنصور
- د. زياد الدريس
- د. ابراهيم الدوسري
- ا. لاحم الناصر
- د. عائشة الأحمدي
- د. حميد الشايجي
- د. محمد الثقفي
- د. خالد بن دهيش
- د. محمد العامر
- ا. عبدالرحمن باسلم
- د. محمد المقصودي
- د. احمد الغامدي
- د. عبدالعزيز الحرقان
- ا. احمد المحيميد
- م. علاء براده